




-
 هــــذا هو ...... ؟؟؟
هــــذا هو ...... ؟؟؟
@هذا هو الإسلام في نظام الحكم
الإسلام ليس دينا للتعبد بين الإنسان وبين ربه في المساجد؛ بل الإسلام دين للفرد ودين للجماعة، الإسلام نظام للإنسان في نفسه وفي مجتمعه، وهو أيضا نظام حكم، قال جل وعلا لنبيه ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾[النساء:58]، وقال أيضا لنبيه في بُعده عن حكم الجاهلية ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[المائدة:50]،
راعى الإسلام أساسيات ما يقوم عليه مجتمع الناس في نظام حكمهم:
فراعى أولا الحرية، والحرية تتنوع:
ومنها الحرية الدينية قال الله جل وعلا ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾[البقرة:265]، وقال لنبيه ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (21) لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾[الغاشية:21-22]، وقال أيضا لنبيه ﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾[يونس:99] وهذه الحرية طبقت بتطبيق ظاهر بين في عهده عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ وفي عهده الخلفاء الراشدين فلم يجبر أحد على أن يعتنق الإسلام؛ بل كان يعرض له الإسلام فإن قبله وإلا ترك، وهذا لأجل هذا الأصل في أنه من كان على ملة كاليهودية والنصرانية فإنه لا يفتن عنها كما جاء في رسالة من رسائل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبعض عماله قال«ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها» يعني لا يلجأ حتى يترك ذلك وسيرة الخلفاء في ذل في التسامح في هذا الجانب وفي تركه ظاهرة بينة.
من أساسيات الشرع في الحريات رعاية الحرية الاقتصادية ورعاية الحرية الشخصية قال الله جل وعلا ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة:275] وسيأتي مزيد بيان لذلك في محور الاقتصاد والمال.
الحرية الشخصية للإنسان في بيته فيما يزاوله، الحرية الشخصية في ماله فيما يزاوله، هذا أصل قعده الشرع ولذلك راع الشرع حرية الإنسان في نفسه في بيته، فلما أراد بعض الناس؛ بل نظروا إلى داخل بيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولما حدث النبي بذلك قال «لو علمت من شأنكم لفقأت عينك» يعني لأنه تدخل ونظر إلى ما ليس له النظر فيه فالإسلام رعى الحريات، ولا يمكن هناك اجتماع حكم أو اجتماع دولة أو اجتماع للناس يألفون فيه ويجتمعون فيه على مصلحتهم إلا بنوع من الحريات كفلها الشرع لهم.
والحريات واسعة ومتنوعة مما رعاه الشرع.
أيضا من أساسات الشرع في حكم الناس العدالة والمساواة، العدل بين الناس والمساواة، وأصل الحكم في الناس لأجل تحقيق مصالحهم الناس يجتمعون على واليهم ويجتمعون على أميرهم ويجتمعون على دولتهم ويجتمعون حكمهم؛ لأجل أنه يحقق مصالحهم، وأعظم ما يرضي الناس وتحقق به المصالح العدل فيما بينهم، والعدل عرفه العلماء بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، ومعلوم أن صاحب الحق يتفاوت كما يتفاوت الناس في إعطائهم بعض الحقوق؛ لكن العدالة أن يوصل الحق إلى صاحب الحق دون مضاربة ودون طغيان على صاحب الحق.
والمساواة مطلوبة وكما أن الناس في التكليف سواء لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، والناس سواسية في التكليف كأسنان المشط، فإنهم كذلك يطلب أن يكونوا سواسية فيما يحتاجونه في دنياهم في مصالحهم وفيما يدفعون به الأذى وفي القضاء ونحو ذلك، ولهذا أكد الشرع على سواسية الناس في مجمل حقوقهم وما به حياتهم وعلى سواسية الناس أمام القاضي وعلى سواسية الناس في تحصيل مصالحهم.
من أساسيات في الحكم أن تُحفظ بيضتهم وأن تحفظ اجتماعهم وقوتهم فأول مهمات الحكم أن يجمع الناس وأن يحفظ لهم بيضتهم واجتماعهم؛ بأن يقيم فيهم شرع الله جل وعلا.
ومن أساسيات ذلك التي رعاها الشرع النصح بين المؤمنين قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم»، فالنصح للعامة والنصح لولاة الأمر هذا أصل من أصول الشريعة، وقد عاهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض الصحابة على أن يقولوا الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعاهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طائفة من الصحابة على أن ينصحوا لكل مسلم على اختلاف طبقات المسلمين.
وهذا داخل في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وصف الله جل وعلا هذه الأمة في هذه الصفة قال جل وعلا ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾[آل عمران:110]، والنصح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا و القاعدة وأشكاله وضوابطه وظروفه تختلف باختلاف الزمان والمكان.
ولذلك كما سيأتي الإشارة إليه الأنظمة الحديثة كمجلس الشورى أو المجالس -مجالس الأمة- أو نحو ذلك، هي نوع وأداة ووسيلة من وسائل النصح التي راعى الشرع فيها القاعدة العامة وترك الوسيلة للناس يطوروها كلما احتاجوا إلى ذلك فإذا تعقد الزمان وتعقد علاقات الناس، ولم يوصل إلى النصح إلا بأسلوب ينظمه ولي الأمر فإنه يجب عليه أن ينظمه حتى تكون النصيحة واضحة واصلة إلى الحاكم وولي الأمر.
كذلك النقد والقول الآخر وكما يسمى المعارضة بضوابطها الشرعية، هذه مقبولة لكن بشروطها الشرعية ومن أهمها أن لا تحدث فتنة وأن لا تفرق المسلمين، فإذا كان النقد والمعارضة والقول الآخر فيه مصلحة الناس ولو شق سماعه؛ ولكن لا يسبب فتنة أو عملية في الناس ولا يؤدي بهم إلى فساد في اجتماع كلمتهم فإنه مأذون به.
أما الحكم في نفسه، فأركان الحكم التي ...: الحاكم، وأهل الحل والعقد، وأهل الشورى والرقابة، والقضاء، والدواوين والأجهزة التنفيذية.
والحاكم الشرع فصل القول فيه؛ فيما يجب عليه، وفيما يجب له، وكيف يختار، وكيف تكون ولايته.
وكذلك في أهل الحل والعقد ومن يكونون، وكيف يزاول وليّ الأَمر الأمر بينه وبينهم.
وكذلك الشورى والرقابة، فقد كان أهل الشورى عند عمر معروفين وكانوا عدد معروفين، وهذا يتطور بتطور الزمان وربما صار اليوم له مجالس وأعدادا كبيرة يمثلون شرائح الأمة حتى في اختلافهم في علومهم وفي إدراكاتهم وفي بلداهم وفي قبائلهم إلى آخره، حتى تكون مسألة الشورى أو مجالس الشورى هي التي يناط بها كما يسمى التشريع، أو يناط بها وضع الأنظمة. والرقابة على أداء الأجهزة التي تنفذ هذه الأنظمة.
القضاء أصل من أصول الشرع، ولم ترع حضارة أو يرع دين أو يرع شريعة القضاء كما قضته هذه الشريعة، قد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصف القضاة «القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة»، وذكر أن القاضيين في النار، القاضي الذي عرف الحق فعدل عنه أو القاضي لم يعرف الحق ولم يحكم به أما الذي لم يعرف الحق ولم يحكم به، أما القاضي الذي عرف الحق فحكم به ولم تأخذه في ذلك لومة لائم فهذا هو الذي يكون قاضيا محمودا وعده النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجنة.
القضاء نزيه لا سلطة لأحد عليه في الشرع، فالقاضي يجب عليه أن يبلغ حكم الله، وقوله في ذلك ملزم، وقد يكون القاضي القضاء في ذلك على رتبة واحدة أو يكون على عدة رتب، كما عندنا مثلا هنا القضاء في المحاكم ثم التمييز ثم مجلس القضاء الأعلى، وفي بلدان أخرى ثلاث، المهم أن سلطة القضاء ومهمة القضاء نزيهة لا سلطان لحاكم ولا سلطان لمحكوم عليها؛ لأنه يحكم بحكم الله جل وعلا، فإذا تدخل الرعية فإنه تدخل في حكم الله فيما شرعه للفصل بين الناس ترتفع إذا تدخل في السلطة القضائية يرتفع العدل ويحل بعض الظلم فيما بين الناس وبينهم، وهذا ما يفكك البيضة وكل الوسائل التي يحفظ ... فإن هذا الوزارات المصالح المختلفة إنما هي أجهزة للتنفيذ ما أمر الله جل وعلا به، لتنفيذ ما أعطاه ولي الأمر لهؤلاء من الأمانة، لتنفيذ الأنظمة، لتنفيذ التشريعات ويجب أن يؤدوا الأمانة ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ﴾[النساء:58].
@هذا هو الإسلام في الأخلاق
أما الأخلاق فإن أعظمها ما وصف الله جل وعلا نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به حيث قال تعالى لنبيه ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[القلم:4]، وقد قال نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وهذا الحصر في قوله (إنما بعثت) يحصر لك أن القصد من البعثة إنما هو تتميم مكارم الأخلاق، وهو بهذا يجعل الأخلاق شاملة لكل ما اشتملت عليه الشريعة وما اشتمل عليه دين الإسلام، وهذا هو الظاهر، والإنسان فيه خَلق وخُلق، أما الخَلق هي صورة الظاهر، وأما الخُلق فهو الصورة الباطنة لروحه، وكما أن الإنسان يحسن عنده الصورة الظاهرة، وكذلك يدخلها التكليف يجب عليه أن يحسن عنده الصورة الباطنة، وهذه يدخلها التكليف متعلقة بالروح والنفس والغرائز تصرف عن ذلك، لهذا نقول: إن الأخلاق دعا إليها الإسلام متنوعة.
فخلق الإنسان مع ربه، الإنسان المسلم خلقه مع ربه يجب أن يكون أسمى الأخلاق في جميع ما يتصل بروحه، وهل محبة الله جل وعلا ورجاؤه والخوف منه والأنس به جل وعلا ودعاؤه والذل له والتوكل عليه وحسن الظن به إلا من الأخلاق العبادية العظيمة بين الإنسان وبين ربه جل وعلا.
خلق الإنسان مع ربه يدخل فيه إخلاصه لربه وأن لا يكون في قلبه قصدا وإرادة سوى الله جل وعلا.
فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان
خلق المسلم مع نفسه، خلق المسلم مع والديه وأهله وأولاده، خلق المسلم مع المسلمين فيما يعامل به هؤلاء من الصدق والأمانة، وأن يحب لهم ما يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يرعى فيهم الأمانة وأن يجنب نفسه وإياهم كل ما فيه نزغ الشيطان في الصدور، ولهذا قال جل وعلا في جماع ذلك ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾[الإسراء:53] بالقول الحسن والفعل الجميل، ولم تتصدع الأخلاق إلا بالقول المشين أو الفعل المعيب، فلهذا كلما حسنت الأقوال والأفعال في تعاملات الإنسان وأحب للناس ما يحب لنفسه من الخير وصار على خلق محمود، جميع الصفات من الصدق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وأداء الحقوق عن أنه يصدق ولا يكذب وأنه يؤدي الأمانة ويغش وأنه يكون صالحا للناس كما يحب أن يكونوا صاحين، هذه أنواع الأخلاق المحمودة.
كذلك خلق المسلم مع غير المسلمين، غير المسلم لا يعني أنه لم يشارك المسلم في دينه أن يكون فض الخلق معه؛ بل يكون معه على خلق حسن في قوله وفي فعله:
أما القول فقد نص الله جل وعلا عليه ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً﴾[البقرة:83].
وأما الفعل فقد قال الله جل وعلا ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[الممتحنة:8].
فلم ينه الله جل وعلا عن الخلق الحميد عن برّ من لم يقاتلنا في الدين وعن الإحسان إليه وعن العدل معه، فالعدل أساس لأنواع التعاملات مع غير المسلمين وذلك البر بهم وكذلك أن يقال لهم الحسن، وهذا كله فيمن لم يظهر العداوة لأهل الإسلام وأهله.
كذلك خُلق المسلم وخُلق الإسلام في الحرب، الإسلام أوّل تشريع جاء في الحرب بعزل المدنية والمدنيين وعن الحرب، واختص في الحرب بمواجهة المحاربين دون مواجهة المدنيين، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألاّ يُقتل في الحرب الشيخ ولا المرأة ولا الوليد، حتى الشجر لا يقطع وحتى إفناء البيوت وهدم البيوت لا يشرع؛ وذلك لأن المدنيين الذين لم يحاربوا فإنه لا حرب عليهم وإنما الحرب المحاربين، وهذا علو في الانتقائية في حال الحرب، فالحرب ليس معناها في الإسلام بأنواعها ليس معناها أن تحصد الأخضر واليابس وأن تحصد الناس لأجل الانتصار، وإنما في الحرب رعى الإسلام الانتقاء من يهاجم ومن يقتل في ذلك.
الخُلُق في تعريف وجيز بما رعاه الإسلام هو حمل الغرائز في صفاتها على موافقة أمر الخالق جل وعلا، فصاحب الخُلق الحميد هو صاحب القول الطيب والفعل الطيب والغرائز والعادات مؤثراتٌ كثيرًا في الخلق.
@هذا هو الإسلام في مجال الاقتصاد والمال
أما الإسلام في مجال الاقتصاد والمال، فللمال والاقتصاد أهمية كبيرة جدا، وذلك لأن الاقتصاد والمال قوة للأمة، وبقوة الأمة في مالها واقتصادها شأنها ذاتها ويقوى تكاتفها في داخلها، ويقوى أيضا أمرها مع أعدائها، فقوة الدولة في الإسلام وقوة المسلمين تنبع من أشياء، ومنها قوتهم الاقتصادية والمالية، وذلك لأنّ المظهر -مظهر القوة- في حكومات الإسلام لا يكون بالاهتمام بالاقتصاد والمال وأن يُرعى هذا الجانب كثيرا.
لكن الشرع في رؤيته للمال مع ذلك جعل هناك عدة أساسيات:
الأول أن المال مال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾[النور:33]، والبشر مستخلَفُون في هذا المال يسيرون فيه على وفق مراد الله جل وعلا، قال سبحانه ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾[الحديد:7]، فجعل الإنفاق يكون مما استُخلفنا فيه، فالمال بأنواعه مما استَخلفنا الله جل وعلا فيه.
لذلك قال العلماء: التبذير هو أن يُنفق المال في غير ما أمر الله جل وعلا به، فالإنفاق في الحرام تبذير، والإنفاق على وفق الشرع إنفاق فيما جعل الله الناس مستخلفين فيه بما يحب الله جل وعلا ويرضى.
المظهر الثاني من مظاهر أساسيات النظرة للاقتصاد ضمان حد الكفاية لأفراد الأمة الشرع رعى أن يراعى حد الكفاية لأفراد الأمة وللأسر بحسب حاجتهم، وذلك قد يكون عن طريق الدولة من خزانتها، كما فرض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بيت المال أشياء للمحتاجين وكما فرض أبو بكر وعمر إلى آخره، وقد يكون من التشريعات الإسلامية كتشريعات الزكاة والصدقة والواجب في النفاق على الأقربين ونحو ذلك.
من أساسيات من نظرة الإسلام إلى الاقتصاد والمال احترام الملكية الخاصة، فالملكية الخاصة محترمة والشرع يرعى أن تنمى الملكيات الخاصة الصغيرة قبل أن ترعى الملكيات الكبيرة، فأصحاب رؤوس المال الكبيرة الشرع يهتم بالصغار قبل الكبار، وهذا بخلاف النظرات الأخرى التي إما أن تحرم الغني أو أن تجعل الغني هو السلطان؛ بل راع الشرع أن يكون الصغير يشتغل ويعمل ويُنتج، حتى يكون المال في يده، قال الله جل وعلا ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾[الحشر:7].
من أساس ذلك أيضا إعطاء الحرية الاقتصادية، فلا اقتصاد ولا قوة إلا بنوع من الحرية، ولهذا الشرع فتح باب الاقتصاد وجعل المحرم من المعاملات في الجاهلية محدودة، أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بمعاملات كثيرة متنوعة فحرم الشرع منها أشياء وجعل الباقي على أصل الجواز.
أيضا من أساس ذلك الحثّ على أنواع التنمية الاقتصادية والعقارية والزراعية والصناعية والإنتاجية، وهذا لكل واحد منهما أدلته من فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو فعل الخلفاء.
من أساسيات الشرع في النظر إلى الاقتصاد والمال ترتيب الإنفاق والنهي عن التبذير والإسراف.
من أساسيات ذلك تحريم كل معاملة تؤول إلى الظلم الفردي أو الجماعي؛ لأنه قد يتسلط صاحب المال فيسعى من جهة حريته الاقتصادية إلى أن يظلم الفرد أو يظلم المجموع، قد يحس الفرد بظلمه؛ لكن يظلم المجموع، والشرع حرّم الظلم في الاقتصاد بأنواعه، وجعل التشريعات المتنوعة كفيلة بصد الظلم بأنواعه، وأن يكون العدل هو المطلوب، إما العدل في الرؤية للفرد أو العدل في الرؤية للجماعة.
كذلك راع الشرع نمو رأس المال أن يكون نمو رأس المال متاحا للصغير والكبير.
من القواعد العامة في نظرة الشرع إلى الاقتصاد والمال:
الأول أن الأصل في المعاملات المالية والاقتصادية الحل والإباحة إلا ما ثبت تحريمه في الشرع، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم:
أنّ العبادات الأصل فيها الحظر المنع حتى يأتي دليل بالأمر بها؛ لأن العبادات لا يدخلها العقل ولا الرأي، فينظر فيها إلى أمر الشارع فيها.
وأما المعاملات فهي حياة الناس وهي دنياهم فلهم أن يجعلوا من التفريعات والمعاملات ومن أنواع المعاملات والأوضاع الاقتصادية والمالية ما يشاءون؛ لكن بشرط أن لا يكون فيها خمس أنواع المحاذير:
الأول: الربا.
الثاني: الميسر والقمار.
والثالث: الجهالة التي تؤدي إلى الخصومات والنزاعات.
الرابع: الغش والخداع.
والخامس: الظلم.
فإذا انتفى في أي نوع من المعاملة، أي نوع من الوضع الاقتصادي، أي نوع ما يريد الناس أن يحدثوه في أوضاعهم المالية أو الاقتصادية أو مؤسساتهم المالية والاقتصادية انتفت هذه الخمس، فالشرع يأمر بهذا النوع ويحث عليه، وهذه الخمس أكررها: الربا، القمار والميسر، الثالث الجهالة، والرابع الغش والخداع، والخامس الظلم.
من القواعد في ذلك أنه يجب أن يحقق الاقتصاد -الذي يأمر به الشرع ويحث عليه وتسعى به الأمة- أن يحقق مصالح الفرد ومصالح المجتمع ومصالح الدولة، وألا يحقق مصلحة أفراد مخصوصين، أو أن يحقق مصلحة طائفة معينة أو أن يحقق مصلحة حزب بعينه قال الله جل وعلا ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾[الحشر:7]. والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سُئل أن يسعّر لما غلا السعر قال «فذروني إن الله هو القابض الباسط» وقال «إن الله هو المسعر» وذلك بفتح المجال حتى يستفيد الصغير، وألا يتحكم أناس في الإسعاد لصالحهم وأن تبقى فيه قوة في داخل المجتمع من الناحية الاقتصادية على حساب جهات أخرى.
@هذا هو الإسلام في الاجتماع والإلفة والافتراق
الموضوع السادس هذا هو الإسلام في حرصه على الاجتماع وعدم الافتراق.
أساس الدين الاجتماع، وأساس الدين عدم الافتراق، قال الله جل وعلا ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾[آل عمران:103]، وقال ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[آل عمران:105]، وقال جل وعلا ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾[الشورى:13]، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الحسن «الجماعة رحمة والفرقة عذاب».
بهذا يتضح لنا أن الشريعة وأن الإسلام أساسه الاجتماع وأساسه عدم الافتراق، هذا الاجتماع ما هو؟ والافتراق ما هو؟ الشريعة دعت إلى الاجتماع ونهت عن الافتراق في نوعي الاجتماع والافتراق:
أما النوع الأول: فهو الاجتماع وعدم التفرق في الدين بأن لا يأتي الناس ويشرّعوا في الدين، ويُحْدثوا في الدين ما يريدونه من عبادات ومن أقوال ومن أوضاع ومن طقوس، فالأساس أ يجتمعوا على الدين الحق في عقيدتهم وفي توحيدهم وفي العبادات بأن لا يفتئتوا على الشارع وألا يتجاوزوا حدهم ويتركوا التشريع لله جل وعلا فيه ذلك، قال جل وعلا في سورة الشورى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾[الشورى:21].
النوع الثاني الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق في أمور الدنيا والدولة والإمام، فالله جل وعلا أمر بالاجتماع على الوالي المسلم وأن يُنصر وأن يُنصح وأن لا يُخذل في أي.. فأمر بحفظ ذلك وتنهى عن التفرق عنه ونهى أن يتفرق وأمر بالجماعة مع الإمام الحق وأن يؤيد وينصر؛ لأن في ذلك نصرة للدين وقوة له حتى ولو كان عنده بعض قصور أو الأخطاء أو الآراء قد لا يوافقه عليها الآخرون؛ لكن لابد للناس من اجتهاد، فإذا صار الاجتهاد هنا وجب على الجميع أن يقفوا مع ولي الأمر فيما فيه مجال للاجتهاد حتى لا يكون تفرق، وأقوى ما تجتمع به الأمة عدم افتراقها على دولتها وأقوى ما تتفرق وتضعف به أن تكون أحزابا وشيعا ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾[هود:118-119]، فأثنى على أهل الاجتماع لأنهم أهل الرحمة.
@هذا هو الإسلام في العلاقات الدولية
السابع الإسلام في العلاقات الدولية.
الحال دائما بين الدُّول:
· إما حال سِلْم.
· وإما حال حرب.
وإذا كانت حال حرب قائمة فالشرع لا يتشوّف للحرب؛ بل الحرب تقوم مقام الضرورة في ذلك، وإذا كان المجال مفتوحا للدعوى إلى الله جل وعلا وإلى تبليغ رسالة الله جل وعلا فإن أصل الجهاد في سبيل الله جل وعلا لم يُشرع،كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في الرد على النصارى قال في ذلك إن الجهاد لم يشرع حماية للدعوة فإذا كانت الدعوة يمكن تبليغها فإن الجهاد جهاد الطلب لا وجه له، وأعطى أدلة على ذلك والشواهد معروفة، حال الحرب في ذلك أن يكون حال الدفاع، وهذا واجب على الإمام وواجب على الأمة أن تدفع عنها الأعداء بحسب ما تستطيع، فإذا كانت لا تستطيع فإنها ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما؛ لأن الظلم وقع بالصحابة ولم يؤذن لهم بالجهاد في وقتها، قال الله جل وعلا ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾[الحج:39]، فجهاد الدفع مطلوب بحسب القدرة وبحسب الحال وبإذن وأمر ولي الأمر.
أما حال السلم فعلاقة دولة الإسلام وبين غيرها تكون:
· إما حال عهد وميثاق.
· وإما حال أمان وهذه ما يعبر عنها العلماء بأن في حال المعاهدين أو حال المستأمنين.
أما حال العهد فالشرع رعى المواثيق والعهود قال جل وعلا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[المائدة:1]، وقال ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾[الإسراء:34]، وقال جل وعلا لنبيه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ ﴾ يعني المؤمنين يعني لو طائفة من المؤمنين استنصروكم قال ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾[الأنفال:72]، فإذا كان فإذا كان هناك ميثاق بين الدولة الإسلامية وبين دولة غير مسلمة ووقع اعتداء على بعض المسلمين، فهنا ولي الأمر مخير الدولة الإسلامية مخيرة بين أن تنبذ العهد وأن تقاتل العدو، وبين أن ترعى الميثاق، وذلك على وفق المصالح لحفظ بيضة الأمة بحسب ما تراه الدولة.
العهود كثيرة متنوعة، فالعلاقات الدولية مقرَّة في ما فيه مصلحة للمسلمين، النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استقبل الرسل وأدناهم وأجلسهم في مجلسه وأخذ الرسائل منه وبعث رسائل إلى رؤساء الدول والأقاليم والأمصار التي كانت في زمنه.
@هذا هو الإسلام في المدنية
الموضوع الثامن وهو الإسلام والمدنية
المدنية والحضارة قامت بمفهومها الشامل الواسع في العهد الإسلامي، وذلك لأن المسلمين رأوا في الشريعة، رأوا ما يحثهم على عمارة الأرض، وما يحثهم على أن يخدموا مدنيتهم بما فيه راحتهم وسعادتهم.
والبناء المدني في الداخل سواء من جهة بناء للمدن أو من جهة التشريعات أو من جهة الأنظمة هذا لن يكون إلا بالتعاون بين النظام التشريعي وما بين الناس وما بين الجهات التنفيذية، ولذلك أقام الشرع الاهتمام الكبير بالنظام المدني بأنواعه، فأقام الوِلاية ووضع الدواوين ووضع الأجهزة التنفيذية والشريعة والقضاء موجودة، وحثّ الناس على التعاون فيما فيه مصلحتهم وخدمتهم، وبناء الأحوال المدنية وبناء الاقتصادي والمالي والتشريعات المختلفة ظاهر، بل شرع الإسلام في بيت المال أن ينظم، وأن يكون هناك أناس مخصوصون للحفاظ على المال وأن يتصرف فيه على وفق الشرع، وحث الإسلام على والوقف وحث على أنواع التبرعات، فالوقف سمة ومن سمات التنوع المدني وتوسيع الاهتمامات المدنية.
ولهذا نرى في الزمن في زمن الحضارة والمدنية الإسلامية ما من مجال إلا غُطي بالوقف، سواء مجال المساجد يعني في المساجد كانت الأوقاف عليها، في التعليم كانت الأوقاف عليه في الصحة كانت الأوقاف على الصحة وأشباهها، وكان هناك وقف على الكتب، وكان هناك وقف على المكتبات، وكان هناك وقف على الطرق، وأوقاف على المياه، وأوقاف على الأرامل والمساكين وعلى المحتاجين بأنواع ذلك، وعلى من لا مسكن له، وهذا نوع من أنواع اهتمام الإسلام بحثّ الناس على أن يسهموا على هذا الجانب، وألا يكلوه إلى خزانة الدولة؛ بل تشريعات الإسلام تحث على تكامل في البناء المدني في تشريع الزكاة والصدقات والتكافل الاجتماعي إلى آخر ذلك.
@هذا هو الإسلام في الخلاف والحوار
التاسع الخلاف والحوار.
لابد للناس أن يختلفوا إذا كان كذلك فلابد أن يتحاوروا، ولهذا دعا الله جل وعلا المؤمنين أن يكون القول بينهم فيما يتحاورون فيه بالأحسن، قال الله جل وعلا ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾[الإسراء:53]، وأكثر ما يكون القول السيئ عند المناقشة وعند الحوار، فإذا اختلف ولم يأخذوا أحسن ما يجدون من الأقوال فإنهم سيختلفون، ولذلك الشرع والإسلام لما رأى هذا الخلاف وأنه واقع وأنه لابد للناس منه فأدب الناس بتأديبه في أن يكون قولهم بالتي هي أحسن، حتى في الدعوة أمر الله جل وعلا بالحكمة، قال سبحانه ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[النحل:125]، وهذا في جميع أصناف الناس المسلمين وغير المسلمين يجادلون بالتي هي أحسن، والحظ قوله ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وليس بالحسنى فقط وإنما بأحسن ما تجد؛ لأن المقصود الوصول إلى النتيجة، فالناس سيختلفون وإذا لم نرعى هذا الخلاف بيننا بالحوار بالتي هي أحسن فإنه سينشق المجتمع وستتعدد فيه الطوائف وسيتعدد فيه البغضاء وهذا خلاف ما أوجب الشرع من حماية البيضة واجتماع الكلمة.
قال أيضا جل وعلا في حوار ومجادلة غير المسلمين ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾[العنكبوت:46] المجتمع بطبيعته بتنقصه ونمائه وبكبره، لابد أن يكون فيه بعض الاتجاهات المذهبية، لابد أن يكون فيه بعض الاتجاهات الطائفية وهذه بدرت من أول يوم، والانتماءات المختلفة موجودة سواء انتماءات عرقية أو قبلية أو بلدانية أو مذهبية ونحو ذلك.
وفي عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انقسم الناس إلى مهاجرين وأنصار، وكان هذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمين شرعيين ذكرهما الله جل وعلا في كتابه، ومع ذلك لما تعصب الناس من الأنصار للأنصار ومن المهاجرين للمهاجرين أنكر عليهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ففي أحد المعازي أو السرايا حصل خلاف بين غلام أنصاري وغلام مهاجري فقال الأنصاري: يا للأنصار؛ يعني ينتخي الأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمعوا فغضب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» مع أن اسم المهاجرين اسم شرعي واسم الأنصار اسم شرعي لكن لما كانت الموالاة والمعاداة على اسم غير اسم الإسلام ويفرق الأمة نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه وقال «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم»، فاختلاف المذهبي والاختلاف الحزبي والاختلاف في الواقع وهذا يكون لابد مع التمدد وتنوع الناس في معارفهم أن يكون بينهم خلاف، وأن يكون هناك انتماءات وأن يكون هناك أنواع التعصبات، وأنواع الآراء المختلفة؛ لكن يجب أن يرعى الشرع فيها، وأن لا يكون الولاء لاسم غير اسم الإسلام، وأن لا يكون الاجتماع اجتماع على غير الاجتماع على كلمة الله جل وعلا تحت راية ولي الأمر.
وأما إذا تفرق المجتمع بوجود المذاهب والطوائف إلى أن يطعن بعضهم في بعض بدون وبافتئات ما يراه ولي الأمر فإن هذا يضعف الأمة ويفتّت قوة كلمتها.
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في وقته المنافقون، وكان يرعى الظاهر منهم، ولم يحاسبهم على بواطنهم، وترك بواطنهم لله جل وعلا وقال له بعض الصحابة أو حثه بعض الصحابة على قتل بعض المنافقين فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا، لا يُتحدث أن محمدا يقتل أصحابه»، هنا عندنا تفصيلات ضاق الوقت عنها.
@هذا هو الإسلام في الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو
آخر نقطة في ذلك الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، وهو الدين الذي يحارب الغلو وينهى عنه، قال الله جل وعلا ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾[البقرة:143]، وهذه الوسطية والاعتدال ظاهرة بينة في جميع عقائد الإسلام والتشريعات، فعقيدة الإسلام وسط وتشريعات الإسلام وسط، وهذا يجب أن نمارسه فيما بيننا في أقوالنا وفي آرائنا حتى في التفكير يجب أن نكون وسطا بين المغالين وبين الجافين، وحتى في رؤيتنا لبعضنا البعض يجب أن نسعى للمنهج الوسط، والمنهج الوسط هو الذي يجب أن نحضّ عليه أنه أساس الإسلام، والغلو منهي عنه أعظم نهي، قال الله جل وعلا لأهل الكتاب ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ﴾[النساء:171]، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الغلو وقال «إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم الغلو» والغلو هو مجاوزة الحد، كل ما تجاوز به حده فقد غلا فيه، فالغلو في الدين مذموم، وأصحابه خارجون عن سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والوسط وإنما ظهرت الفرق وظهرت المحدثات بظهور الغلو، الخوارج ما ظهورا إلا بالغلو والفئات والطوائف الضالة إلا بالغلو في دين الله جل وعلا، وهل نشب الأمة في تاريخها إلا من الازدياد فيما يحسبه أهله، الازدياد في الغلو والازدياد في التدين بما لا دليل عليه، وربما نحا أصحاب الغلو إلى أدلة؛ ولكن الغلو والانحراف في النفوس قبل أن يبحث أصحابه في الأدلة، وهذا ما نصّ الله جل وعلا عليه حيث قال ﴿هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ هناك متشابهات يشتبه عِلمها يمكن أن يستدل بها كذا ويمكن أن تستدل بها على كذا، ويمكن أن تستدل بها على كذا قال الله جل وعلا ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾[آل عمران:7]، فالذي في قلبه زيغ أصلا، في قلبه غلو، في قلبه زيغ، في قلبه انحراف، فيتبعون ما تشابه منه، وصار اتباع المتشابه من القرآن يوقع الحيرة في وجود المتشابه ولكن الزيغ وجد فذهب إلى غير دليل ليستدل به وليقنع نفسه بأنه على صواب ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾[آل عمران:7].
أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي زللي وخطلي وقصوري، وأن يجعلني فيما ذكرت متحريا الصواب وكلمة الحق في وصف الإسلام وفي شرحه وفي بيانه، وأستغفر الله فيما فصرت به عبارتي ونحا فيه فهمي إلى غير الصواب.
أسأل الله جل جلاله أن يجعلني من الهداة المهتدين وأن يجنبنا [مضلات] الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز هذه الأمة وأن يقوها على أعدائها وأن ينصرها نصرا مؤزرا إنه سبحانه جواد كريم.
وأشكر لكم حسن إنصاتكم وحسن إصغائكم، وآسف إن أكن قد أطلت عليكم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
منقوووووووووووول
الـــــــSHARKـــــاوى
إن المناصب لا تدوم لواحد ..... فإن كنت فى شك فأين الأول؟
فاصنع من الفعل الجميل فضائل ..... فإذا عزلت فأنها لا تعزل
-
 مشاركة: هــــذا هو ...... ؟؟؟
مشاركة: هــــذا هو ...... ؟؟؟
يا سلام على المقال الشامل
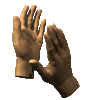
جزاكم الله خيرا على النقل المفيد
تعرف جاءت لى فكرة
ح اترجمه
سلام
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى











 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
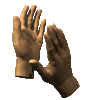



المفضلات