



-
 موجز في مصاد الدِّين المسيحيِّ المعاصر.
موجز في مصاد الدِّين المسيحيِّ المعاصر.
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
اللهمَّ إنَّا نحمدك ونشكرك معتقدين فيك أنَّك لا ترتاح إلى الشُّكر ارتياح ذوي الحاجات، ولكنَّ النُّفوس المؤيَّدة تأبى إلاَّ الشُّكر لمنعمها، سبحانك أيُّه الرَّبُّ الرَّحيم، حلمت مع نفوذ علمك، وأمهلت مع شدَّة بطشك، ولم تمنع الرِّزق من جاهر بعصيانك، تعاليت، أنت القريـب، الظَّاهر، الأوَّل، الآخر، لا تستفزُّك سطوة العبيد، وأنت أقرب إليهم من حبل الوريد.
ونسألك اللهمَّ صلاةً زاكيةً مباركةً على نبيِّ الرَّحمة، ومنقذ هذه الأمَّة، محمَّد، عبدك الدَّال عليك، والهادي إليك.
ونعوذ بالله أن نكون ممَّن رَغِبَ عن طريق هو لها سالك، وقال: هلك النَّاس وهو في جملتهم هالك. وبعد:
فهذا ملخَّص أتناول فيه المصادر والأسس الَّتي تقوم عليها العقيدة المسيحيَّة، وتجنُّباً للإطالة نشرع في المقصود مُباشرةً، فأقول والله الموفِّق وعليه التَّوكُّل:
تنحصر مصادر الدِّين المسيحي بثلاثة مصادر، وهي: الكتاب المقدَّس، والمجامع الكنسيَّة، والأقيسة المُتَّخذة من الخليقة المحسوسة. فيما يلي توضيح لكلِّ واحد من هذه المصادر على حدة:
المصدر الأوَّل: الكتاب المُقدَّس.
ينقسم الكتاب المُقدَّس إلى قسمين، وهما :
• العهد القديم، وهو: القِسم الَّذي يشترك في تقديسه المسيحيُّون واليهود، وقد كُتبت أصلاً باللُّغة العبريَّة.
وقد سُمِّي بالعهد القديم، كما هو في المفهوم اللاَّهوتي المسيحي؛ لبيان أنَّه عبارة عن الميثاق الَّذي حدَّد العلاقة بين الله تعالى وشعبه المُختار الَّذي هو شعب إسرائيل.
والعهد القديم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي:
1. أسفار التَّوراة، أي التَّعليم أو الشَّريعة، وهي أوَّل خمسة أسفار من العهد القديم والَّتي تُنسب إلى النَّبيِّ موسى، عليه السَّلام .
2. أسفار الأنبياء، وهي واحد وعشرون سِفراً، تبدأ بسِفر يُشوع، وتنتهي بسِفر ملاخي.
3. أسفار الكُتب، أو ما يُعرف بالأسفار التَّاريخيَّة والأدبيَّة والتَّأمليَّة، وهي ثلاثة عشر سِفراً، تبدأ بسِفر أخبار الأيَّام، وتنتهي بسِفر نحميَّا.
فيكون مجموع عدد أسفار العهد القديم تسعة وثلاثين سِفراً، هذا في وِجهة نظر طائفة البروتستانت، بينما أضافت الكنيسة الأرثوذكسيَّة القبطيَّة، والكاثوليكيَّة اللاَّتينيَّة، سبعة أسفار أُخرى، تَعتبرها الكنيسة البروتستانتيَّة اليوم أبوكريف، أو مزوَّرةً لا صلة لها بالكتاب المُقدَّس.
• العهد الجديد، وهو: القِسم الَّذي ينفرد المسيحيون في تقديسه، وقد كُتِبت أصلاً باللُّغة اليونانيَّة، وقد سمِّي بالعهد الجديد، كما هو في المفهوم اللاَّهوتي المسيحي؛ لبيان أنَّه عبارة عن الميثاق الَّذي جرى بين الله تعالى والعالمَ أجمع من خلال موت المسيح، عليه السَّلام، على الصَّليب؛ ليفتدي البشر.
والعهد الجديد ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي:
1. الإنجيل، أي: البشارة أو الخبر الجيِّد، وهي أربعة أسفار: إنجيل متَّى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنَّا.
تُعرف الأناجيل الثَّلاثة الأولى بالأناجيل الإزائيَّة، أو المتشابهة؛ وقد سُمِّيت بهذا الاسم لأنَّ أسلوب مؤلِّفيها كان واحداً. بينما يُسمَّى الإنجيل الأخير، وهو إنجيل يوحنَّا، بالإنجيل غير الإزائي، أو المختلف؛ لكونه امتاز عن الأناجيل الأخرى بأسلوبه الغنوصي، أو الفلسفي الرَّمزي.
2. سِفر أعمال الرُّسل.
3. الرَّسائل، وهي واحد وعشرون رسالة، ثلاثة عشرة منها بقلم بولس.
4. سِفر رؤيا يوحنَّا.
طريقة دراسة الكتاب المُقدَّس:
ينبغي على الدَّارس للكتاب المُقدَّس أن يلتفت في دراسته له إلى شيئين:
الشَّيء الأوَّل: مدى التَّوافق والتَّخالف بين أسفار الكتاب المقدَّس، وهو ما يُعرف بـ:" النَّقد النَّصي للكتاب المُقدَّس ".
الشَّيء الثَّاني: تاريخ نصوص الكتاب المقدَّس، مِن حيث زمن كتابتها، وصلتها بمن نقلها، والأحداث والوقائع الَّتي احتفَّت بها أثناء وقبل وبعد تدوينها، وهو ما يُعرف بـ: " النَّقد التَّاريخي للكتاب المُقدَّس ".
وفيما يلي نضرب أمثلةً على كلٍّ من ذينك الشَّيئين:
أوَّلاً: مدى التوافق والتَّخالف بين أسفار الكتاب المُقدَّس:
وقد كان التَّخالف بين أسفار الكتاب المُقدَّس على شكلين:
الشَّكل الأوَّل: التَّخالف بين سفرين مُختلفين، ومثل هذا كثير، نقتصر منه على مثالين:
المِثال الأوَّل: فيما قاله يسوع المسيح، عليه السَّلام، وهو على الصَّليب، كما يزعمون، ففي إنجيلي متَّى [27: 46 – 47] ومرقس [15: 34 – 35] أنَّ يسوع صرخ صرخةً شديدةً قائلاً: ((إلهي.. إلهي، لماذا خذلتني)). بينما جاء في إنجيل لوقا [23: 46] أنَّ يسوع يصرخ صرخةً عالية، إلاَّ أنَّه يقول: ((يا أبتاه، من يديك أستودع روحي)). وأمَّا عن إنجيل يوحنَّا فقد جاء في [19: 30] أن يسوع لا يصرخ، وأنَّه لا يقول إلاَّ ((تمَّ كلُّ شيء)) ثم يحني رأسه ويلفظ الرُّوح.
المِثال الثَّاني: اختلاف أسفار العهد الجديد في تحديد موعد صعود المسيح، عليه السَّلام، وقد كان ذلك على النَّحوِ الآتي:
1. لم يذكر كلٌّ من إنجيلي متَّى ويوحنَّا شيئاً عن صعود المسيح، عليه السَّلام، لا من قريب ولا من بعيد.
2. لوقا، وهو يذكر صعود المسيح، عليه السَّلام، في موضعين، هما:
الموضع الأوَّل: في إنجيله المعروف، إنجيل لوقا، وهو يحدِّدها بيوم قيامته، عليه السَّلام، من القبر.
الموضع الثَّاني: في سفر أعمال الرُّسل، الَّذي يُعتَقد أنَّه هو من ألَّفه، ويحدده فيه بعد أربعين يوماً من آلامه. والخلاف بين الرِّوايتين واضح.
3. مرقس، وهو يشير إلى الصُّعود من غير تحديد لتاريخه، وذلك في خاتمة تعتبر اليوم غير صحيحة .
الشَّكل الثَّاني: اختلاف السِّفر مع نفسه، من ذلك ما جاء في إنجيل متَّى [28: 19] أنَّ المسيح، عليه السَّلام، قال لأتباعه: ((اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمِّدوهم باسم الآب، والابن، والرُّوح القُدُس)). بينما جاء في الإنجيل نفسه [10: 5 - 6 و 15: 24] دعوة المسيح، عليه السَّلام، لأتباعه بأن يتجنَّبوا السَّامريِّين والوثنيِّين، وأن يقتصروا في دعوتهم على" خراف بني إسرائيل الضَّالَّة ".
أمَّا عن زمن تدوين الأناجيل، وهنا نبدأ بالنَّقد التَّاريخيِّ لها، فقد كان في القرن الثَّاني للميلاد. وهنا يظهر إشكال جليٌّ حول دقَّة هذه الأناجيل من حيثُ الاتِّصال بالسَّيِّد المسيح، عليه السَّلام.
ومن ناحية أخرى، فإنَّ الرَّاجح أنَّ كتابة الأناجيل كانت تعتمد على أجزاء منقولة شفهيَّاً اعتماداً على الذَّاكرة، وأنَّه لم يكن أيُّ نصٍّ مكتوب قبل ذلك، ففي التَّرجمة المسكونيَّة للعهد الجديد 1972 أنَّه ليس هناك شهادة تدلُّ على وجود مجموعة من الكتابات الإنجيليَّة قبل عام 140للميلاد.
نخلص من هذا الكلام إلى النتائج التَّالية:
1. لا يوجد سند متَّصل بالمسيح، عليه السَّلام؛ لأنَّه كما ذكرنا دُوِّنت الأناجيل بعد قرنين أو 140 من ميلاده، عليه السَّلام.
2. أنَّ كتابة الأناجيل في العام 140 كانت تعتمد اعتماداً مباشراً على الذَّاكرة، وانَّه عند كتابتها لم يكن أيُّ نصٍّ مكتوب.
ومن الجدير بالذِّكر هنا، أنَّ الكتاب المقدَّس قد كان عُرضةً للأيدي والإتلاف، ففي العام 325 للميلاد، وهو العام الذي عُقِدَ فيه مجمع نِيقْيَة الَّذي كانت من أهمِّ قراراته تأليه السَّيِّد المسيح، عليه السَّلام، قام الأمبروطور قسطنطين الأوَّل، وهو الدَّعي إلى المجمع، بإتلاف جميع الأعمال الَّتي تعارض تعاليم المجمع.
نظرة المسيحيِّين للكتاب المقدَّس:
ينقسم الوحي في نظر المسيحيِّين إلى قسمين:
القِسم الأوَّل: وحي الشَّخص، وهم يعنون به: تجسُّد أقنوم الابن في جسد المسيح، عليه السَّلام، وما تبعه من تعذيبه وصلبه وموته.
القسم الثَّاني: وحي الاختبار، وهم يعنون به: الكتاب المقدَّس بعهديه القديم والجديد، وهم يرون أنَّهما عبارة عن محاولات تفسيريَّة اجتهاديَّة، من قبل الكتبة، لوحي الكلمة.
فالعهد القديم في نظرهم عبارة اختبار الترقُّب والشَّوق لوحي الذَّات الآتي، والعهد الجديد عبارة اختبار المعايشة والمداناة لوحي الشَّخص بعد ظهوره. يقول الأب مشير عون في كتابه بين المسيحيَّة والإسلام: "... وأمَّا في المسيحيَّة، فالوحي، كما سنرى، وحي الشَّخص، ووحي الاختبار؛ فالله يعهد في وحيه الكامل، وهو كلمته يسوع المسيح، إلى بني الإنسان، به يختبرون في صميم وجودهم ومعاناتهم سرَّ ظهور الله في التَّاريخ، فالوحي المدوَّن هو اختبار بشريٌّ للوحي المتجسِّد، والوحي المتجسِّد هو قمَّة الاعتلانات التَّاريخيَّة للوحي الإلهيِّ.
ثمَّ قال: وهذا ما يُفسِّر إقبال المسيحيَّة على نصوص الوحي المدوَّنة إقبال التَّأويل الحرِّ الَّذي يُحيل مدلول الكلمة المدوَّنة إلى وحي الكلمة المتجسِّد، ويستشفُّ صورة الكلمة المتجسِّدة من خلال اختبار الأنبياء والرُّسل لاعتلان الكلمة الإلهيَّة في يسوع المسيح، وهو اختبار التَّرقُّب والتَّشوُّق في العهد القديم، واختبار المدانة والمعايشة في العهد الجديد " .
من خلال الكلام السَّابق للأب مشير عون يظهر لنا أنَّ المسيحيِّين لا يعتبرون الكتاب المقدَّس بوضع إلهيٍّ، كما هو القرآن الكريم عندنا نحن المسلمين، بل هو عبارة عن محاولات بشريَّة لاختبار وحي الشَّخص، وعلى هذا فإنَّ الكتاب المقدَّس يختلف عن القرآن الكريم من حيث إنَّ القرآن الكريم بوضع إلهيٍّ لا يصحُّ لأحد أن يبدِّله، أو يغيِّره، أو حتَّى يؤوِّله بتأويل غير سائغ لا يحتمله اللَّفظ، بينما نجد كلَّ هذا أمراً طبيعيَّاً مستساغاً عند المسيحيِّة في مقابل كتابها المقدَّس. كلُّ هذا دعا الأب مشير عون إلى أن يصف القرآن الكريم بأنَّه وحي الأمانة؛ لأنه لا يحقُّ لأحد من المؤمنين التَّبديل أو التَّغير فيه؛ إذ الَّذي يحقُّ له ذلك في الإسلام، هو الله تعالى وحده، بينما كان وحي الكتاب المُقدَّس، في نظر الأب مشير عون أيضاً، يمتاز عن وحي القرآن بأنَّه وحي الجرأة؛ لأنَّ الله تعالى عهد بتلك الأمور إلى خلقه، فيضعون فيه، ويحذفون منه، ما تمليه عليهم خبرتهم لوحي الشَّخص.
ويؤكِّد هذا الكلام تلك المفارقات الكبيرة الَّتي نجدها يوماً بعد يوم في نسخ الكتاب المقدَّس، مرَّةً بالزِّيادة، وأخرى بالنَّقص، وثالثة بإضافة بعض الأسفار، وحذف بعضها الآخر. في الوقت الَّذي لا نجد شيئاً من ذلك في نسخ القرآن الكريم على مَرِّ التَّاريخ.
إنَّ التَّبديل والزّيادة على الكتاب المقدَّس، بل وحتى مهاجمته، لا تعني شيئاً عند المسيحيِّين، وفي هذا يقول القس فهيم عزيز في كتابه المدخل إلى العهد الجديد: " لا تخشوا على الكتاب المقدَّس، ولا تخافوا من أيِّ هجوم؛ فنحن لا نعبد كتاب، ولكنَّنا نعبد السَّيِّد الموجود بين دفَّتي هذا الكتاب " .
نتيجة الكلام السَّابق:
أنَّ الكتاب المقدَّس فيه تناقضات، وغير ثابت تاريخيَّاً، وأخيراً ليس بوضع إلهيٍّ، بل هو عبارة عن اختبارات بشريَّة، لوحي الشَّخص، وهذه الاختبارات تحتمل الصِّحَّة، كما تحتمل الخطأ.
السُّؤال الأساسيُّ بعد كلِّ هذا: هل يصحُّ الاحتجاج بالكتاب المقدَّس على العقائد المسيحيَّة ابتداءً بمسألة التَّثليث وانتهاءً بالخطيئة والخلاص؟
إنَّ مسألة عدم صحَّة كثير من آيات وأسفار الكتاب المقدَّس، وعدم معرفة من كتبها، غدة اليوم من المسائل البدهيَّة الَّتي لا شكَّ فيها حتَّى من قِبَل الباحثين المسيحيِّين أنفسهم، وفي هذا يقول نهاد خيَّاطة في كتابه: الفِرق والمذاهب المسيحيَّة من البدايات حتَّى ظهور الإسلام، عن صاحب إنجيل متَّى: " لم يعد مقبولاً أن نقول اليوم إنَّه أحد تلاميذ المسيح " ، وقال عن صاحب إنجيل مرقس: " لم يكن أحد التَّلاميذ الاثني عشر، وربَّما كان أحد الاثنين والسَّبعين " ، وقال عن صاحب إنجيل يوحنَّا: " غير أنَّ بعض الدَّارسين من العلمانيِّين يذهبون إلى أنْ لا شيء معروفاً عن مؤلِّف الإنجيل الرَّابع، وأنْ ليس ثمَّة ما يدعو إلى الافتراض أنَّ اسمه يوحنَّا " .
ومثله كمال الصَّليبي إذ يقول في كتابه: البحث عن يسوع: "... وسوف نفترض أنَّ كلاًّ من هؤلاءِ الأربعة هو الَّذي كتب الإنجيل المنسوب إليه تسهيلاً للأمور، حتَّى لو لم يكن ذلك صحيحاً " .
النَّتيجة الحتميَّة بعد هذا الكلام: أنَّه لا يصحُّ الاحتجاج بشيء من الكتاب المقدَّس على العقائد المسيحيَّة. ولكن قبل إنهاء الكلام عن هذا المصدر من مصادر الدِّين المسيحيِّ، لا بدَّ أن نُنبِّه على شيئين:
الشَّيء الأوَّل: العقيدة من الاعتقاد، والاعتقاد هو الجزم من غير أي تردُّد، ويُشترط في المُعتقد حتَّى يُقبل عند الله تعالى ثلاثة شروط، وهي:
1. الجزم من غير أي تردد.
2. مطابقة المعتقد للواقع؛ فلو جزم إنسان أنَّ الله مؤلَّف من ثلاثة أقانيم وهو تعالى ليس كذلك لم يُقبل مُعتقده.
3. الدَّليل المُعتبر في الوصول إلى المُعتقد السَّليم؛ فلو جزم إنسان بأنَّ الله تعالى واحد، والله تعالى في الواقع كذلك، إلاَّ أنَّه لا يعرف الدَّليل، ولو إجماليَّاً على أنَّ الله تعالى واحد، لم يُقبل معتقده.
إذا تخلَّفت أحد الشّروط الثَّلاثة السَّابقة في المُعتقد لم يُقبل، أمَّا الجزم والمطابقة فظاهر، وأمَّا الدَّليل فلماذا كان شرطاً في قَبول المُعتقد، فيحتاج إلى توضيح، وهو كالآتي:
الجزم في المعتقد إمَّا أن يكون عناداً واستكباراً، وإمَّا أن يكون يقيناً، والَّذي يفصل بين الأمرين، أي بين اليقين والعناد، الدَّليل؛ فمن عَلِمَ الدَّليل المُعتبر في الوصول إلى المعتقد الحقِّ كان معتقده اعتقاداً يقينيَّاً، ومن فقد الدَّليل عليه، كان اعتقاده اعتقاد عناد واستكبار. هذا الكلام يظهر لنا مدى الصِّلة بين الدَّليل والجزم، وعليه، فمن كان دليله على معتقده دليلاً قطعياً، كان اعتقاده به اعتقاداً قطعيَّاً أيضاً، ومن كان دليله على معتقده دليلاً ظنِّيَّاً كان اعتقاده به اعتقاداً ظنِّيَّاً أيضاً، ولكنَّنا قلنا إنَّ شرط قبول المُعتقد الجزم، والظَّن، كما هو معلوم، يُنافي الجزم، لذلك لا يصحُّ الاستدلال على المعتقد بالأدلَّة الظنِّيَّة، والكتاب المقدَّس عند المسيحيِّين ليس ظنِّيَّاً فقط، بل ومشكوك فيه أيضاً، مشكوك في آياته، وأسفاره، وكَتَبَتِه، وكلُّ هذا باعتراف المسيحيِّين أنفسهم كما بيَّنَّا، لذلك لا يصحُّ من المسيحيِّين الاستدلال على عقائدهم بالكتاب المقدَّس؛ لأنَّه لا يورث يقيناً.
الشَّيء الثَّاني: قولنا إنَّ المسيحيِّين يستدلون على معتقداتهم بالكتاب المقدَّس فيه تجوُّز منَّا، خصوصاً فيما يتعلَّق بإلوهيَّة السَّيِّد المسيح، عليه السَّلام، وفكرة التَّثليث؛ حيثُ لا يوجد ولو نص واحد من نصوص الكتاب المقدَّس يدلُّ على إلوهيَّته، أو على مسألة التَّثليث، بل على العكس تماماً؛ فالكتاب المقدَّس مليء بالآيات الَّتي تدلُّ على وحدانيَّة الله تعالى، وبشريَّة المسيح، عليه السَّلام، وقد كتب المسلمون، قديماً وحديثاً، كتباً كثيرةً تدلُّ على هذا الأمر؛ فمن الكتب القديمة كتاب حُجَّة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، رضي الله تعالى عنه، والموسوم بـ: " الرَّد الجميل لإلوهيَّة المسيح بصريح الإنجيل "، ومن الكتب المعاصرة في هذا الموضوع أيضاً كتاب المفكِّر الإسلامي سعد رستم، وفَّقه الله تعالى، والموسوم بـ: " التَّوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القِديسين بولس ويوحنَّا ".
المصدر الثَّاني: المجامع الكنسيَّة :
والمجامع الكنسيَّة هي: هيئات شوريَّة في الكنيسة المسيحيَّة، يتشاور فيها أهل الاختصاص في الدِّين المسيحيِّ الأمور المتجدِّدة، أو الَّتي وقع فيها الخلاف، سواء أكانت مسائل أصلية عقائديَّة؛ كإلوهيَّة السَّيِّد المسيح، عليه السَّلام، أو فرعيَّة؛ كمسألة الختان.
والمجامع الكنسيَّة تنقسم إلى قسمين:
1. مجامع مسكونيَّة أو عالميَّة، وهي: المجامع الَّتي حازت قراراتها القَبول في المسكونة كلِّها.
وهذا التَّعريف للمجامع المسكونيَّة في نظر؛ لأنَّ عدداً من المجامع الَّتي تُعتبر مسكونيَّةً في نظر الطَّوائف المسيحيَّة، لم تَحُز قراراتها على القَبول في كلِّ المسكونة؛ كمجمع خلقيدونيَّة المنعقد سنة 451م الَّذي كانت أبرز قراراته: أنَّ أقنوم الابن يمتاز بطبيعتين، إحداهما لاهوتيَّة، والأخرى ناسوتيَّة ، هذا المجمع أخذت به الكنيسة الكاثوليكيَّة اللاَّتينيَّة، والكنيسة البروتستانتيَّة، في حين رفضته الكنيسة القبطيَّة الأرثوذكسيَّة، وقالت إنَّ أقنوم الابن ذو طبيعة لاهوتيَّة فقط.
وعليه يمكننا أن نعرِّف المجامع المسكونيَّة بتعريف آخر، هو أدَّق من التَّعريف السَّابق، بأن نقول هي: المجامع الَّتي حضرها رجال الدِّين المسيحيِّ من مختلف أرجاء المسكونة،سواء أجمعوا على قراراته أم لا.
2. مجامع إقليميَّة أو مكانيَّة، وهي: المجامع الَّتي حضرها رجال الدِّين المسيحيِّ للمنطقة الَّتي عُقد فيها المجمع؛ كمجمع سرديقية، وقرطاجة.
الَّذي عليه التَّعويل في الدِّين المسيحيِّ المجامع المسكونيَّة، أمَّا المجامع الإقليميَّة فليس عليها تعويل كبير.
أبرز المجامع المسكونيَّة هما: مَجمع نِيقْيَة المنعقد سنة 325م، ومَجمع خلقيدونيَّة المنعقد سنة 451م. أمَّا مَجمع نِيقْيَة؛ فلأنَّه أوَّل مَجمع مسكونيٍّ، ولأنَّ أبرز قراراته كانت تأليه السَّيِّد المسيح، عليه السَّلام، جاء في نصِّ المَجمع:
" نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكلَّ، خالق كلَّ شيء، ما يُرى وما لا يُرى، وبربٍّ واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود مِن الآب، ومِن جوهر الآب، إله مِن إله، نور مِن نور، إله حقٌّ من إلهٍ حقٍّ، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر، الَّذي به كان كلُّ شيءٍ، ما في السَّماء وما في الأرض، الَّذي مِن أجلنا نحن البشر، ومِن أجل خلاصنا، نزل مِن السَّماء، وتجسَّد، وتأنَّس ، وتألَّم " .
وأمَّا مَجمع خلقيدونيَّة؛ فلأنَّه أوَّل مَجمع مسكونيٍّ ناقش طبيعة المسيح، عليه السَّلام، وحدَّدها بأنَّ له، عليه السَّلام، طبيعتين، إحداهما لاهوتيَّة، والأخرى ناسوتيَّة، كما ذكرنا قبل قليل. جاء في نصِّ المَجمع: "... إنَّنا نعترف بالابن أو الرَّب يسوع المسيح، هو نفسه كاملاً في اللاَّهوت، وكاملاً في النَّاسوت، هو إله حقٌّ، وإنسان حقٌّ، مؤلَّف من نفس وجسد، وهو واحد في الوقت نفسه، من جوهر كجوهر الآب مِن جهَّة لاهوته، ومِن طبيعة كطبيعتنا مِن جهَّة ناسوته، مثلُنا في كلِّ شيءٍ ما عدا الخطيئة " .
تأمُّلات في المجامع المسكونيَّة:
لو تفكَّرنا قليلاً في المجامع المسكونيَّة، لوجدنا أنَّها تشبه، لحدٍّ ما، ما يُعرف عندنا نحن المسلمين بـ:
" الإجماع "، والإجماع عندنا، كما هو معلوم، حجَّة قطعيَّة تنزل منزلة القرآن الكريم، والسُّنَّة النَّبويَّة المتواترة، وهو كذلك حُجَّة معتبرة في أصول الدِّين؛ أي عقائده، وفروعه؛ أي فقهه، وعليه، فإنَّ ما أجمعت عليه أمَّتُنا، وَجَبَ على كلِّ فردٍ منَّا أن يُسلِّم به؛ لأنَّه إن أنكره، فسيحول به إنكاره حينها إلى الكفر؛ لأنَّ إنكاره للأمر المُجمع عليه ينزل منزلة إنكار شيء من القرآن الكريم أو السُّنَّة النَّبويَّة المُتواترة.
إذن، الإجماع في الدِّين الإسلاميِّ حُجَّة قطعيَّة، ولكنَّ السُّؤال: ما هو الأساس في اعتبار الإجماع حُجَّةً قطعيَّةً في الإسلام؟ والجواب: أنَّ الأساس في ذلك هو الدِّين الإسلاميُّ نفسه؛ فهو الَّذي اعتبر أنَّ إجماع الأمَّة حُجَّة قطعيَّة، وذلك عندما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " لا تجتمع أمَّتي على ضلالة "، وعليه، فإنَّ الإسلام لو لم يعتبر الإجماع حجَّةً قطعيَّةً، فإنَّه لن يكون حجَّةً قطعيَّةً، ممَّا يُبيِّن لنا أنَّ اعتبار الإجماع أو عدم اعتباره يعود إلى الدِّين نفسه، لذلك وجدنا علماء أصول الفقه يقولون عن الإجماع إنَّه حُجَّةً سمعيَّةً؛ أي إنَّ اعتباره في الاستدلال على العقائد والأحكام راجع إلى السَّمع أو الشَّرع، ولكن، إن لم تثبت صحَّة الدِّين الإسلاميِّ، فهل يكون الإجماع مُعتبراً في الاستدلال؟ بالطَّبع لا؛ لأنَّ الأساس في اعتباره، وهو الدِّين الإسلاميُّ، لم يَثبُت حتَّى يُثْبِت، فيجب أوَّلاً إثبات صحَّة الديِّن، ثمَّ بعد ذلك إثبات الأشياء الأخرى الَّتي أثبتها الدِّين؛ كالإجماع.
والمجامع المسكونيَّة مِن هذه النَّاحية، تأخذ حُكم الإجماع عندنا نحن المسلمين؛ فلا يصحُّ لهم الاحتجاج بها على غيرهم قبل ثبوت أحقِّيَّة دينهم؛ للسَّبب نفسه الَّذي ذكرناه، وهو: أنَّ اعتبار حجِّيَّة هذه المجامع متوقِّفٌ على إثبات صحَّة الدِّين المسيحي، ولكنَّ الدِّين المسيحيَّ لم يثبت بعد، فلا يصحُّ الاحتجاج بالمجامع المسكونيَّة.
ومن ناحية أُخرى، فإنَّنا نحن المسلمين، حتَّى مع اعتبارنا أنَّ الإجماع حجَّة قطعيَّة، إلاَّ أنَّنا لا نستدل به على غيرنا من غير المسلمين، إذ إنَّه ليس مِن المقبول أن أجيب شخصاً غير مسلم سألني عن الدَّليل على وَحدانيَّة الله تعالى بقولي: الدَّليل على ذلك أنَّ الأمَّة الإسلاميَّة أجمعت على القول بوحدانيَّة الله تعالى.
والكلام نفسه ينزل على المسيحيِّ؛ إذ إنَّه من غير المقبول منه أيضاً أن يكون جوابه على سؤالي له عن الدَّليل على أنَّ المسيح، عليه السَّلام، إله، بأن يقول لي إنَّ نصَّ مَجمع نِيقْيَة قال هذا.
بقي أن نُشير إلى أنَّ شرط اعتبار الإجماع في الدِّين الإسلاميِّ هو إجماع كلُّ مجتهدي العصر على حُكم الواقعة الشَّرعيَّة؛ فلو خالف أحد المجتهدين، ولو كان واحداً فقط، في الواقعة الشَّرعيَّة، لم يتحقَّق الإجماع، وبالتَّالي لم يُعتبر، ولكن، لو نظرنا إلى المجامع المسكونيَّة، فهل سنجدها حقَّقت الإجماع بهذا المعنى؟ نترك الجواب لمَجمعي نِيقْيَة وخلقيدونيَّة؛ أمَّا نِيقْيَة فقد حضره 2041 أسقفاً، واللَّذين أجمع منهم على إلوهيَّة السَّيِّد المسيح، عليه السَّلام، 318 أسقفاً فقط . وأمَّا خلقيدونيَّة، فقد ذكرنا أنَّ الكنيسة القبطيَّة الأرثوذكسيَّة بأكملها ترفض هذا المَجمع. ومع كلِّ هذا يبقى المسيحيُّون مصرِّين على الاستدلال بهذه المجامع على عقائدهم الأصليَّة؛ كإلوهيَّة المسيح، عليه السَّلام، وطبيعته.
المصدر الثَّالث: الأقيسة المُتَّخذة من الخليقة المحسوسة:
وهي: أمثلة من العالَم المحسوس تُحاول من خلالها الطَّوائف المسيحيَّة الَّتي تبنَّت فكرة التَّثليث، التَّوصُّل إلى أنَّ الجمع بين الوحدة والكثرة أمر ممكن.
وقد سلكوا هذا المسلك؛ لتبرير مقولتهم المشهورة: " الله ثلاثة في واحد، وواحد في ثلاثة "، فلمَّا ألزمناهم بالمناقضة؛ من خلال أنَّ الجمع بين الوحدة والكثرة أمر لا تقبله بداهة العقول، احتجُّوا بهذه الأدلَّة الَّتي زعموا أنَّها توضِّح مقصودهم من عبارتهم السَّابقة، ولكن، هل هي كذلك فعلاً؟
المثل المشهور على هذه المقولة عند المسيحيِّين هو: " مِثال الشَّمس المكوَّنة مِن: قُرص الشَّمس، والضُّوء، والحرارة "؛ فهم يقولون: إنَّ الشَّمس رغم أنَّها تتكوَّن مِن تلك الأشياء، وهي: قُرص الشَّمس، والضُّوء، والحرارة، إلاَّ أنَّها في الوقت نفسه تبقى شمساً واحدةً، وكذلك الله؛ فهو رغم أنَّه يتألَّف من ثلاثة أقانيم، وهي: الآب، والابن، والرُّوح القُدُس، إلاَّ أنَّه يبقى إلهاً واحداً.
لا يخفى على المُتبصِّر أنَّ هذه مُغالطة واضحة، وكونها مُغالطة يظهر من عدَّة وجوه، نذكر مِنها:
الوجه الأوَّل: وهو جواب للسُّؤال التَّالي: هل قرص الشَّمس، ونورها، وحرارتها، شيء واحد، بحيث إنَّنا نستطيع أن نقول إنَّ قرص الشَّمس شمس، ونورها شمس، وحرارتها شمس؟ الجواب بالطَّبع لا؛ لأنَّ الأمر لو كان كذلك لصحَّ لنا أن نقول إنَّ قُرص الشَّمس ضوئها، وإن ضوء الشَّمس حرارتها، وإن حرارة الشَّمس قُرصها، ولكنَّ هذا الكلام فاسد؛ إذ قرص الشَّمس ليس ضوئها، وضوئها ليس حرارتها، وحرارتها ليست قرصها، ممَّا يُبيِّن لنا أنَّ الشَّمس تحتوي على ثلاثة أشياء مُختلفة، شيء يُقال له قُرص الشَّمس، وشيءٌ آخر يُقال له ضوء الشَّمس، وشيء ثالث يُقال له حرارة الشَّمس، وعلى ضوء ذلك، فإنَّه لا يُمكن الجمع بينها بحيث تكون شيئاً واحداً في حال مِن الأحوال. ومثله نقول في قولهم عن الله تعالى: إنَّه ثلاثة في واحد؛ فهم بصريح عبارتهم قاسوا فكرتهم عن الله تعالى على الشَّمس، وعليه، فإنَّ ما يَلزم على الشَّمس يلزم على فِكرتهم عن الله تعالى، وتوضيحه: أنَّ الله عندهم مؤلَّفٌ مِن ثلاثة أقانيم، كما قُلنا، وهي: الآب، والابن، والرُّوح القُدُس، وعليه، هل يصحُّ أن نقول عن الآب ابناً، وعن الابن روح قُدُس، وعن الرُّوح القُدُس أباً، إن من يقول بهذا القول عند المسيحيِّين يُعتبر مُهَرْطِقاً ؛ بمعنى كافر أو مُرتدٌّ عن الدِّين المسيحيِّ، لماذا؟ لأنَّ الآب غير الابن، والابن غير الرُّوح القُدُس، والرُّوح القُدُس غير الآب، وإلاَّ، فما هو المانع مِن ذلك؟!
كلُّ هذا يؤكِّد لنا شيئاً واحداً، وهو أنَّ المسيحيِّين مهما حاولوا إظهار مُعتقدهم بمظهر التَّوحيد لله تعالى، إلاَّ أنَّ الشِّرك بالله تعالى سيبقى ملتصقاً بمعتقدهم أشد التصاق، حتَّى يسلِّموا بالحقِّ الثَّابت في الإسلام، لذلك فإنَّ أكثر الأشياء الَّتي نتذكَّرها هنا قول الله تعالى: {لقد كفر الَّذين قالوا إنَّ الله ثالث ثلاثة وما من إلهٍ إلاَّ إلهٌ واحد، وإن لم ينتهوا عمَّا يقولون ليمسَّنَّ الَّذين كفروا مِنهم عذاب أليم} .
الوجه الثَّاني: أنَّ هذا المصدر من مصادر الدِّين المسيحيِّ غير مُجمع عليه، بل إنَّ مِن المسيحيِّين من أنكره، وفي هذا يقول القُمُّص ميخائيل مينا في كتابه علم اللاَّهوت عن هذا المصدر مِن مصادر الدِّين المسيحـيِّ: " انقســم اللاَّهوتيُّون إلى فريقين مِن جهَّة الأقيسة المُتَّخذة مِن الخليقة: ففريق منهم رفضها رفضاً باتَّاً؛ بحُجَّة أنَّه ليس للتَّثليث المُقدَّس نظير بين جميع المخلوقات " . وعلى هذا نقول: نحن المُسلمين أولى بالرَّفض لهذا القياس استناداً على نفس الحُجَّة الَّتي احتجَّ بها اللاَّهوتيُّون المًُنكِرون للأقيسة المُتَّخذة من الخليقة المحسوسة؛ لأنَّ إيماننا بأنَّ الله تعالى: {ليس كَمثله شي} ، وأنَّه: {لم يكن له كفواً أحد} أشدُّ من إيمانهم بهذه الحقيقة الثَّابتة لله تعالى.
الوجه الثَّالث: أنَّ حقيقة القياس هي: ردُّ فرع إلى أصل لاشتراكهما في العلَّة تسمَّى " مناط الحُكم "، والسُّؤال الآن: هل من علَّة تجمع بين الله تعالى والشَّمس تُصحِّح قياس الله تعالى عليها؟ إن كان يوجد علَّة تصحِّح هذا القياس فعليهم بيانُها، وإلاَّ، فقد ظهر لنا قطعاً فساد قياسهم.
إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الملخَّص عن مصادر الدِّين المسيحيِّ، مع بيان طرفٍ من بيان عدم حُجِّيتها ونفعها في إيضاح المقصود منها.
فالحمد لله ربِّ السَّماوات وربِّ الأرض ربِّ العالمين، وله الكبرياء في السَّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
والصَّلاة والسَّلام على خير الخلق والمُرسلين، سيدنا محمَّد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العليِّ العظيم.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة خادم الحسين في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 11-03-2016, 05:54 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى الأبحاث والدراسات المسيحية للداعية السيف البتار
مشاركات: 9
آخر مشاركة: 23-10-2012, 01:53 AM
-
بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 12
آخر مشاركة: 08-04-2012, 09:56 PM
-
بواسطة دفاع في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 3
آخر مشاركة: 05-10-2010, 08:04 PM
-
بواسطة ebn_alfaruk في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
مشاركات: 3
آخر مشاركة: 03-09-2006, 09:29 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى







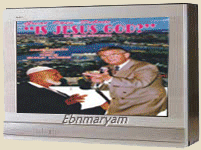

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


المفضلات