




-

وقد ذكر الباحثون أنّ للديمقراطيّة في مجالات السياسات والنظم ما لا يقل عن خمس ميزات أساسيّة هي:
1. المساواة أمام القانون.
2. المساواة في الاقتراع.
3. انتخاب الممثلين النيابيين دورياً.
4. التشريع بموافقة الأغلبيّة.
5. حريّة العمل السياسي ووضع البرامج السياسيّة.
(يراجع بالتفصيل معنى الديمقراطية، صول. ك. بادوفر، ترجمة جورج عزيز، دار الكرنك للنشر القاهرة 1997م، ص 19.).
ويقول الدكتور عدنان الأتاسي: ومن الوجهة العمليّة إنّ للديمقراطية اليوم شقين يتمم أحدهم الآخر:
1ـ تعني الديمقراطيّة تمتع كل مواطن بالأمن الشخصي وبالحريّات المدنيّة والسياسيّة، وخاصّة بالمساواة في الحقوق والواجبات، وبقضاء عادل مستقل.
2ـ تعني الديمقراطيّة أيضاً، أن يكون للمواطنين رأي في انتقاء الحكام وفي توجيه الحكم ومراقبته، وذلك عن طريق التصويت العام الحرّ في فترات متقاربة (الديمقراطية التقدميّة والاشتراكية الثوريّة، ص 97.).
فهي تقول بحقّ الإنسان بأن يعيش حرّاً ضمن حدود القانون، وأن يساهم في الحياة السياسيّة ضمن نظام قائم على إرادة الشعب (الديمقراطية التقدميّة والاشتراكية الثوريّة، ص 114)، وبحيث تتعمق هذه المبادئ في حس المواطنين وسلوكهم وهذا يقتضي إطلاق حريات الأفراد، والالتزام برأي الأكثرية مع احترام رأي الأقلية، في إطار تطبيق القانون على الجميع. ذلك أنّ تطبيق المبادئ الديمقراطيّة يحتاج إلى تربية سياسيّة وتوجيه مستمر حتى لا تقع الأخطاء ويقع القصور في الممارسة والتطبيق (انظر المرجع نفسه عند الحديث عما أسماه بعيوب الديمقراطيّة وكيفية علاجها، ص 132 وما بعدها.).
وواضح أنّ هذا الفهم يجعل التشريع للأغلبيّة من خلال الممثلين النيابيين، من منطلق أن التشريع ووضع القوانين الضابطة لنواحي الحياة المتعددة هو من صلاحيّة الشّعب يمارسها من خلال مجلس منتخب تؤخذ القرارات فيه بالأغلبيّة. فهو فهم لا يلاحظ ولا يهتم بوجود شريعة إلهيّة حملها الرسل والأنبياء يجب الالتزام بها والعمل بموجبها، لذلك يهاجم كثير من المتمسكين بوجوب تطبيق الشريعة هذا الفهم وينددون به، ويعتبرونه مخالفاً لوجوب تطبيق الشريعة، ومن هنا فإنّ عدداً من العلماء المسلمين أشاروا إلى هذا الفهم ومتعلقاته باعتباره نوعاً من أنواع الحكم الذي يختلف عن الحكم الإسلامي المقبول.
وقد نبّه ابن خلدون في مقدمته إلى أنواع الحكم بالنظر إلى نوعيّة ما يطبقه الحكم على الناس فقسمها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: المُلك الطبيعي، وهو الحكم الذي يقوم على مقتضى الفرض والشهوة، والغلبة والقهر، دون أن يكون هنالك أي قوانين تطبق على الناس. وهو ما يسمى بالحكم الديكتاتوري، وهو الذي تكون فيه إرادة الحاكم هي الفيصل الحاكم في جميع شؤون الدولة والرعيّة.
القسم الثاني: المُلك السياسي، وهو الحكم الذي يقوم على حمل الكافة على تطبيق قانون وضعي مبني على النظر العقلي في جلب المصالح ودفع المضار، وذلك من قبل عقلاء الأمة وأكابرها.
القسم الثالث: الخلافة؛ وهو الحكم الذي يقوم على حمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالح الدنيا والآخرة، فهي خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
ثمّ بيَّن ابن خلدون بعد ذلك أنّ المُلك الطبيعي مذموم، لأنه جور وعدوان لا يقوم على قانون أو شرع، وأنّ الملك السياسي مذموم كذلك، لأنه نظر بغير نور الله، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، والشارع أعلم بمصالح الكافة منهم.
والمُلك السياسي يُعنى بمصالح الدنيا، ولا يهتم بمصالح الآخرة.
أمّا الخلافة فتسير بنور الله، وتعمل بوحيه المنزل، وتهتم بمصالح الناس الدنيويّة والأخرويّة، فهي أحسن أنواع الحكم (انظر ذلك في الفصل الخامس والعشرين من المقدمة، ص 190 – 191، وانظر الملكيّة في الشريعة الإسلاميّة، د. عبد السلام العبادي، ج 2، ص 236.).
ويظهر من تقسيم ابن خلدون هذا لأنواع الحكم أنه يعتبر الأساس في التمييز بين أنواع الحكم هو نوعية القوانين التي تنظم شؤون الحكم وتسيّر أموره؛ فالقانون الذي يمارس الحكم تطبيقه هو الذي يحدد طبيعة الحكم ونوعية وظائفه. ومن هنا كان لنظام الحكم الإسلامي طبيعة خاصّة، ووظائف متميزة، لأنه هو الذي يطبق شريعة الله الكاملة؛ حكم يكمل بقدر ما يطبّق من أحكام الشريعة، والمهم فيه تطبيق الأحكام الشرعيّة.
أمّا التسميات التي تطلق عليه فيلاحظ فيها أمر أو آخر، فتسميته بالخلافة باعتبار أنه خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق الشريعة الإلهيّة الخاتمة والالتزام بها (انظر مقدمة ابن خلدون، 191.).
وتسميته بالإمامة باعتبار أنّ الحاكم يتقدم المسلمين في الصلاة وغيرها. وواضح في الأنظمة الديمقراطيّة أنّ أكابر الأمّة وعقلاءها يتم اختيارهم من الشّعب، فالمجلس المنتخب هو الذي يضع القوانين. وفي الدولة الحديثة، وأمام تقسيم السلطات إلى ثلاث: تنفيذيّة وتشريعيّة وقضائيّة، فإنّ السّلطة التشريعيّة هي التي تمثلها المجالس المنتخبة من الشّعب.
والشريعة التي يطبقها الحكم الإسلامي لها منهجها في تنظيم الواقع الإنساني، فهو الذي يقوم عليه الفقه الإسلامي، فهي في تنظيمها لحياة الناس قد وضعت القواعد العامّة والمبادئ الأساسية، ونصّت على كثير من الأحكام التفصيلية التي لا يتغيّر فيها الحكم بتغير الأزمنة، وتركت كثيراً من الأمور التفصيلية لتنظم في كل عصر بحسبه، وفق ما يقدر عليه العقل الإنساني، ويقدمه نمو المجتمع الإنساني، على أن يظل ذلك في إطار مبادئ الشريعة العامة وقواعدها الأساسيّة، ولا يخرج على نصوصها. ويكون ذلك وفق قواعد الاجتهاد التي قررتها الشريعة لاستنباط الأحكام للحوادث المستجدة والقضايا الحادثة من نصوص الشريعة، ويكون ذلك لولي الأمر وفقهاء الشريعة بالوسائل التي اعتمدتها وقررتها لضبط عملية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعيّة الخاصّة والعامّة.
وقد فصل القول في هذه القواعد علم أصول الفقه؛ فبيَّن مصادر الأحكام الشرعيّة، وقواعد الاستنباط وشروط الاجتهاد وكل ما يتعلق بمعرفة القواعد التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتها التفصيليّة.
ولكون ولي الأمر الإمام هو الذي يسهر على تنفيذ الشريعة، وتطبيق أحكامها في كل الحوادث والنوازل فقد اشترط فيه العلم المؤدي إلى القدرة على الاجتهاد لمعرفة حكم النوازل والحوادث الطارئة من نصوص الشريعة، وعندما وجد خلفاء لم يصلوا إلى هذه الرتبة، ولم يتوافر فيهم هذا الشرط، بيَّن الفقهاء أنه لابد أن يتحقق هذا الشرط عن طريق اعتماد الإمام على المجتهدين من الأمّة، فلا يقطع رأياً دونهم.
وعلى ضوء هذا الاستعراض فإنّ أهم ميزة للحكم الإسلامي أنه يطبق الشريعة الإسلاميّة، وأنّ تطبيق الشريعة الإسلاميّة يتطلب باستمرار اجتهاداً يواكب حركة المجتمع وحاجاته ليستنبط لكل ذلك الأحكام الشرعيّة اللازمة، وأنّ هذا الأمر أوسع من مجرّد إدارة الدولة المباشرة والقيام على شؤونها الخاصّة، وهو الذي يعالج من خلال إقامة ولي الأمر، أي إقامة الدولة. وقد بيّن العلماء أدلة وجوب إقامة الدولة.
وكان أهم أدلتهم على ذلك وجوب تطبيق الشريعة الذي لا يمكن أن يتم دون أن تقوم دولة تسهر على ذلك، وتعمل على تحقيقه بين الناس، ولذلك اهتموا في بدايات بحثهم في الفقه السياسي في الإسلام بهذا الأمر وعالجوه بإفاضة وتوسّع، وبينوا أنّ إقامة الدولة حكم شرعي، وأنّ الإسلام قد عنى بتنظيم شؤونها، وأنّ هنالك نصوصاً مباشرة تعالج هذا الأمر؛ يتضمن بعضها أحكاماً تفصيليّة، ويتضمن بعضها الأخر مبادئ كلية تستوعب في تطبيقها تفصيلات كثيرة قد تختلف باختلاف الأماكن والأزمان، وذكروا من ذلك مبدأ الشورى فهو قاعدة من قواعد الحياة الإسلاميّة سياسيّة أو غير سياسيّة، متروك للاجتهاد في كل عصر أن يستحدث من الصور والتفصيلات ما يمكن من تطبيقها والالتزام بها أحسن تطبيق والتزام.
وهذا يطرح قضية البحث الأساسيّة في إمكانيّة تبني نظام الحكم الإسلامي لصيغ الديمقراطيّة وآلياتها المعاصرة وهي نتاج جهد إنساني كبير، وذلك على أساس قواعد الاجتهاد المقررة في الشريعة، وفي إطار ما يمكن أن يستوعبه مبدأ الشّورى المقرر قاعدة أساسيّة من قواعد نظام الحكم في الإسلام، بل إنّ بعضها له نظير في تطبيقات هذا المبدأ في صدر الإسلام، وهذا ما سوف أخصص له المطلب الثالث من هذا البحث بعد أن استعرض في المطلب الثاني حقيقة الشّورى في النظر الإسلامي، ومدى استيعابها للصيغ الديمقراطيّة المعاصرة.
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة صاحب القرآن في المنتدى فى ظل أية وحديث
مشاركات: 76
آخر مشاركة: 21-06-2015, 12:43 AM
-
بواسطة ابوغسان في المنتدى اللغة العربية وأبحاثها
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 26-11-2014, 06:23 PM
-
بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 13-03-2010, 02:00 AM
-
بواسطة ياسر سواس في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 16-02-2010, 10:39 PM
-
بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 08-09-2007, 12:22 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى









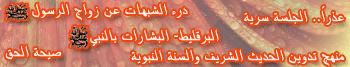

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


المفضلات