




-

الفرع الأول
من مبادئ نظام الحكم في الإسلام
مبدأ المساواة
أ ـ جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص صريحة تقرر نظرية المساواة وتفرضها فرضاً، فالقرآن الكريم يقرر المساواة ويفرضها على الماس جميعاً في قوله تعالى:
[يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)] الحجرات: 13.
والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكرر هذا المعنى في قوله:" الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى". ثم يؤكد هذا المعنى تأكيداً في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لأن الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم".
ويلاحظ على هذه النصوص أنه فرضت المساواة بصفة مطلقة، فلا قيود ولا استثناءات، وأنها المساواة على الناس كافة أي على العالم بصفة مطلقة، فلا فضل لفرد على فرد، ولا لجماعة على جماعة، ولا لجنس على جنس، ولا للون على لون، ولا لسيد على مسود، ولا لحاكم على محكوم..
وهذا هو نص القرآن الكريم يذكر الناس أنهم خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى ولا تفاضل إذا استوت الأصول وإنما مساواة، وهذا هو قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يذكر الناس أنهم جميعاً ينتمون لرجل واحد خلق من تراب فهم متساوون ويشبههم في تساويهم بأسنان المشط الواحد، ولم يعرف أن سنًّا من مشط فضلت على سنة أخرى..
وقد نزلت نظرية المساواة على الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يعيش في قوم أساس حياتهم وقوامها التفاضل فه يتفاضلون بالمال والجاه، والشرف واللون، ويفاخرون بالآباء والأمهات، والقبائل والأجناس، فلم تكن الحياة الاجتماعية وحاجة الجماعة هي الدافعة لتقرير نظرية المساواة، وإنما كان الدافع لتقريرها من وجه آخر ضرورة تكميل الشريعة بما تقتضيه الشريعة الكاملة الدائمة من مبادئ ونظريات..
ولا جدال في أن عبارة النصوص جاءت عامة مرنة إلى آخر درجات العموم والمرونة، فلا يمكن مهما تغيرت ظروف الزمان والمكان والأشخاص أن تضيق عبارة النصوص بما يستجد من الظروف والتطورات، والعلة في وضع نصوص الشريعة على هذا الشكل أن الشريعة لا تقبل التعديل والتبديل فوجب أن تكون نصوصها بحيث لا تحتاج إلى تعديل أو تبديل.
وإذا كانت نظرية المساواة قد عرفت في الشريعة الإسلامية من خمسة عشر قرناً فإن القوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.
إذن فقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير المساواة بثلاثة عشر قرناَ، ولم تأت القوانين الوضعية بجديد حين قررت المساواة، وإنما سارت في أثر الشريعة واهتدت بهداها، وسيرى القارئ فيما بعد أن القوانين الوضعية تطبق نظرية المساواة تطبيقاً محدوداً بالنسبة للشريعة الإسلامية التي توسعت في تطبيق النظرية إلى أقصى حد.
أما مصطلح المساواة (Equality) في الفكر العلماني، فيشير إلى حالة التماثل بين الأفراد في المجتمع.
والمساواة بالمفهوم البرجوازي تعني المساواة بين المواطنين أمام القانون، بينما يبقى الاستغلال والتفاوت بين أفراد الشعب دون مساس.
أما الماركسية فترى أن المساواة الاقتصادية والثقافية مستحيلة بدون الغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتصفية الطبقات المستغِلة.
ويشيع أيضاً مصطلح (التفاوت)، أو عدم المساواة (Inequality)، الذي يعني التفرقة بين الأفراد على أساس العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي، أو أسس التمييز الأخرى في التعليم والعمل وأمام القانون، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وينظر إلى التفاوت الاجتماعي على أنه نتيجة للفروق بين الخصائص الشخصية للأسر (كالقوة والذكاء والحافز)، ولإنتاجية أعضاء الأسرة، كما يظهر التفاوت بسبب وراثة الثروة Wealth والقوة (النفوذ) Power والهيبة Prestige داخل الأسرة، وبسبب أن الجماعات المسيطرة في كل المجتمعات الطبقية تكوّن أفكاراً ومعتقدات تبرر لها الأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة.
هذه هي نظرية المساواة كما تطلع علينا بها القوانين الوضعية الحديثة لا تزال مهيضة الجناح، مقصوفة الأطراف، لم تسمو بين الرؤساء والمرؤوسين، والحاكمين والمحكومين، لم تسو بين الأفراد، ولا بين الجماعات، ولا بين الغني والفقير.
وقد يدهش بعض الذين لا يعلمون أن نظرية المساواة التي لم يتم نضجها وتكوينها في القانون الوضعي الحديث قد نضجت تمام النضج، وتكونت تمام التكوين ووصلت إلى أقصى مداها في الشريعة الإسلامية ولا تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بهذا فقط، بل تتميز عليها أيضاً بأنها عرفت نظرية المساواة على هذا الوجه منذ خمسة عشر قرناً، بينما لم تبدأ القوانين الوضعية بمعرفتها إلا في آخر القرن الثامن عشر.
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة صاحب القرآن في المنتدى فى ظل أية وحديث
مشاركات: 76
آخر مشاركة: 21-06-2015, 12:43 AM
-
بواسطة ابوغسان في المنتدى اللغة العربية وأبحاثها
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 26-11-2014, 06:23 PM
-
بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 13-03-2010, 02:00 AM
-
بواسطة ياسر سواس في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 16-02-2010, 10:39 PM
-
بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 08-09-2007, 12:22 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى









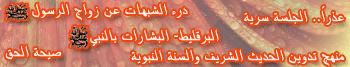

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


المفضلات