




-

شملت هذه الوثيقة النبوية جملةً من البنود القانونية والحقوقية:
1 - ففيها الدستور المدون، والمصاغ صياغة قانونية، والذي طبق منذ اللحظات الأولى لبناء مجتمع الإسلام بيثرب منذ 1440 عاماً. (نحن الآن في العام 1440للهجرة).
2 - وفيها النصوص التي تبين علاقة الراعي برعيته، والقاضي وآدابه وضروراته اللازمة للوفاء بتحقيق المساواة والعدالة بين الناس بمختلف مللهم ونحلهم.
3 - وفيها الصياغة البليغة للعلاقات الدولية بين مختلف الطبقات الاجتماعية بمختلف عقائدها وأصولها.
4 - وفيها حق الأمة في العدل والأمن والتناصر والتعاون، والحقوق الإنسانية والاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع.
5 - وفيها مبدأ الشورى بين الحاكم والمحكومين والراعي ورعيته، وذلك من خلال هذه الوثيقة التي كانت ثمرةً لمشاورته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوجوه الرعية، الذين يسمون فيه «أهل هذه الصحيفة»، فالكتاب ينظم العلاقات بين مختلف مكونات مجتمع المدينة بكل فئاته، فرداً بفرد وجماعةً بجماعة وحاكماً بمحكومية، وهذا مما تجب فيه الشورى وفق منطوق القرآن الكريم ومفهومه ونصوص الحديث النبوي الشريف.
6 - وفيها التكافل بين رعية الأمة وجماعتها في مختلف الميادين سواء المادية أم المعنوية (المعاهدة على نصرة المظلوم، وحماية الجار، مساعدة المدين، ورعاية الحقوق الخاصة والعامة..)، الأمر الذي يعني رفض حمية الجاهلية.
7 - فالصحيفة أو الوثيقة تم بموجبها تنظيم العلاقات في هذا المجتمع الإسلامي الجديد سواء بين مكوناته أم بين من انضوى تحته وخاصة من كان بالمدينة من اليهود.
8 - لقد وضعت الصحيفة المبادئ الأساسية لهذا المجتمع؛ باعتبار المسلمين أمةً واحدةً، بعضهم أولياء بعض، يتعاونون بينهم ويتحابون ويتراحمون، واضعين النُّعرات القبلية وحمية الجاهلية تحت أقدامهم، لا فرق بين أسود وأبيض ولا بين عربي وعجمي إلا بالتقوى.
9 - كما بينت الصحيفة حقيقة الحرية معرضة عن التعصب... حتى ولو مع اليهود الذين أعطت لهم حقوقهم كاملةً، كحق الجوار ما التزموا ببنود الصحيفة.
10 - كما نصت الصحيفة على أن الناس أمة واحدة، ولاحظوا استخدام لفظ «الأمة»، للمساواة بين جميع الأطراف في المواطنة، فالمؤمنون والمسلمون أمة واحدة، واليهود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، «وأنه من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة».
11 - كما بيّنت هذه الوثيقة وطن هذه الأمة التي يشملها هذا الدستور، وأنه حرم آمن لرعية الدولة، كما قررت في نفس الوقت، أن لا حصانة لظالم أو آثم، حتى ولو كان معتصماً «بيثرب» عضوًا برعية دولتها.
12 - كما رفضت الصحيفة الاستبداد والطغيان، وجعلت كتاب الله تعالى وسنة رسول الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفيصل والحاسم عند كل خلاف وتنازع بين كل فئات هذا المجتمع.
13 - كما تضمنت الصحيفة بنودًا للدفاع عن المدينة إذا هاجم العدو فئةً من فئاتها.
14 - ووافقت كل فئات المجتمع على نصوص هذا الدستور الجديد، بما فيهم يهود المدينة بمختلف قبائلهم.
وبالعودة إلى تفصيلنا نجد أن أسبق النصوص والوثائق وثيقة المدينة، التي عقدها النبيّ المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع (أهل يثرب)، والتي لم تكن إلاّ دستوراً مدنياً ضامناً للحقوق والحرّيات، ومحدِّداً لسلطات الدولة، بحيث يمكن الاستناد لأصل من الأصول النظرية المدوّنة للخروج من هذه الثنائية التي يُراد للتجربة السياسية الإسلامية أن تنحشر فيها؛ إما ترك الشأن العام؛ أو تطبيق الدولة الدينية؛ لأن المهم في هذه الوثيقة أنها قد صدرت عن مقام النبوّة المعصومة التي تبلِّغ عن الله تعالى، وإن أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنّة ملزمة، ومرجعٌ للتشريع.
ثم إنها وثيقة مكتوبة في عام 622م، أو السنة الأولى للهجرة.
وإنها ناتج مباحثات ومشاورات بين قطاعات دينية واجتماعية مختلفة، تشكل المكونات الاجتماعية في يثرب.ثم إنها وضعت للتطبيق العملي في بواكير تأسيس دولة جديدة، يتنوّع شعبها تنوعاً في الأديان والأعراق، فأقيمت على دستور مكتوب، وهو «الصحيفة»، التي لها ذاتية مستقلة تميِّزها عن غيرها من الدساتير والوثائق الدولية والمجتمعية.والأكثر أهمية في ذلك أن البنية الاجتماعية العربية آنذاك كانت تعتبر هذا التنوع شيئاً غريباً وغير مألوف اجتماعياً في حياة العرب وتقاليدهم؛ لأن الأساس السائد في التجمعات البشرية كانت رابطة الدم والقرابة، بينما كان مجتمع المدينة المنورة إبّان تأسيس الدولة مكوّناً من أديان وقوميات، فكانت رابطة المواطنة.وكذلك فإن الافتراض بأن دولة يترأسها نبيٌّ مرسَل له دينٌ يعدّ خاتم الأديان، وناسخاً لكلّ الشرائع السماوية، كان يفترض أن تكون الرابطة الاجتماعية فقط هي الرابطة الدينية،إلاّ أنّ كلّ هذا لم يحصل، إنما الذي حصل هو مشروعية التنوُّع والتعدُّد، ونمط المشاركة الدستورية، وكانت الرابطة هي رابطة المواطنة،وعليه فإن المنهج الذي نتعامل على وفْقَهِ في هذا البحث لا يغفل عن الملحظ الزمني التاريخي الموجود في ذات النصّ، فأيّ رواية أو نصّ صادر من المعصوم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يمكن أن ينفصل عن عصره، لكنه لما كان جزءاً من دين، أو جزءاً من خطاب ربّاني للإنسان، فلا بُدَّ أن تكون له ديمومة داخل جيولوجيا النصّ، يمكن تحويلها مجرَّدة عن ارتباطها بأزمان الصدور إلى موجهات فلسفية وفكرية وقانونية لعصور تالية، وإنْ اختلفت في التركيب والتشكُّل.
لتحميل كتبي فضلاً الضغط على الصورة التالية - متجدد بإذن الله
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة صاحب القرآن في المنتدى فى ظل أية وحديث
مشاركات: 76
آخر مشاركة: 21-06-2015, 12:43 AM
-
بواسطة ابوغسان في المنتدى اللغة العربية وأبحاثها
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 26-11-2014, 06:23 PM
-
بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 13-03-2010, 02:00 AM
-
بواسطة ياسر سواس في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 16-02-2010, 10:39 PM
-
بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 08-09-2007, 12:22 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى









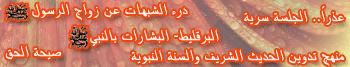

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


المفضلات