




-

الرد على السؤال رقم 9: جاء في سورة يونس 94 ..." فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ... لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ " ... وجاء في سورة الأعراف 2 ..." كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ " ...
وقال الناقد ان الإمام الرازي قال في تفسير سورة يونس 94 ... أن من الوجوه في تفسير نص " فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ... " هو أن الخطاب لمحمد ... وأن محمداً من البشر ... وأن حصول الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات ... وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل وتقرير البيّنات ... فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن خاطره تلك الوساوس ... وقال البيضاوي في تفسير آية سورة الأعراف 2: " حَرَجٌ مِنْهُ ": أي شك فيه ... فإن الشك حرج الصدر وضيق القلب مخافة أن يكذب فيه ...
وقال الناقد أنه واضح من هذا أن محمداً كان يشك في مصدر وحيه وإن كان كلامه من عند الله أي ليس بوحي ... حتى نصحه مصدر وحيه أن يسأل في ذلك اليهود والنصارى الذين يقرأون الكتاب من قبله ... فإن كان الرسول يشك في رسالته والمبلّغ يرتاب في صدق بلاغه ... فكيف يتوقع من سامعيه أن يصدقوه ؟؟؟
واضاف الناقد انه في الوقت الذي كانت فيه الشكوك تساور محمداً في وحيه ... اعترف أن المرجع والمحك لأقواله هو الكتاب المقدس ... فجاء قوله: " فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ " ... وأكد القرآن أن التوراة التي بين يدي يهود عصره صحيحة سليمة فيها حكم الله ... والأَوْلى أن يرجعوا إليها لا أن يرجعوا إلى محمد فقال في سورة المائدة 43" وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ " ... وأوصى القرآن المسيحيين أن يلازموا أحكام إنجيلهم ... وحكم بالفسق على من لا يقيم أحكام الإنجيل فقال في سورة المائدة 47 " وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " ...
حاول الناقد أن يوظف انتقاله بين التفسيرات المختلفة فيما يمكنه من تحقيق غرضه وهو الطعن في عقيدة غيره ... كما حاول أيضاً أن يوهم القارئ السطحي بعَدَمِ نبوةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى سيطرةِ الوساوسِ عليه بشأنِ الوحي ... فرأيناه مرة يذهب الى تفسير الرازي للآية 94 من سورة يونس ... ثم رأيناه مرة أخرى يذهب لتفسير البيضاوي للآية 2 من سورة الاعراف ظناً منه أنه سيعثر على ركيزة يستند عليها لتحقيق ما يوافقُ هواه لترسيخ غرضه المزعوم.
فأما ركيزته في تفسير البيضاوي للآية 2 بسورة الأعراف فهي ركيزة واهية ... ولماذا ؟؟؟ لأن الناقد ادعى أن البيضاوي قال: " حَرَجٌ مِنْهُ ": أي شك فيه ... فإن الشك حرج الصدر وضيق القلب مخافة أن يكذب فيه ... وبالتالي فإن محمداً كان يشك في مصدر وحيه !!! ولكن حقيقة الأمر أن الناقد حرّف ما قاله البيضاوي الذي قال:" فَلاَ يَكُن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ "أي شك ... فإن الشك حرج الصدر أو ضيق قلب من تبليغه مخافة أن تكذب فيه ... أو تقصر في القيام بحقه ... وتوجيه النهي فيه للمبالغة ... انتهى تفسير البيضاوي ... والقارئ الذكي لابد وأن لاحظ ما قام الناقد بإضافته وحذفه من كلمات في تفسير البيضاوي حتى يحقق غرضه ... ويخرج بالتفسير الحقيقي للبيضاوي عن المعنى المقصود !!!
أما تفسير البيضاوي على حقيقته وكما هو واضح ... فلا يدل على أَنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم كان عندَه شَكّ في الوحْي، كما زعم الناقد ... إِنما تَنهى الآيةُ الرسولَ صلى الله عليه وسلم عن التحرج من تَبليغِ الوحْيِ وإِنذارِ الناسِ به: " فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ " ... أَيْ: لا تتحرجْ من إِنذارِ الناسِ به ... وفَرْقٌ بين القول: كانَ عنْدَه شَكّ في الوحيِ والنبوة ... وبينَ القول: يَدْعوهُ اللهُ إِلى عدمِ التحرجِ من إِنذارِ الناسِ به ... وإِذا تحرجَ من الإِنذارِ والتبليغِ، يكونُ التحرجُ خشيةَ أَنْ يُكَذّبَه الكافرون، أَو خشيةَ تقصيرِه من القيامِ بِالحَقِّ وأَداءِ الواجب ... ولا تَدُلُّ الآية ُعلى أَنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم تحرجَ من الإِنذار، إِنما تدلُّ على أَنه إِذا أَصابَه التحرجُ من الإِنذارِ به فعليه أَنْ يُزيلَه ... ويؤكد نفس المعنى الذي ذكرناه لهذه الآية أيضاً تفسير المنتخب: " أي أنزل إليك القرآن لتنذر به المكذبين ليؤمنوا ... وتذكِّر به المؤمنين ليزدادوا إيماناً ... فلا يكن في صدرك ضيق عند تبليغه خوفاً من التكذيب. "تفسير المنتخب
ولذلك فإن الرسولَ صلى الله عليه وسلم لم يتحرجْ َأبداً من الإِنذارِ بالقرآن الكريم ... ولم يشك لحظة في رسالته ... ولم يرتاب في صدق بلاغه كما زعم الناقد ... وقد صدقه سامعوه فأصبح أحفادهم حاليا منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها ويشكلون ما يقرب من ربع سكان كوكب الأرض ... وبهذا نسفت ركيزة الناقد التي استند عليها لتحقيق غرضه ...
نأتي للآية الأخرى وهي:" فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ " يونس 94 ... وسنقف أولاً على تفسيرها من نفس تفسير البيضاوي الذي استدل به الناقد في تفسير الآية 2 من سورة الأعراف ... يقول تفسير البيضاوي: " المراد زيادة تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم ... لا إمكان وقوع الشك له ... ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: {لا أشك ولا أسأل ... أي: أَنا لستُ في شَكٍّ مما أَوحى اللهُ إِليَّ، ولستُ بحاجةٍ إِلى سؤالِ أَهْلِ الكتاب} ... وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته أو لكل من يسمع ... أي إن كنت أيها السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك ... وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم ... {لَقَدْ جَاءكَ الحق مِن رَّبّكَ} واضحاً أنه لا مدخل للمرية فيه بالآيات القاطعة ... انتهى التفسير
إذن تفسير البيضاوي المذكور لهذه الآية ينفى تماماً ما زعمه الناقد من عَدَمِ نبوةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ... أو على سيطرةِ الوساوسِ عليه بشأنِ الوحي ... أو على أنه شك لحظة في رسالته ... ولذلك لم يستدل الناقد بتفسير البيضاوي هذا لتلك الآية ... بالرغم من استدلاله بتفسير البيضاوي للآية 2 من سورة الأعراف ولكن بعد تحريف التفسير كما وضحنا بعاليه ... ولذلك ... ذهب الناقد الى تفسير آخر وهو تفسير الرازي ظناً منه أنه سيجد فيه غايته المنشودة في طعن عقيدة غيره !!! فماذا في تفسير الرازي لهذه الآية ؟؟؟
قال الناقد ان الإمام الرازي قال في تفسيره لسورة يونس 94 ... " أن من الوجوه في تفسير نص " فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ... " هو أن الخطاب لمحمد .... وأن محمداً من البشر ... وأن حصول الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات ... وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل وتقرير البيّنات ... حتى أن بسببها تزول عن خاطره تلك الوساوس " ... ولما رَجَعْنا إِلى تفسيرِ الرازي وَجَدْنا أن الأَمْرَ على غيرِ ما ذَكَرَه الناقد !!! فماذا قال الرازي ؟؟؟
ذَكَرَ الرازي قولَيْن في تحديد من المخاطبِ في هذه الآية:
القول الأول:الخطابُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في الظاهرِ ... لكن المرادُ غيرُه ... ومن الأمثلة المشهورة: إياك أعني ... واسمعي يا جاره.
القول الثاني: الخطابُ للإِنسانِ الشّاكِّ في نبوةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ... والتقديرُ: إِنْ كنتَ أَيها الإنسانُ في شَكٍّ مما أَنزلْنا إِليك من الهدى على لسانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ... فاسأَلْ أَهْلَ الكتابِ لِيَدُلُّوكَ على صحةِ نبوَّتِه ...
ونفى الرازي أَنْ يكونَ الخطابُ في الحقيقةِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ... ورَجَّحَ أَنْ يكونَ الخطابُ في الظاهرِ له ... لكنَّ المرادَ غيره ... أي أخذ بالقول الأول السابق ... وضرب لذلك مثالاً بقوله تعالى: " وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ... إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ... تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ... إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ " المائدة 116 ... فالخطاب هنا لعيسى ... ولكن المقصود به من أتخذوه وأمه إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... ليعلموا زيف الادعاء بان عيسى وأمه ... " إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ " ...
وعلى سبيل المثال أيضاً ما جاء في سورة الطلاق الآيات 1 & 2 فهو خطاب موجه للرسول أيضاً ... و لكن المراد و المقصود به أمته ... " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "
فالآية لم تقل " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتَ النِّسَاءَ " ... بل قالت ... " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ " فالخطاب هنا بصيغة الجمع لأن المقصود به الأمة ... أي يا امة محمد إذا طلقتم النساء فاتبعوا ما أمر الله تعالى به في الطلاق ... فالخطاب موجه إلي النبي لكن المقصود به أمته ...
والأفعال أيضا في هذه الآيات تؤكد ما ذكرناه ... لأنها تعود على الأمة وليس على شخص النبي مثل: طَلَّقْتُمُ ... فَطَلِّقُوهُنَّ ... وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ... وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ... لَا تُخْرِجُوهُنَّ ... فَأَمْسِكُوهُنَّ ... أَوْ فَارِقُوهُنَّ ... وَأَشْهِدُوا ... وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ ...
ولو كان الخطاب المقصود به النبي لكانت الأفعال بصيغة المفرد ولكنها أتت جميعها بصيغة الجمع ... إذن فبالرغم من أن الخطاب للنبي ... إلا أن المراد أمته ...
وحتى يؤكد الرازي قراره في أن الخطابُ في الظاهرِ للنبي صلى الله عليه وسلم ... لكنَّ المرادَ به غيره ...قالَ الرازي:
والذي يَدُلُّ على صحةِ ما ذَكَرْناهُ من وجوه:
الاوَّل:قولُه تعالى في آخرِ نفس السورة: " قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " يونس 104 ... فَبَيَّنَ أَنَّ المذكورَ في الآيةِ السابقة على سبيل الرمز (أي المخاطب في الآية 94) هم المذكورونَ في هذه الآيةِ (أي فى يونس 104) على سبيلِ التصريح (أي الناس المتشككون) ...
الثاني: أَنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم لو كانَ شاكاً في نبوةِ نفسِه ... لكانَ شَكُّ غَيرِه في نبوتِه أَوْلى ... وهذا يوجبُ سُقوطَ الشريعةِ بالكلية.
الثالث:بتقديرِ أَنْ يكونَ شاكاً في نبوةِ نفسِه ... فكيفَ يزولُ ذلك الشَّكُّ بإِخبارِ أَهْلِ الكتابِ عن نبوَّتِه ... مع أَنهم في الأَكثرِ كُفّار !!! وقد ثَبَتَ أَنَّ ما في أَيديهم من التوراةِ والإِنجيلِ مُصحَّفٌ مُحَرَّف ...
ولذلك ثبتَ أَنَّ الحَقَّ هو أَنَّ هذا الخطابَ وإِنْ كانَ في الظاهرِ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ... إلا أَنَّ المرادَ به أُمَّتُه ". ومثل هذا الأمر معتاد ... فإن السلطان الكبير إذا كان له أمير ... وكان تحت راية ذلك الأمير جمع ... فإذا أراد السلطان أن يأمر الرعية بأمر مخصوص ... فإنه لا يوجه خطابه عليهم ... بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي جعله أميراً عليهم ... ليكون ذلك أقوى تأثيراً في قلوبهم ... انتهى تفسير الرازي ... ولقد حذف الناقد هذا الكلامَ كُلَّه بالطبع ... لأَنه لا يُساعدُ فيما يريدُه من اتهامِ النبيِّ وتخطئةِ القرآن !!! هدى الله السيد الناقد وبصّره بالحق ...
إن ما يؤكد تماما ما ذكرناه ... ويؤكد أيضا أن النبي لم ينتابه أي شك كما ادعى السيد الناقد ... الآية 104 التي وردت بعد الآية 94 التي استشهد بها سيادته في سورة يونس وهي ... " قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " ... فإذا كان النبي قد شك كما ادعى الناقد لكانت الآية " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فقد تشككت أنا أيضا " ... إنما قالت ... " إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ " ...
لقد نزل القرآن الكريم باللغة العربية وأيضاً على ما تعارف عليه العرب في أساليب لغتهم و من ذلك ... " أن يكون الخطاب موجه إلى فلان لكن المقصود غيره " ... فالله تعالى يخاطب امة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال خطابه لرسوله ... لأن الرسول هو معلم الأمة و مرشدها إلى الهدى و الرشاد ... إذن فمعنى الآية هو ... أنك لست في شك يا محمد ... ولكن غيرك في شك ... وهذا ما اجمع عليه المفسرون في أمهات كتب التفسير: الجامع الكبير لأحكام القرآن للقرطبي ... وتفسير القران العظيم لابن كثير ... والتفسير الكبير للرازي ... وروح المعاني للألوسي وغيرهم ... وأيضا جمهور العلماء ...
نأتي الى أحد وجوه تفسير الرازي والتي نقلها الناقد عنه ... وهي ليست كما نَقَلَها الناقد !!! لأَنه أَخَذَ من التفسير الجزءَ الذي يتفقُ مع هواه ... وأَسقطَ وبتر الجزءَ المهمَّ منه، وهو قولُ الرازي:
وأقول تمام التقرير في هذا الباب إن قوله: {فَإِن كُنتَ فِي شَكّ} فافعل كذا وكذا ... قضية شرطية ... والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أو لم يقع ... ولا بأن الجزاء وقع أو لم يقع ... بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمه لماهية ذلك الجزاء فقط ... والدليل عليه ... أنك إذا قلت إن كانت الخمسة زوجاً كانت منقسمة بمتساويين ... فهو كلام حق ... لأن معناه أن كون الخمسة زوجاً يستلزم كونها منقسمة بمتساويين ... ثم لا يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج ... ولا على أنها منقسمة بمتساويين ... فكذا ههنا هذه الآية ... تدل على أنه لو حصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا ... فأما إن هذا الشك وقع أو لم يقع ... فليس في الآية دلالة عليه ... والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول هي تكثير الدلائل وتقويتها ... مما يزيد في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر ... ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوة . انتهى تفسير الرازي
هذا ومن الجدير بالذكر أن الوجه السابع في تفسير الرازي لهذه الآية ... والذي لم يذكره الناقد بالطبع ... هو أن لفظ {إن} في قوله تعالى: {إِن كُنتَ في شَكّ} للنفي ... أي ما كنت في شك قبل ... يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك ... لكن لتزداد يقيناً كما ازداد إبراهيم عليه السلام بمعاينة إحياء الموتى يقيناً ...
وقد قال الرازي أيضاً في تفسيره لهذه الآية: " أن المسؤول منه في قوله: ... " فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ " يونس 94 حسب قول المحققين ... هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ... وعبد الله بن صوريا ... وتميم الداري ... وكعب الأحبار ... لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم. " انتهى التفسير ... أي ليس أهل الكتاب بصفة عامة ...
لقد ذَكَرْنا ما قالَه الرازي في تفسيرِ الآيةِ لنُطلعَ القارئ الكريم على مزاجيةِ الناقد وافترائِه، وتحريفِه، وافتقادِه الأَمانةَ العلميةَ في النقلِ والإِحالة ... مع أَنه يلبسُ ثوبَ الموضوعيةِ والمنهجيةِ والحيادِ والبحثِ عن الحقيقة ... واستخرجَ من كلامِ الرازيِّ والبيضاوي أُكذوبةً مفتراه ... لم يذكُرْ أَيٌّ منهما حَرْفاً واحداً منها ؟؟؟ بل وسَبَقَ أَنْ نفاها كُلٌّ من الرازي والبيضاوي ...
وحتى نطمئن الناقد ونريح قلبه فيهدأ باله ... ففضلاً عما ذكرناه فإن القارئ الذكي سيلاحظ بالطبع أن الآية تقول " فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ ... " وليس " فإذا كنت في شك ... " ... والفارق شاسع بين (إِن) الشرطية ... وبين (إذا) الشرطية ... ذلك لأن (إِن) لا تفيد تحقيق الوقوع ... وانما تفيد افتراض الوقوع ... يعنى: على افتراض أنك شككت – ولن تشك – ومثال ذلك قوله تعالى: " قُلْ إِن كَانَ لِلرّحْمَـَنِ وَلَدٌ ... فَأَنَاْ أَوّلُ الْعَابِدِينَ " الزخرف 81 ... أي أنه من باب الافتراض " إن صح بالبرهان أنَّ للرحمن ولداً فأنا أول العابدين لهذا الولد ... لكنه لم يصح بالحُجة أن ولداً للرحمن ... لما يترتب عليه من مشابهة الخالق للمخلوقين ... وهو سبحانه منزه عن مشابهة الحوادث من خلقه " تفسير المنتخب ... أما (إذا) فإنها تفيد تحقيق الوقوع ... ولذلك صدرت الآية هنا " بإِن " التي هي للافتراض وليست " إذا " التي هي لتحقيق الوقوع والفارق بينهما واضح وشاسع ...
والله سبحانه أعلم وأعظم
يتبع بإذن الله وفضله
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة سيف الإسلام في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 21
آخر مشاركة: 06-10-2020, 04:33 PM
-
بواسطة سيف الإسلام في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 25
آخر مشاركة: 14-01-2018, 06:04 PM
-
بواسطة سيف الإسلام في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 7
آخر مشاركة: 09-10-2017, 06:28 PM
-
بواسطة سيف الإسلام في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 16
آخر مشاركة: 08-10-2017, 03:02 PM
-
بواسطة سيف الإسلام في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 15
آخر مشاركة: 03-02-2017, 09:38 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى








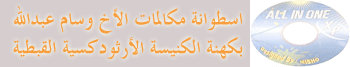

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


المفضلات