آخـــر الـــمـــشـــاركــــات




-
 دور آسيا الوسطى في اعتناق الاسلام في حوض الفولغا
دور آسيا الوسطى في اعتناق الاسلام في حوض الفولغا
بسم الله الرحمان الرحيم
نشرت مجلة "الاسلام المعاصر" في عددها مايو/ ايار ـ يونيو/حزيران 2011 مقالة لجلنارا ايدياتولينا حول دور آسيا الوسطى في اعتناق الاسلام في حوض الفولغا، او بعبارة اخرى، من اين انتشر الاسلام في روسيا؟
تتناول هذا الموضوع جلنارا ايدياتولينا، دكتوراه في التاريخ، كبيرة الباحثين في قسم الفكر الاجتماعي والاسلام بمعهد المرجاني للتاريخ التابع لاكاديمية علوم جمهورية تتارستان الروسية، في مقالتها بعنوان "دور آسيا الوسطى في اعتناق الاسلام في حوض الفولغا".
بالرغم من ان التاريخ الرسمي المعتمد لاعتناق البولغار الاسلام يعتبر عام 922، وهو تاريخ وصول البعثة الدينية السياسية الشهيرة من بغداد التي كانت تضم احمد بن فضلان، ان انتشار الاسلام بين البولغار بدأ في فترة مبكرة اكثر، اذ وجد ابن فضلان هناك ما يقارب 5 آلاف مسلم. ويورد المرجاني بالاعتماد على مؤرخين شرقيين، معلومات حول انتشار الاسلام بين البلغار منذ عهد الخليفين هارون الرشيد وابنه المأمون (النصف الاول من القرن التاسع). وعلى ما يبدو ان اول تعرف مبكر للبولغار على الدين الجديد جرى في ظروف نشر الاسلام في امارة الخزر نتيجة الفتوحات العربية، وتغلغل اشخاص من خوارزم. وتدل على هذا الاكتشافات الاثارية الحديثة. ومع ذلك، لعبت اهم دور في انتشار الاسلام في بولغاريا القديمة العلاقات مع آسيا الوسطى، حيث كان الدعاة الاوائل يرافقون القوافل التجارية .
وكان طريق قوافل نشط يربط البولغار مع خوارزم من قديم الزمان. ويرجع علماء الاثار تداول القطع النقدية الشرقية في منطق الفولغا ـ كاميير من القرن الثامن، وفي حوض كاميير المتوسط ـ منذ عهد الساسانيين. واغلب الظن، ان الدعاة الاوائل كانوا من خوارزم ايضا. ويؤيد هذا الافتراض سواء قربها الجغرافي نسبيا، او اهميتها السياسية والتجارية الكبيرة في الشرق الاسلامي، والتي اكتسبتها مدينة خوارزم منذ القرن الثامن. وبفضل الجوار القديم والعلاقات الوثيقة مع القبائل الرحل، اصبحت خوارزم مركز انتشار الاسلام في اطراف اسيا الوسطى الاتراكية التي تمتد حتى حدود حوض الفولغا.
وانتشر الاسلام في آسيا الوسطى نفسها منذ الفتوحات العربية الاولى. وجرى ضم مناطق توخاريستان وبخارى وسمرقند وفرغانة الى الدولة الاسلامية في الفترة 705 ـ 713. وكان موقف السكان المحليين المعادي للعرب الوافدين ودينهم في البداية ناجما بصورة رئيسية عن سياسة الأمويين المبنية على رعاية وتقريب العرب فقط، والنفور السافر من الغرباء، بغض النظر عن اعتناقهم الاسلام. وتغير الوضع بصورة ملموسة لدى استلام العباسيين (عام 750)، السلطة على موجة الشعوبية (ثورة المسلمين غير العرب من اجل المساواة في الحقوق). وذلك عندما حصل المسلمون الجدد ( الفرس والاتراك وغيرهم ممن اعتنق الاسلام) لا على حقوق متساوية مع العرب فحسب،، بل وعلى منفذ لتبوأ مناصب عالية في هرم السلطة. ومنذ ذلك الحين اخذ عدد المسلمين يتزايد باطراد، وعند القرن العاشر رسخ الاسلام مواقعه في المنطقة. وحتم نجاح نشر الاسلام في الغالب ايضا، وجود تجار ودراويش بين العرب، الفاتحين الاوائل. فقد اكسبت نشاطاتهم الاسلام انصارا بالطرق السلمية، ولعب هذا العامل دورا حاسما في استمرار انتشار الاسلام حتى حدود بولغاريا والاورال. وكانت نتائج هذا الحدث هامة جدا.
وان اعتناق الدين الجديد حتم طبعا ضم وسط حوض الفولغا الى مدار الحضارة الاسلامية، وعلى المستوى السياسي ـ الى صنف البلدان الاسلامية. وابتداء من ذلك الحين، كان كل تطور المنطقة التاريخي الثقافي مرتبطا بدينامية تطور العالم الاسلامي.
وعند بداية القرن العاشر استوعب البولغار باكمل وجه، تأثير الحضارة الاسلامية عليهم. ومن الممكن العثور على تأكيد هذا في مذكرات ابن فضلان. وأمن طريق التجارة تدفق سيل المسلمين سواء من آسيا الوسطى او من مناطق نائية اكثر على بولغاريا.
واشار الرحالة العربي ابن فضلان وقتئذ الى رفض البولغار اتباع المذهب الشافعي، الذي كان سائدا في بغداد، وفضلوا المذهب الحنفي، الذي اتبعه السامانيون.
هذا ومن المستبعد ان يكون موقف البولغار في قضايا القانون في ظروف الحياة اليومية والعادات العشائرية عفويا، وانما املاه حساب سياسي وحيد ـ البحث عن الرعاية والحلفاء. وتمثل هذا على الارجح، بالخيار الواعي للمذهب الذي يتصف باكبر تسامح مقارنة بالمذاهب الاخرى. وان اتباع المدرسة الحنفية كانوا يسترشدون في قضايا القانون والقضاء بضرورة تركيز الاهتمام بصورة رئيسية على الاجتهاد وليس على النص، وهذا ضروري لمراعاة الظروف المحلية.
وان اطلاع ملك البولغار على قواعد الفقه، وكذلك الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، الذي اشار اليه ابن فضلان، يتيح استنتاج لا مجرد اطلاع البولغار على القوانين الاسلامية فحسب، وبل ومحاولة صياغتها مراعاة للظروف المحلية. وهذا يتطلب امتلاك مستوى معارف عال للغاية. ومن المعروف ان اول المدارس الدينية الاسلامية انشئت في خراسان وما وراء النهر في القرن العاشر. وكان الفقه مادة التعليم الاساسية فيها، واصبح حتى ذلك الوقت مادة دراسية مستقلة.
وعلى ما يبدو، ان الدعاة البولغار الاوائل كانوا اما مما وراء النهر وخراسان مباشرة، او من بين الذين درسوا في احد مراكز آسيا الوسطى التعليمية. وبالتالي اعتبروا نظام التعليم هذا بمثابة نموذج ونقلوه الى وطنهم. وان عدم ترابط المعلومات يعيق تتبع انتشار هذه التيارات الفكرية والمدارس والمذاهب في ارض حوض الفولغا. ولا يمكن الا افتراض ان تأثير تقاليد آسيا الوسطى كان مهيمنا، ويلاحظ في كافة فروع المعارف. وساعد على هذا المناخ الفكري الذي كان سائدا فيما وراء النهر، ولم يكن بوسع البولغار تجاوزه.
وقد اشار ظهير الدين بابر (القرن السادس عشر)، في مذكراته بصدد مزايا وطنه، الى انه "لم يظهر في اي بلد علماء مسلمين بعدد العلماء مما وراء النهر". وفي الحقيقة، ان ما وراء النهر موطن علماء المسلمين البارزين المعترف بهم عالميا، مثل محمد بن اسماعيل البخاري (810 ـ 870)، مؤلف كتاب الاحاديث النبوية "صحيح البخاري"، وابو منصور محمد الماتوريدي (870 ـ 944)، مؤسس احد مدرستي علم الكلام الكبريين، وقام بتدريس الفقه وعلم الكلام في موطنه سمرقند، وكذلك برهان الدين المارغيناني (توفي عام 1197)، مؤلف كتاب الفتاوى "الهداية" الواسع الانتشار. وكتب بابر ان الكتب المتوفرة قليلة بشأن تشريعات الامام ابي حنيفة التي تحظى باهمية اكبر من "الهداية". وظل كتاب "الهداية" يستخدم في المدارس الدينية الاسلامية بمثابة كتاب تعليمي في الفقه حتى القرن العشرين.
وشكلت فترة تواجد البعثة العربية في بولغاريا، بداية القرن العاشر، عصر ازدهار دولة السامانيين. وكذلك مرحلة، عندما كانت تجنى ثمار الحركة الشعوبية القديمة في القرن الثامن، التي اصبح التطور الجامح للعلوم والثقافة، وعلى العموم الثقافة الفارسية، احد انجازاتها. وكانت مكتبة السامانيين في بخارى احدى اغنى خزائن الكتب في ذلك العهد. وترتبط ببخارى وبهذه المكتبة سني ابن سينا (980 ـ1037" المبكرة. وفي بداية القرن العاشر اعدت مخطوطة "نارشاهي" الشهيرة ـ تاريخ بخارى. و"نارشاهي" لربما، كانت بمثابة الحافز لاصدار يعقوب بن نعمان "تاريخ بخارى". ولدى ذكره هذا الكتاب، اشار ابو حامد الغرناطي الاندلسي الذي زار بولغاريا في الفترة 1135 ـ 1136، الى ان مؤلفه قاض سابق، احد تلاميذ الفقيه المعروف ابو المعالي الجويني من نيسابور. ويدور الحديث حول ممثل الاشعرية في الكلام والفقه الشافعي، الملقب بامام الحرمين، مدرس الغزالي، ودرس في المدرسة "النظامية" التي انشأها له الوزير نظام الملك. واستولى السلاجقة على نيسابور التي كانت منذ النصف الثاني من القرن العاشر المركز الاداري والديني لولاية خراسان، في عام 1038، وكانت احدى مدن السلطنة الرئيسية.
وتؤكد العلاقات الوثيقة مع هذا الاقليم البلاغات التي تعود الى الفترة 1024 ـ 1025، حول بعثة ملك البلغار ابراهيم الى حاكم خراسان، ومساعدة البلغار في بناء جامعين في مدينتي سبزوار وخسروجرد في ولاية بيسابور. وعلى ما يبدو ان المؤرخ البولغاري يعقوب النعمان سمع الكثير عن مزايا المدينة والمدرسة. ولكن الغرناطي لم يذكر فترة حياته، وعلى الارجح النصف الثاني من القرن الحادي عشر ـ بداية القرن الثاني عشر. وانطلاقا من انه كان يعيش في نيسابور في تلك الفترة المفكرون العباقرة، مثل ابو حامد الغزالي (1058 ـ 1111)، وعمر الخيام (حوالي 1048 ـ بعد 1122)، من الممكن تصور سعة وتنوع الافكارالتي انتقلت من هناك الى بولغاريا.
وتعود المعلومات المبكرة جدا عن العلماء البولغار الى القرن الحادي عشر. ومنهم الحاج احمد البولغاري استاذ السلطان محمود الغزنوي (998 ـ 1030). وعلى ما يبدو ان هذا السلطان من البولغار، حصل على التعليم في احد مراكزها التعليمية منذ عهد السامانيين، ومن ثم انتقل الى غزنى. ويدل على درجة السلطان العلمية تجمع افضل علماء العصر في حاشيته، بمن فيهم البيروني العظيم (973 ـ1489)، والمرجاني الذي كان يلقب بعارف الشريعة، ومعاصره شمس الاسلام السرخسي (توفي عام 1090)، وفخر الاسلام البزدوي (توفي عام 1098)، وشيخ الاسلام ظواهر زاده (توفي عام 1090)، ويؤكد انه كان بمنزلتهم.
وكافة هؤلاء الاشخاص كانوا كبار فقهاء ما وراء النهر، ومعدو مؤلفات هامة في المذهب الحنفي، ظلت تحظى بشهرة واسعة على مدى فترة طويلة، ومنها كتاب السرخسي "المبسوط في فروع الفقه"، وكان يستعمل سواء في موطنه او في حوض الفولغا. وكذلك الشروحات لمؤلف "اصول الفقه" للامام فخر الاسلام البزدني، جرى اعدادها واعادة كتابتها على مدى قرون عديدية. ويذكر المرجاني اسم عالم بولغاري آخر ـ ابو العلاء حامد بن ادريس البولغاري ( النصف الاول من القرن الثاني عشر)، الذي ذكر في كتابه عالما بولغاريا آخر ـ سليمان بن داود السكسايني، كناقل احاديث. ومن المميز ن كافة النصوص المنقولة عنه قدمها فقهاء ومحدثون من آسيا الوسطى، لايقلون شهرة، مثل ابو المنعم ميمون بن محمد النصافي (توفي عام 1144) وابو بكر بن عبد الله السرخسي (توفي عام 1124) وابو بكر محمد بن حسن السرخسي (توفي عام 1111). وعلى العموم ان فترة تواجد الغرناطي (النصف الاول من القرن الثاني عشر)، الذي شهد وقتئذ انه كانت لدى البولغار حتى في سكسينا احياء منفصلة فيها جوامع، كانت فترة ترسخ الاسلام بصورة نهائية في حوض الفولغا، والتحاق المنطقة بنمط حياة العالم الاسلامي.
وبالاضافة الى الاسلام الحنيف، ونظام التعليم الاسلامي التقليدي، تغلغل في حوض الفولغا من آسيا الوسطى المذهب الصوفي. وعلاوة على ذلك، اذا كنا نقصد اعتناق السكان الاسلام بصورة جماعية، فمن الممكن التحدث عن انتشار الاسلام بصيغته الصوفية التي يعتنقها في الغالب الاتراك.
وكان حوض الفولغا يرتبط بصورة وثيقة بالصوفية من البداية، وحتى كل تنوع المواضيع والافكار، التي انتقلت من الشرق، جرت دراستها في سياق العقيدة الصوفية. وابتداء من ذلك الحين وحتى اواسط القرن التاسع عشر، كان الشعر التتاري يتطور في المجرى الصوفي، وهذا على العموم، ما يتميز به كل العالم الاسلامي، اذ تتخلل كل الشعر الفارسي، والعربي اقل درجة نسبيا، التشابيه والدوافع والرمزية الصوفية.
وان الشيخ حسن البولغاري (توفي عام 1299)، احد الاسماء الخالدة المعدودة من صوفيي العهد البولغاري. والمريد السابق سعد الدين الحموي عاش فترة طويلة في بولغاريا، ووصدر الحكم عليه بالحد بوشاية من اعدائه، واضطر على الفرار. وكان المرجاني يعتقد ان ضريح "الحاج البولغاري"، مزار سكان بخارى الشهير، انشئ على انقاض قبر الشيخ الانف الذكر، وان عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة، الفقيه القانوني، مؤلف كتاب الفقه "المختصر" نصحه واعاده الى الطريق القويم.
وان التوجهات التي نشأت في آسيا الوسطى، وبالمرتبة الاول فيما وراء النهر في الفترة (القرن العاشر ـ القرن الثالث عشر) في مجالات التعليم والعلوم والادب والفنون، بالاضافة الى نشاطات الطريقة الياسوية، حددت في الغالب خصوصية التطور الثقافي التالي في حوض الفولغا. وانعكس تعزز مواقع الاخوة الصوفية والتيار الصوفي بشكل ملحوظ، وعلى العموم الذي تميز به العالم الاسلامي كله، على طابع العلاقات مستقبلا بين الاقاليم، وكانت الطريقة، وبالتحديد، الطريقة النقشبندية التي نشأت في القرن السادس عشر وكسبت شهرة واسعة على مدى القرون التالية، احدى حلقات الوصل الرئيسية.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة ابوغسان في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 21-02-2013, 06:02 PM
-
بواسطة Rabi3 في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 25-11-2011, 01:11 AM
-
بواسطة نعيم الزايدي في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 28-06-2010, 01:40 AM
-
بواسطة نعيم الزايدي في المنتدى المنتدى العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 20-06-2010, 12:38 AM
-
بواسطة د.محمد عامر في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 07-03-2010, 07:17 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى







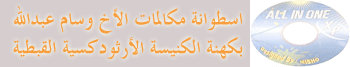

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


المفضلات