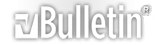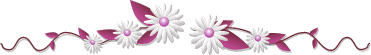اقتباس:
جاء في ( سورة المائدة 5: 69) : " إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ " . وكان يجب أن ينصب المعطوف على اسم إن فيقول : والصابئين في كما فعل هذا ورد فى البقرة 2: 62 والحج 22: 17
يا عزيزي لو كان في الجملة اسم موصول واحد لحق لك أن تنكر ذلك ، لكن لا يلزم للإسم الموصول الثاني أن يكون تابعا لإنَّ . فالواو هنا استئنافية من باب إضافة الجُملة للجملة ، وليست عطفا على الجملة الأولى .
لذلك رُفِعَ (وَالصَّابِئُونَ) للإستئناف (اسم مبتدأ) وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك أى فى حكمهم . والفائدة من عدم عطفهم على مَن قبلهم هو أن الصابئين أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً ، فكأنه قيل: "كل هؤلاء الفرق إن آمنوا وعملوا الصالحات قَبِلَ اللهُ تَوْبتهم وأزال ذنبهم ، حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك" .
و هذا التعبير ليس غريبا في اللغة العربية ، بل هو مستعمل فيها كقول بشر بن أبي خازم الأسدي الذي قال :
إذا جزت نواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاق *** وإلا فاعلموا أنــا وأنـتم بغـاة ، ما بقـينا في شـقاق
والشاهد في البيت الثاني ، حيث (أن) حرف مشبه بالفعل ، (نا) اسمها في محل نصب ، و (أنتم) الواو عاطفة وأنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ، وبغاة خبر أن ( أو أنتم ) مرفوع ، والخبر الثاني محذوف ، وكان يمكن أن يقول فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة ، لكنه عطف مع التقديم وحذف الخبر ، تنبيها على أن المخاطبين أكثر اتصافا بالبغي من قومه هو ، فقدم ذكرهم قبل إتمام الخبر لئلا يدخل قومه في البغي ــ وهم الأقل فيه ــ قبل الآخرين .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة الأعراف 7: 56 ) : " إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ " . وكان يجب أن يتبع خبر إن اسمها في التأنيث فيقول : قريبة .
يا عزيزي إن كلمة قريب على وزن فعيل ، وصيغة فعيل يستوى فيها المذكر والمؤنث .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة الأعراف 7: 160): " وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً " . وكان يجب أن يذكر العدد ويأتي بمفرد المعدود فيقول : اثني عشر سبطاً .
إن (أَسْبَاطاً) ليس تمييز لأنه جمع . وإنما هو بدل من (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ) بدل كلٍ من كل. والتمييز محذوف . أي اثنتى عشرة فرقة. ولو كان (أَسْبَاطاً) تمييزا عن اثنتى عشرة لذكر العددان . ولقيل: اثنى عشر ، بتذكيرهما وتجريدهما من علامة التأنيث ، لأن السبط واحد الأسباط مذكر . ولا يجوز أن يكون (أَسْبَاطاً) تمييزاً ، لأنه لو كان تمييزاً لكان مفرداً .
وجاء في قول عنترة:
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأسحم
(إعراب القرآن الكريم 3/47) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة الحج 22: 19) : " هذا نِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ". وكان يجب أن يثنّي الضمير العائد على المثنّى فيقول : خصمان اختصما في ربهما
الجملة في الآية مستأنفة مسوقة لسرد قصة المتبارزين يوم بدر وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة .
التقدير هؤلاء القوم صاروا في خصومتهم على نوعين . وينضوي تحت كل نوع جماعة كبيرة من البشر . نوع موحدون يسجدون لله وقسم آخر حق عليه العذاب كما نصت عليه الآية التي قبلها. (إعراب القرآن الكريم 6/415) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة التوبة 9: 69 ) : " وَخُضْتُمْ كَالذِي خَاضُوا ". وكان يجب أن يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول : خضتم كالذين خاضوا
الكاف ومدخولها في محل نصب على المفعولية المطلقة . والضمير المحذوف تقديره: كالأمر الذي خاضوا فيه . (إعراب القرآن الكريم 4/129) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة المنافقون 63: 10 ) : " وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِين " َ وكان يجب أن ينصب الفعل المعطوف على المنصوب فأَصدق وأَكون
الفاء في (فَأَصَّدَّقَ) عاطفة. وأكن فعل مضارع مجزوم بالعطف على محل فأصدق وأكن. واسم أكن مستتر تقديره أنا. و(مِنَ الصَّالِحِين) خبرها. (إعراب القرآن الكريم 10/103) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة البقرة 2: 17 ) : " مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ " . وكان يجب أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفرداً فيقول: استوقد... ذهب الله بنوره .
المخالفة بين الضميرين من فنون البلاغة القرآنية . فقد وحد الضمير في (اسْتَوْقَدَ) وحوله نظرا إلى جانب اللفظ لأن المنافقين كلهم على قول واحد وفعل واحد. وأما رعاية جانب المعنى في (بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ) فلكون المقام تقبيح أحوالهم وبيان ذاتهم وضلالهم فإثبات الحكم لكل فرد منهم واقع . (إعراب القرآن الكريم 1/45) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة النساء 4: 162 ) : " لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً " . وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول : والمقيمون الصلاة .
الواو معترضة . والمقيمين نصب على المدح بإضمار فعل لبيان فضل الصلاة كما قال سيبويه . والنصب على المدح أو العناية لا يأتي في الكلام البليغ إلا لفائدة وهي هنا مزية الصلاة . وكما قال تعالى في آية أخرى ((وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ)).
وهذا سائغ في كلام العرب كما قال الشاعر:
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر ** النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر
واستشهد سيبويه في ذلك بقول الشاعر:
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها
الطاعنين ولما يطعنوا أحدا والقائلون: لمن دار تخليها
(إعراب القرآن الكريم 2/378) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة هود 11: 10 ) : " وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ" . وكان يجب أن يجرَّ المضاف إليه فيقول : بعد ضراءِ
(ضَرَّاءَ) هنا مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالكسرة ولكن منع من الصرف انتهاء الكلمة بألف التأنيث الممدودة. (إعراب القرآن الكريم4/320) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة البقرة 2: 80 ) : " لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً " . وكان يجب أن يجمعها جمع قلة حيث أنهم أراد القلة فيقول : أياماً معدودات
أنه يجوز فيه الوجهان معدودة ومعدودات ولكن الأكثر أن (معدودة) في الكثرة , و(معدودات) في القلة .
قال الزجاج: "كل عدد قل أَو كثر فهو معدود، ولكن معدودات أَدل على القِلَّة لأَن كل قليل يجمع بالأَلف والتاء نحو دُرَيْهِماتٍ وحَمَّاماتٍ. وقد يجوز أَن تقع الأَلف والتاء للتكثير" (لسان العرب1774) . وهنا لا دلالة فيه على القلة بخلاف قوله تعالى ((وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)) {فهي ثلاثة أيام المبيت في منى وهي قليلة العدد. كذلك الشأن في مناسك} .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في : " سورة الصافات 37: 123-132 " : " وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ... سَلاَمٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ... إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِين " . فلماذا قال إلياسين بالجمع عن إلياس المفرد؟ فمن الخطا لغوياً تغيير اسم العلَم حباً في السجع المتكلَّف. وجاء في (سورة التين 95: 1-3 ) : "وَالتِّينِ وَالزَيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا البَلَدِ الأَمِين"ِ . فلماذا قال سينين بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطأ الغوياً تغيير اسم العلَم حباً في السجع المتكلف.
إن هذا اسم علم أعجمي ومهما أتى بلفظ فإنه لا يعني مخالفة لغة العرب . مثل إبراهيم وأبرام. وهما إسمان لنبي واحد. فهو إلياس واسمه الكامل إلياسين . فالاسم ليس من الأسماء العربية حتى يقال هذا مخالف للغة العرب .
كذلك الأمر في قوله تعالى ((وَطُورِ سِينِينَ)) , والسينين باللغة الحبشية هو الشيء الحسن . فإنها من باب تسمية الشيء الواحد بتسميات متشابهة كتسمية مكة بكة .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة البقرة 2: 177 ) : " لَيْسَ َالبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ". والصواب أن يُقال : ولكن البر أن تؤمنوا بالله لأن البر هو الإيمان لا المؤمن.
يقول الإمام الرازى أنه حذف فى هذه الآية المضاف كما لو أراد قول "ولكن البر كل البر الذى يؤدى إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله". وشبيه ذلك الآية ((أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ .. كَمَنْ آَمَنَ)) , وتقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن؟ ، أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن؟ ليقع التمثيل بين مصدرين أو بين فاعلين ، إذ لا يقع التمثيل بين مصدر وفاعل .
وقد يُقصدً بها الشخص نفسه فتكون كلمة (البِرَّ) هنا معناها البار مثل الآية ((وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى)) أى للمتقين ، ومثله قول الله تعالى ((قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا)) أى غائراً.
وقد يكون معناها ولكنَّ ذا البر ، كقوله: ((هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ)) أى ذو درجات .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة البقرة 2: 177) : " وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ " . وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول : والموفون... والصابرون
جاء السياق بلفظ (الصَّابِرِينَ) وهو منصرب على المدح إشعاراً بفضل الصبر ومدحاً لأهله كما هو معروف عند العرب:
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر ** النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر
واستشهد سيبويه في ذلك بقول الشاعر:
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها ** الطاعنين ولما يطعنوا أحدا والقائلون: لمن دار تخليها(إعراب القرآن الكريم 1/250) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في : " سورة آل عمران 3: 59) : " إنّ مثَل عيسى عند الله كمثَل آدمَ خلقه من ترابٍ ثم قال له كن فيكون " . وكان يجب أن يعتبر المقام الذي يقتضي صيغة الماضي لا المضارع فيقول : قال له كن فكان .
وكيف يقتضي المقام صيغة الماضي لا المضارع . مع أن (ثم) حرف عطف للترتيب مع التراخي . وهل يعقل أن يكون السياق هكذا: أذا أمرتك بشيء فعلت؟ أم أن الأصح أن تقول: إذا أمرتك بشيء تفعله؟
وتقدير السياق في الآية فإذا أراد الله شيئا فيكون ما أراد . ولا يقال فكان ما أراد . فإن (أراد) فعل ماضي . وليس من المنطق أن يأتي المراد بصيغة الماضي لأنه تحقق بعدما أن أراده الله. فتكون صيغة المضارع مفيدة للتراخي بحيث يكون الشيء المراد بعد إرادة كونه . وتأمل لو أننا صغنا العبارة الأخيرة بقولنا: بحيث كان الشيء المراد بعد إرادة كونه !! ... أي العبارة أبلغ وأكمل لو كنتم تفقهون؟
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة يوسف 12: 15 ) : " فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ " . فأين جواب لمّا؟ ولو حذف الواو التي قبل أوحينا لاستقام المعنى.
هذا من أساليب البلاغية العالية للقرآن أنه لا يذكر لك تفاصيل مفهومة بديهة في السياق. فإن جملة (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ) معطوفة على محذوف يفهم من سياق القصة تقديره: فأرسله معهم . (إعراب القرآن الكريم 4/461) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة الفتح 48: 8 و9 ) : " إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيرا لتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً " . وهنا ترى اضطراباً في المعنى بسبب الالتفات من خطاب محمد إلى خطاب غيره. ولأن الضمير المنصوب في قوله تعزّروه وتوقروه عائد على الرسول المذكور آخراً وفي قوله تسبحوه عائد على اسم الجلالة المذكور أولاً. هذا ما يقتضيه المعنى. وليس في اللفظ ما يعينه تعييناً يزيل اللبس. فإن كان القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائداً على الرسول يكون كفراً، لأن التسبيح لله فقط. وإن كان القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائداً على الله يكون كفراً، لأنه تعالى لا يحتاج لمن يعزره ويقويه!!
نعم. فإن كان القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائداً على الرسول يكون كفراً، لأن التسبيح لله فقط .
ولكن بعد أن قال تعالى (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيرا) فقد بيَّنَ فائدة وأسباب الإرسال المرتبطة بلام التعليل ليعلم الرسول والناس كلهم السبب من إرساله لذلك قال (لتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً).
والخطاب هنا للرسول فى الإرسال ، ثم توجه للمؤمنين به ليبين لهم أسباب إرساله لهذا الرسول . كما لو خاطب المدرس أحد تلاميذه أمام باقى تلاميذ الفصل، فقال له: لقد أرسلتك إلى زملائك لتعلموا كلكم بموعد الإمتحان .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة الإنسان 76: 15 ) : "وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا " بالتنوين مع أنها لا تُنّوَن لامتناعها عن الصرف؟ إنها على وزن مصابيح.
لو رجعت للمصحف لعرفت أن قواريرا غير منونة ، فهى غير منونة على قراءة عاصم وكثيرين غيره ، ولكن قرأ الإمامان النحويان الكسائى الكوفى ، ونافع المدنى قواريراً منصرفة ، وهذا جائز فى اللغة العربية لتناسب الفواصل فى الآيات .
.
اقتباس:
وجاء في ( سورة الإنسان 76: 4 ) : "إِنَّا أَعْتَدْنَال لْكَافِرِينَ سَلاَسِلاً وَأَغْلاَلاً وَسَعِيراً " . فلماذا قال سلاسلاً بالتنوين مع أنها لا تُنوَّن لامتناعها من الصرف؟
سلاسلاً ليست من أوزان الأسماء الممنوعة من الصرف الخاصة بصيغة منتهى الجموع . وأوزان الأسماء التى على صيغة منتهى الجموع هى:
(أفاعل – أفاعيل – فعائل – مفاعل – مفاعيل – فواعل – فعاليل) مثل: أفاضل – أناشيد – رسائل – مدارس – مفاتيح – شوارع – عصافير) .
ويمنع الاسم من الصرف فى صيغة منتهى الجموع بشرط أن يكون بعد ألف الجمع حرفين ، أو ثلاثة أوسطهم ساكن:
1- مساجد: تمنع من الصرف لأنها على وزن مفاعل (صيغة منتهى الجموع) ولأن بعد الألف حرفان.
2- مصابيح: تمنع من الصرف لأنها على وزن مفاعيل (صيغة منتهى الجموع) ولأن بعد الألف ثلاثة أحرف أوسطهم ساكن.
وقد قرأت سلاسلَ بدون تنوين على لغة من لغات أهل العرب التى تصرِّف كل الأسماء الممنوعة من الصرف فى النثر. أو أن تكون الألف المنونة فى سلاسلاً بدلاً من حرف الإطلاق. (الكشاف للزمخشرى ج 4 ص 167)
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة الشورى 42: 17 ) : " اللهُ الذِي أَنْزَلَ الكِتَابَ بِالحَقِّ وَالمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ " . فلماذا لم يتبع خبر لعل اسمها في التأنيث فيقول: قريبة ؟
في الآية مقدر محذوف وهو مجيء الساعة قريب . وفيه أيضا فائدة وهي أن الرحمة والرحم عند العرب واحد فحملوا الخبر على المعنى .
ومثله قول القائل: "إمرأة قتيل". ويؤيده قوله تعالى ((قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي)) فأتى اسم الإشارة مذكراً . ومثله قوله تعالى ((وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)) .
واللي حضرتك تجهله أن المذكر والمؤنث يستويان في أوزان خمسة:
1 - فعول كرجل صبور وامرأة صبور.
2 - فعيل: كرجل جريح وامرأة جريح.
3 – مفعال: كرجل منحار وامرأة منحار أي كثير النحر.
4 – فعيل: بكسر الميم مثل معطير ومسكين وجوزه سيبويه قياسا على الرجل.
5 – مفعل: بكسر الميم وفتح العين. كمغشم وهو الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه من شجاعته. ومدعس من الدعس وهو الطعن.
(إعراب القرآن الكريم 9/25) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة البقرة 2: 196 ) : " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَاِملَةٌ " . فلماذا لم يقل تلك عشرة مع حذف كلمة كاملة تلافيا لإيضاح الواضح، لأنه من يظن العشرة تسعة؟..،وهذا ينافي البلاغة والقوة اللغوية،فهل أُبهرت قريش بأسلوب لغوي ركيك كهذا؟لا أظن!...
إن التوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب ، كقوله تعالى: ((وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)) ، وقوله تعالى: ((وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ)) ، أو يقول قائل سمعته بأذني ورأيته بعيني ، والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر عنه بالعبارات الكثيرة ويعرف بالصفات الكثيرة، أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذى يعبَّر عنه بالعبارة الواحدة ، وإذا كان التوكيد مشتملاً على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من المهمات التى لا يجوز إهمالها البتة .
وذهب الإمام الطبري إلى أن المعنى "تلك عشرة فرضنا إكمالها عليكم، إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج، فأخرج ذلك مخرج الخبر" .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة الأنبياء 21: 3 ) : "وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الذِينَ ظَلَمُوا " . مع حذف ضمير الفاعل في أسرّوا لوجود الفاعل ظاهراً وهو الذين .
إن هذا جائز على لغة طيء وأزدشنوءة ويضرب اليوم لهذه اللغة مثالاً وهو ما يسمى بلغة (أكلوني البراغيث) نحو ضربوني قومك وضربنني نسوتك. وفي الحديث الطويل قول النبي :salla-icon: لورقة بن نوفل رحمه الله "أوَ مخرجي هم" . وكان عمرو بن ملقط الجاهلي من شعراء العرب الأوائل يقول:
أُلفِيَتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا وقيه
(إعراب القرآن الكريم 6/279).
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة يونس 10: 21 ) : " حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ " . فلماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ والأصحّ أن يستمر على خطاب المخاطب.
إن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة من أعظم أنواع البلاغة . فإنه لما كان قوله تعالى ((هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ)) خطابا ينطوي على الامتنان وإظهار نعمة المخاطبين ، ولما كان المسيرون في البر والبحر مؤمنين وكفارا والخطاب شامل لهم جميعا حسن الخطاب بذلك ليستديم الصالح الشكر ، ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة فيتهيأ قلبه لتذكر وشكر مسديها . ولما كان في آخر الآية ما يقتضي أنهم إذا نجوا بغوا في الأرض عدل عن خطابهم بذلك إلى الغيبة لئلا يخاطب المؤمنين بما لا يليق صدوره منهم وهو البغي بغير الحق. ومن جهة أخرى ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها كالمخبر لهم ويستدعي منهم الإنكار عليهم والتقبيح لما اقترفوه، ففي الإلتفات فائدتان وهما المبالغة والمقت والتبعيد .
(إعراب القرآن الكريم 4/226) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة التوبة 9: 62 ) : " وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ " . فلماذا لم يثنّ الضمير العائد على الاثنين اسم الجلالة ورسوله فيقول : أن يرضوهما
أفرد الضمير للدلالة على أن إرضاء الله هو عين إرضاء الرسول. كذا قال أهل العلم: أن إفراد الضمير لتلازم الرضاءين .
وقال سيبويه بأن المراد الله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك . فيكون الكلام جملتين حذف خبر إحداهما لدلالة الثاني عليه والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك . (إعراب القرآن الكريم 4/121) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اقتباس:
جاء في ( سورة التحريم 66: 4 ) : " إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا " . والخطاب (كما يقول البيضاوي).موجّه لحفصة وعائشة. فلماذا لم يقل صغا قلباكما بدل صغت قلوبكما إذ أنه ليس للاثنتين أكثر من قلبين؟
إن الله عز وجل قد أتى بالجمع في قوله (قُلُوبُكُمَا) وساغ ذلك لإضافته إلى مثنى وهو ضميراهما . والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى .
فإن العرب كرهوا اجتماع تثنيين فعدلوا إلى الجمع لأن التثنية جمع في المعنى والإفراد. لا يجوز عند البصريين إلا في الشعر كقوله:
حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من العز الفوادي مطيرها
(إعراب القرآن الكريم 10/134) .
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
:p018:
ممكن حضرتك تقول لنا الفرق بين : لا يوجد في المدرسة طفل , لا يوجد في المدرسة أطفال ؟:king: