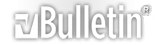الروابط فى المرفقات
موسوعة علمية معجمية مفصلة في شواهد اللغة العربية من الأشعار، وقد ذكر فيها الأبيات وبحرها وقائلها ومكانها التي وردت فيه . وقد استوعب قدرا كبيرا من الشواهد لم يسبق إليها كتاب وقد رتبه حسب القوافي على الترتيب الألفبائي
يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات المعجمية كان" إبراهيم بن مراد" قد كتبها بين 1978 و1986، ونشر بعضها في حوليات الجامعة التونسية ومجلة المعجمية التي تصدرها جمعية العربية بتونس. وتعالج هذه الدراسات جملة من قضايا المعجم العربي في القديم والحديث، أهمها ثلاث: أولادها قضية المعجم العلمي العربي المختص. ثانياً: المنهج في المعجم العربي. وقضية المنهج في الحقيقة هي معضلة الثقافة العربية المعاصرة، بل إن أزمة التفكير العربي المعاصر هي أزمة منهج. ومظاهر هذه الأزمة جليلة في المعجم العربي الحديث، العام منه والمختص. فالسمة الغالبة عليه هي "التسيب" المنهجي في مستويي الجمع والوضع على السواء. وأسباب هذا "التسيب" كثيرة، لعل أهمها انعدام التخصص في المعجمية -النظرية والتطبيقية- عند كثيرين ممن ألفوا فيها، والاحتكام إلى الهوى والمذهب قبل الاحتكام إلى العلم ومقتضياته، والقول بالإقليمية الضيقة قبل القول بوحدة اللغة والثقافة، والعقلية الحالمة التي تنظر إلى اللغة- قديمها وحديثها- حسب ما تتمنى أن تكون عليه وليس حسب ما كانت وما هي عليه حقاً.
والقضية الثالثة هي قضية الاقتراض في المعجم العربي. وقد وجه البحث فيها إلى محورين اثنين: أولهما دور الاقتراض في إثراء المعجم العلمي العربي المختص، باعتباره وسيلة من وسائل الخلق المعجمي والتوليد اللغوي، وثانيهما حق المقترضات اللغوية العربية -وخاصة القديم منها- في أن تتنزل منزلتها من المعجم اللغوي العربي العام، شأنها شأن الفصيح تماماً.
برع العرب في فنون عديدة ساعدهم على ذلك اتساع رقعة دولتهم واحتكاكهم بالأمم الأخرى التي أخذوا عنها فأضافوا لما أخذوا ولقحوا كما طرقوا أبواباً جديدة لم تكن معروفة عند سابقيهم. وقد عنى المؤلفون العرب بموضوع التعريف بالبلدان والأقطار وأخبارها ووصفها ومواقعها وقد بلغوا في ذلك الغاية.
وكتاب الروض المعطار في خبر الأقطار يتدرج ضمن هذا الجهد إذ عمد مؤلفه محمد بن عبد المنعم الحميري، أبو عبد الله إلى وضعه لهذه الغاية وقد التزم خطة سار عليها في كتابه فجعل المعجم على حروف المعجم، واكتفى بذكر الأماكن المشهورة أو الأماكن التي اتصلت بها قصة أو حكمة أو غير ذلك مما يستجوب ذكره. كما لم يلتفت إلى ذكر الأماكن المعمورة أو غير المشهورة ورغم أنه أراد لمعجمه أن يكون معجماً جغرافياً تاريخياً فإنه تعمد الإيجاز في مواضيع عديدة.
هذا كتاب عن الأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي، صنفه المستشرق النمسوي الأستاذ إدوارد فون زامباور، وصدرت منه طبعتان: إحداهما باللغة الألمانية، والأخرى باللغة الفرنسية، وكان فراغه من وضع هذا الكتاب في بداية الربع الثاني من القرن الحالي.
كان زامباور من رجال السلك السياسي في بلاده، وظل وزيراً مفوضاً للنمسا في البلاط العثماني من سنة 1913 إلى سنة 1918، وكان مولعاً بجمع النميات ودراستها حتى أصبح من أئمة هذا الميدان، فعهد إليه المشرفون على دائرة المعارف الإسلامية بتحرير المواد المتصلة بالسكة الإسلامية؛ وقد نشر، فضلاً عن ذلك، طائفة من المقالات القيمة عن النميات الشرقية، في مجالات مختلفة، ثم عنى إلى جانب هذا كله بدراسة 'الكامل في التاريخ' لابن الأثير دراسة جيدة، ونقله إلى الفرنسية: وكان قد فرغ من هذه الترجمة سنة 1949 حين وافته المنية، ولسنا نعرف مصيرها إلى اليوم.
لم يكن هذا الكتاب الذي صنفه زامباور-في أنساب الأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي-أول كتاب شامل من نوعه، فقد سبقه إلى هذا الموضوع المستشرق الإيرلندي الأستاذ ستانلى لين بول الذي أصدر سنة 1894 كتابه المشهور عن الأسر الحاكمة الإسلامية. ولكن تقدم الدراسات التاريخية الإسلامية ونشر كثير من المصادر القديمة اقتضى مراجعة هذا الكتاب وإصدار طبعة منقحة منه. ومع ذلك لم يقدم أحد على هذا العمل، اللهم، إلا المستشرق الروسي بارتولد، فقد ترجم كتاب لين بول إلى الروسية سنة 1899، وأضاف إليه بعض الحواشى والملحقات مما اهتدى إليه من إصلاح أو زيادة. ومن أسف أن الأستاذ بارتولد لم ينشر بعد ذلك طبعة منقحة من كتاب لين بول. وقد حدث بعد ذلك أن نقل الأستاذ خليل أدهم إلى التركية كتاب الأسر الحاكمة تأليف لين بول، فرجع زامباور إلى هذه الترجمة قبل إصدار كتابه الذي نقدمه بهذه السطور.
ولا شك في أن هذا الكتاب جليل الفائدة للمشتغلين بالتاريخ والآثار الإسلامية، وانه تقدم في ميدان هذه الدراسات خطاً واسعة عن كتاب لين بول، ولا سيما أن زامباور اعتمد على "الكامل في التاريخ" لابن الأثير اعتماداً حسناً وبخاصة فيما يختص بتاريخ أتابكة الموصل، كما أنه أفاد إفادة عظيمة من الكتابات التاريخية والنميات.
ويمتاز كتاب زامباور بأنه لم يقف عند سرد الأسرات الرئيسية بل امتد إلى كثير من الأسرات الثانوية وأسرات الوزراء والولاة وأعلام القواد، كما امتاز باشتماله على فصل كبير عن ولاة الأمصار. ولكن كتاب لين بول ظل يمتاز بالنبذ التاريخية التي ألمّ فيها المؤلف بتاريخ كل إقليم من الدولة الإسلامية قبل سرد الأسرات التي تعاقبت على حكمه. واعتذر زامباور من عدم استطاعته ذلك في كتابه بالنظر إلى ضيق المكان وبسبب اتساع نطاق الجداول والأسرات فيه.
إن كثيراً من المحدثين قد اعتنوا بجمع أسماء مشايخهم، وتدوين أخبار كبارهم، فرأى ابن حجر أن يقتدي بهم، فجمع أسماء شيوخه، بالترتيب الألفبائي، وقد قسمهم على قسمين: الأول: من حمل عنهم على طريق الرواية، والثاني: من حمل عنهم على طريق الدراية، وإضافة إلى هذا المقصد فالكتبا يعدّ أيضاً من كتب التراجم، إذ حوى تراجم شيوخه الذين أورد أسماءهم، وهذه طبعة محققة تحقيقاً علمياً ومقارنة مع تسع خطية أخرى.
كتاب جليل حوى دررا من مناقب الصحابة وانوار فضائلهم وبعض اثارهم فذكر كذلك اسماءهم وبعض الاثار المروية عنهم. وقد جاء الكتاب مضبوطا بالشكل الكامل لأسماء الصحابة والأحاديث المروية عنهم ومرتبا على حروف المعجم ليسهل الرجوع الى أي من اسماء الصحابة رضوان الله عليهم.
معجم ألقاب الشعراء محاولة جادة لاستقصاء ظاهرة عرف بها العرب أكثر من غيرهم، وكانوا يقولون: الألقاب تنزل من السماء. وقد خص شعراؤهم بهذه الظاهرة من بين الآخرين. وقلما نعثر على شاعر لم يحظ بلقب اختاره لنفسه أو اختاره له غيره.
يضم هذا المعجم ألقاب الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي حتى القرن العاشر الهجري.
ويستند منهجه على المحاور الآتية: ترتيب الألقاب على حسب الحروف الهجائية. إيراد أسماء الشعراء الكاملة بعد ألقابهم والعصور التي عاشوا فيها. تعليل لقب كل شاعر مذكور في هذا المعجم ما أسعفت المصادر. وتمتاز هذه الطبعة بتنقيحات هامة، وإضافات مغنية، وضبط وتشكيل يسمحان للقارئ بالوصول إلى المعاني بيسر.
مؤلف عام وشامل لكل المعاني والمفردات والمصطلحات التي تتضمنها مادة التاريخ، وقد رتبت هذه المصطلحات ترتيباً معجمياً، بحيث يكون عوناً للباحثين والعاملين بمختلف المجالات المتصلة بتراثنا عبر العصور السالفة كلها
-----------
الأنساب لغة: مفردها: النسب. وتعني: القرابة، أو هو في الآباء خاصة. وقال ابن السكيت: يكون من قبل الأم والأب. وهو أن تذكر الرجل فتقول: هو فلان بن فلان، أو تنسبه إلى قبيلة أو صناعة. واستنسب الرجل، كأنتسب: أي ذكر نسبه. ويقال للرجل، إذا سئل عن نسبه: "استنسب لنا" أي انتسب لنا، حتى نعرفك.
وعلم الأنساب من العلوم الأساسية التي شغلت حيزاً كبيراً من الاهتمام عند مؤرخي العرب ونسابيهم. فتركوا لنا كثيراً من التصانيف والمؤلفات في هذا المضمار. والأنساب أنواع كثيرة منها: الذين نسبوا إلى قبائلهم: كالبكري، والتغلبي. والذين نسبوا إلى بلادهم: كالأندلسي، والشآمي. والذين نسبوا إلى مدنهم وأماكن ولادتهم ونشأتهم وإقامتهم ووفاتهم: كالإسكندري، والبصري. والذين نسبوا إلى نحلتهم أو مذهبهم أو طريقتهم: كالحنفي، والحنبلي. والذين نسبوا إلى مهنتهم أو حرفتهم أو صناعتهم: كالأسطرلابي، والحصري. والذين نسبوا إلى مؤدبيهم وأساتذتهم أو لمن لازموهم وخدموهم: كالأفضلي. والذين نسبوا إلى علوم وآداب شغفوا بها، واهتموا بدراستها وتدوينها: كالأعمشي، والتاريخي. وجميع هذه الأنساب التي ذكرناها سابقاً، لا تدخل في هذا المعجم، لا من قريب ولا من بعيد، إنما الذي يعنيه في المقام الأول والأخير الذين نسبوا إلى أمهاتهم.
ويمكن تقسيم المنسوبين إلى أمهاتهم إلى قسمين: أولاً: منهم من عرف واشتهر بنسبته إلى أمه ولم يعرف باسمه الحقيقي. مثال ذلك: ابن حنينة. ثانياً: ومنهم من عرف بنسبته إلى أمه، كما عرف باسمه الحقيقي. كابن أم بلال.
هذا وقد فطن مؤرخو الأدب العربي ورواته القدامى إلى هذه الظاهرة المميزة، فوضعوا فيها العديد من المصنفات، واستقصوا بها مجمل ما وصل إلى أسماعهم منها، ومن هذه المصنفات نذكر: "كتاب من نسب إلى أمه". "كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء" لمحمد بن حبيب البغدادي السامرائي. و"ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه" وهو أيضاً لمحمد حبيب البغدادي السامرائي وغيرهم.
والمعجم الذي بين يدينا يدخل ضمن نطاق السعي لتناول هذا الموضوع، غير أن ما يميزه هو أنه الأول في العربية الذي تطرق لهذا الموضوع بشمولية، حيث أنه لم يتخذ جانباً معيناً فيتحدث عنه، وإنما تناول أصحاب الأنساب في كل العصور العربية والإسلامية بدءاً من العصر الجاهلي وانتهاءً بالربع الأول من القرن العشرين: فبلغ عدد المنسوبين إلى أمهاتهم أو أجداتهم خمس مئة وثمانية وثلاثين علماً.
وإذا ما تتبعنا منهجية هذا المعجم نجده أولاً قد عمد إلى ترتيب هؤلاء المنسوبين ألفبائياً، حسب النسبة لا حسب الاسم أو الكنية. ثانياً: أعد ترجمة موجزة لكل علم من أعلام الأنساب، تناول فيها الحديث عن اسمه وكنيته ونسبه ومراحل حياته منذ ولادته حتى وفاته، مع ذكر أشهر أعماله أو مؤلفاته. ومتطرقاً بشكل أساسي ومباشر إلى الحديث عن انتسابه. فذكره بفقرة مستقلة. ثم أردف ذلك بذكر شيء من أشعاره أو أقواله أو آرائه وحكمه. ثالثاً: ذكر في الحاشية جميع المصادر والمراجع التي تناولت صاحب الترجمة أو مؤلفاته وآثاره بالدراسة والنقد والتحليل، وقد بلغت أحياناً العشرات. وذلك لمساعدة القارئ أو الباحث والدارس ومده بسيل كبير منها، إذا ما أراد أن يعرف المزيد عن هذه الشخصية، أو إن يقوم بكتابة بحث، أو دراسة أكاديمية جامعية عنها. رابعاً: يتميز هذا المعجم بوفرة مصادره الأساسية -التي تناولت موضوع الأنساب بشكل مباشر- وبغزارة ومراجعه الثانوية العامة والتي تشمل كتب التراث والتراجم والمعاجم والموسوعات العربية القديمة منها والحديثة. وقد بلغ عدد هذه المصادر والمراجع مئة وثلاثين ما بين كتاب -يبلغ عدة مجلدات- وكتيب ورسالة.
وخلاصة القول فإن هذا المعجم الطريف بموضوعه، الغني باشتماله على معلومات فكرية وثقافية وأدبية وعلمية، الجديد بمنهجيته وطريقة معالجته، يسد ثغرة من ثغرات المكتبة العربية، ويرفدها برافد التواصل بين الماضي والحاضر.
يعتبر العصر المملوكي من أهم العصور التاريخية التي مرت على بلاد الشام ومصر... وهو أولى العصور بالدراسة والتحليل، ذلك إننا في بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن بصورة خاصة وفي العالم الإسلامي بصورة عامة، متصلون اتصالاً وثيقاً بهذا العصر في ثقافتنا وتفكيرنا وأخلاقنا وعاداتنا وما إلى ذلك من شؤون. ورغماً عن العهد العثماني الذي فصل بيننا ويبن العصر المملوكي بنحو أربعة قرون، فإننا ما زلنا متأثرين إلى حد بعيد بالعصر المملوكي فأسواقنا وحماماتنا وخاناتنا وتيسرياتنا وجوامعنا ومساجدنا ومدارسنا جلها مملوكية.
وإذا رجعنا إلى حياتنا الفكرية والعلمية نجد أنفسنا خاضعين في تفكيرنا للكتب المؤلفة في العصر المملوكي، أمثال ألفية "ابن مالك" وشروحها، وعلوم البلاغة، وكتب التاريخ والتراجم... وقد موت هذه الكتب المئات من الألفاظ التاريخية التي تكررت مراراً، سواء بهذه الكتب، أم بغيرها من أمهات الكتب التاريخية التي تعود للعصر المملوكي "كصبح الأعشى للقلقشندي" وأمثاله. وحباً في تقديم الفائدة للمتهمين بتاريخ هذا العصر، غنى المعجّم "محمد أحمد دهمان" بجمع هذه الألفاظ بهذا المعجم المصغّر، الذي يحتوي على ثماني مائة كلمة مشروحة بأسلوب سهل مبسط يمتع القارئ والباحث والمطلع العربي على حد السواء.
لما كانت كتب المذكر والمؤنث كلها أو معظمها، القديمة والحديثة، لا تلبي حاجة الكاتب العربي، سواءً من ناحية ترتيب موادها وفصولها، أو من ناحية إحاطتها بجميع مسائل المذكر والمؤنث ومفرداتهما، فقد عني الدكتور "اميل بديع يعقوب" بوضع كتابه هذا الذي بين أيدينا والذي لا يدعي فيه أنه قد استقصى كل هذه المفردات وتلك المسائل، ولكنه يأمل أن يكون أكثر توفيقاً في تلبية حاجة الكتاب العرب من غيره، سواء في عدد مواده أم في أبحاثه، وقد قسمه إلى قسمين: قسم جعل فيه بعض مباحث المذكر والمؤنث، وقسم آخر خصصه لمفردات رتبها ترتيباً ألفبائياً. وهي مفردات لـ:المؤنث السماعي المعنوي، ما يجوز تذكيره وتأنيثه، ما يذكر أو يؤنث من الحيوان، الصفات التي يستوى فيها المذكر والمؤنث، الصفات الخاصة بالمؤنث، ولا علامة تأنيث فيها، الصفات التي قد يوصف المؤنث بها، ولا علامة تأنيث فيها، أعضاء الإنسان.
الصرف من أهم علوم العربية، وأصعبها. والذي يبين أهميته احتياج جميع المشتغلين بالعربية إليه أيما حاجة، لأنه ميزان العربية، فاللغة يؤخذ جزء كبير منها بالقياس، ولا يعرف القياس إلا كل من درس التصريف. أما غموضه فمتأت مما يتضمنه من إعلال، وإبدال، وإدغام ووجوب، معرفة الحروف الزوائد، وكثرة أوزان الفعل،وأوزان الاسم،وكثرة الشذوذ، واختلاف الآراء، وتعدد المذاهب، وكثرة المصطلحات" ولأهمية هذا العلم عني "راجي الاسمر" بوضع هذا المعجم المفصل في موضوع علم الصرف، وحاول فيه التبسيط ما استطاع إلى ذلك، وذلك سواء بإيراد الأمثلة، أم بطريقة الشرح، أم بإيراد تفصيلات المسألة الواحدة. وقد اعتمد في ذلك على عدد من المصادر والمراجع، ومن أهمها كتاب ابن عصفور "الممتع في التصريف" الذي توسع في مسائل الإبدال، والإدغام، والحروف الذائد. وأوزان الاسم. وزيادة في الإيضاح والشرح ألحق كتابه بملحقين، ضمن الأول منهما جداول تصريفية لبعض الأفعال، اختارها بحيث تمثل كل الأفعال العربية من حين التصريف، وضمن الثاني أهم كتب الصرف العربي.
كتاب "المعجم العربي بين الماضي والحاضر" مؤلف وجيز الحجم لكنه عظيم الفائدة، جليل القيمة، لأنه أرخ لحركة المعجمية العربية بعقل ناقد نافذ، ومنطلق يحيط بالمبادئ العامة دون أن يهمل الجزئيات الدقيقة، معتمداً قواعد التحليل والتركيب في آن.
واكب مسيرة المعاجم بدءاً من رسائل تفسير غريب القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف والشعر العربي، والرسائل اللغوية التي تعالج موضوعاً محدوداً ومحدداً، مروراً بأمهات المعاجم كالعين والجمهرة والبارع والصحاح والمقاييس والمحكم وأساس البلاغة والمصباح المنير، والعباب ولسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس، وصولاً إلى معاجم عصر النهضة كمحيط المحيط، وأقرب الموارد، والبستان، والمنجد، ومتن اللغة، والوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
وما يميز هذا المعجم أنه قد جاء ليصف عيوب المعاجم القديمة والحديثة في خمس مجموعات هي:-عيوب عدم الالتزام-عيوب النقص في الإحالة-عيوب عدم التمسك بالتناظر-عيوب تعريف المصطلحات الجديدة-عيوب نقص التكامل.
كما ودعى إلى الإصلاح والنهوض وإلى بناء المعجم العربي المنشود قائلاً: "والمعجم اللغوي أو العلمي الذي نريده للعربية لا يكفيه تأليف لجنة من كبار علماء اللغة... بل لا بد له من علماء في اللغة إلى جانب مختصين بمختلف العلوم الأخرى، يتوزعون مواده، ويسهمون في الإشراف على مختلف أقسامه... يعملون جميعاً في تنسيقه وتبويبه وطباعته حتى يخرج للناس المعجم العربي المنشود.
"موسوعة معارك العرب" أول موسوعة ثقافية من نوعها في الوطن العربي، تتضمن عرضاً لـ 160 معركة من المشرق العربي والمغرب العربي معاً وبالتحديد منذ صدر الإسلام حتى معركة الكرامة في الأردن عام 1968، وتضم أيضاً 254 مرجعاً باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية... وهذا ما يجعلها مكتبة قائمة بذاتها.
إلى جانب هذا تضمنت الموسوعة عشرات الخرائط والصور والرسومات العسكرية ومختلف أنواع الأسلحة القديمة والحديثة، كما احتوت فهرساً أبجدياً للمعارك يتناول اسم المعركة ومكان وقوعها وتاريخ وقوعها.
وباختصار إن "موسوعة معارك العرب" هي تعبير عن الالتصاق بماضينا الأصيل وعظمة أمتنا العربية الغنية بالرجال والقادة العظام الذين كانوا أوفياء لها...
أما المواضيع التي تطرقت لها أجزاء الموسوعة فهي:
الجزء الأول: يتضمن هذا الجزء تقديم العماد مصطفى طلاس، ومقدمة اللواء رياض تقي الدين، ومقدمة المؤلف. كما يتضمن أيضاً 27 معركة أهمها (من حرف الألف إلى الباء): معارك أبو قير وباب أليون في مصر، ومعارك أجنادين والأقحوانه وباب الواد وبلعا وبيت سوريك وبير السبع وبيسان في فلسطين، ومعارك أبو نجيم وأجدابيا وبئر عافية وبنينا في ليبيا، ومعارك أحد وبدر والبكيرية في الجزيرة العربية، ومعارك الأرك وبلش في الأندلس، ومعارك أنوال وبقدورة في المغرب، ومعارك الأنبار والبويب في العراق، ومعركة أم درمان في السودان، ومعركة البذ في أذربيحان إيران، ومعركة بلاط الشهداء في بواتييه...
الجزء الثاني: يتضمن ثلاثين معركة أهمها (من حرف التاء إلى الحاء): معارك تاقرفت وترهونة والجغبوب في ليبيا، والتل الكبير وحصن كريون في مصر، وتل النيرب والتوافيق في سوريا، وتل الفخار وحطين وجبل الرادار والمكبّر والجامعة العبرية وثورة 1936 في فلسطين، ومعارك الحرّاش والحوض وجبل الخضر في الجزائر، ومعارك الجسر والجمل وجلولاء في العراق، ومعارك جراب وحديقة الموت والجهراء وحنين في الجزيرة العربية.
الجزء الثالث: يتضمن 25 معركة أهمها (من حرف الخاء إلى الزين): معركة الزلاج في تونس، معارك الخمس ودرنة والحريبة واوية المحجوب في ليبيا، ومعارك الزلاقة وزامورا والخندق في الأندلس، معركة دمشق في سوريا، ومعارك الدهيشة ورأس العين وزرعين ورامات هاكوفيتش في فلسطين، معارك ذي قار وذات العيون الزاب في العراق، معركة الخطروم في السودان، معارك خيبر وذات السلاسل في الجزيرة العربية، معركة رشيد في مصر، معركة خورمسكر في عدن/اليمن، ومعركة الزرّاعة في غور الأردن.
الجزء الرابع: يتضمن 24 معركة أهمها (من حرف السين حتى الغين): معارك سبو وسبيطلة في المغرب، معارك السمّوع والشجرة والشيخ جراح والصبيم وصفد وطبرية وعطاروت وعكا وعين جالوت في فلسطين، معارك سواني بني آدم وعبد الغني والمشرّك وسيدي عبد الجليل والعوكلي وغدامس في ليبيا، معركة صفين في العراق، وعنجر وعين دارة في لبنان، سيدي إبراهيم وعبد الرحمن خنيج وعنابة وعين الزانة في الجزائر، وعرمان في سوريا، وعقرباء في الجزيرة العربية، وطلس على نهر سيحون.
الجزء الخامس: يتضمن 28 معركة أهمها (من حرف الفاء حتى الميم): معارك فزان والقرضابية ولبدة ومحروقة والمرقب في ليبيا، معارك اللسّانة ولوشة ومكلين في الأندلس، معارك قصر العظم والكفر والمزرعة والمسيفرة وميسلون في سوريا، معارك القادسية وقس الناطف في العراق، معارك قاقون والقسطل والقطمون وكفار عصيونه والماصيون والمصرارة في فلسطين، معارك الكاظمة والمذار في الجزيرة العربية، معارك قصر الشمع وميناء الإسكندرية في مصر، ومعركة الكرامة في الأردن، ومعركة المالكية في لبنان.
الجزء السادس: يتضمن 16 معركة أهمها (من حرف النون إلى الياء): معارك الناصرة والنبي يوشع والنبي يعقوب ونور شمس ويافا في فلسطين، ومعركة نهاوند في بلاد فارس، ومعركة اليرموك في سوريا، ومعركة وادي لكّة في الأندلس، معركة وادي المخازن في المغرب، معارك الهاني والهواري ووادي مرسيط في ليبيا، معارك الولجة ويوم مهران ويوم الأعشار في العراق، ومعركة وادي سودان في الجزائر.
دليل يضم جميع الاسماء العربية
ومرجع واف الاختيار أسماء الذرية من الاناث
الجغرافيا كما يدل عليها اسمها هي علم "وصف الأرض"، لكنها عملياً تعدت هذا الوصف وتناولت ميادين أوسع وأكثر تنوعاً مما أدّى إلى غنى اللغة وتعدد المفردات التي يمن تصنيفها في خانة هذا العلم وبالتالي أصبح ضرورياً وجود معجم يجمع بين طياته مختلف المفردات التي يمكن تصنيفها في خانة هذا العلم؛ وهذا المعجم جاء لتلبية هذه الحاجة، فهو يتعدى كونه مرجعاً في علم الجغرافيا ليكون مقدمة علومية ومنهجية ضرورية لدراسة وفهم هذا العلم الذي تبنى بالإضافة إلى مفرداته مفردات من ميادين كثيرة أخرى مثل العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية.
والمعجم بشكل عام يعتمد على التسلسل الأبجدي العربي للمصطلحات، وبالرجوع إلى منهجيته نجد أنه يضع الكلمة العربية وبعدها يقدم المرادف الفرنسي للمصطلح العربي ويحدد القسم الذي يندرج تحته (جغرافيا بشرية، اقتصادية، مناخ، تربة، الخ...)، ومن ثم يعطي شرحاً ويتناول مجالات تطبيقه. وقد تمّ إيجاد التسمية العربية إما بالاستعانة بالمعاجم والمؤلفات العربية الموجودة إما باستحداث تسميات مناسبة للمصطلحات الجديدة التي طرأت حديثاً على هذا العالم الذي يتطوّر مع تطوّر الأبحاث واتساع مجالاتها.
ونشير أخيراً إلى أن المعجم يضمّ في خاتمته قائمتين بالمصطلحات: واحدة حسب التسلسل الأبجدي العربي فتعطي المرادف الفرنسي للمصطلح ورقم الصفحة التي يرد فيها، وأخرى شبيهة تعتمد التسلسل الأبجدي الفرنسي وتعطي المرادف العربي ورقم الصفحة.
"معجم الألقاب والأسماء المستعارة في التاريخ العربي والإسلامي" معجم شامل يحتوي على ألقاب الشعر والأدباء والكتاب واللغويين والنحويين، والفلاسفة والمفكرين والأمراء والوزراء والأعيان، ومشاهير الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين في كلّ العصور بدءاً من العصر الجاهلي وانتهاءً بالنصف الأول من القرن العشرين.
وقد اشتمل على آلاف وسبعة عشر لقباً، جمعها المصنف من بطون المعاجم وكتب التراجم والموسوعات العربية القديمة منها والحديثة، وقد بلغت سبعمائة وثلاثة وستين مصدراُ أو مرجعاً، وعمد إلى ترتيبها-ترتيب الألقاب-ترتيباً ألفبائيا، غير معتد بابن وأبي وبنت وأم، كما وألحق كل صاحب لقب بترجمة موجزة، تناول فيها اسمه ونسبه وكنيته ومراحل حياته منذ ولادته وحتى وفاته، كما مؤلفاته الشعرية أو النثرية وذكر في نهاية ترجمته لقبه وسبب تلقيبه، متوخياً في ذلك كله الدقة والوضوح.
كتاب مهم جدا، يتضمن تراجم لشخصيات عرفت بالفصاحة والخطابة واخبار العرب وانسابهم ومحدثيهم واصحاب المقامات والنثر وكل من يحمل صفة الادب، وكذلك اشتمل على تراجم لادباء ترجموا من لغات اجنبية الى العربية والخطاطين وغيرهم. وقد جاءت التراجم مرتبة على الحروف الهجائية مما يستهل الرجوع اليها .
معجم البلدان هو كتاب هام من كتب التراث، ويعد من المصادر الأساسية. والمعجم إلى هذا لا يعد معجماً جغرافياً فقط، وإنما هو أيضا كتاب تاريخ وأدب، ومرجع من أعظم المراجع التي يمكن الاعتماد عليها. إذ أن المؤلف ضمنه أسماء البلدان والجبال والأودية والقيعان والقرى والمحال والأوطان والبحار والأنهار والغدران، وخلال ذلك كله كان يسرد كل ما يتعلق بتلك البلدان من أخبار وأحوال وآثار حتى انه كان ينحو أحيانا حتى النحوي في بعض المواضع ومنحى المؤرخ في موضع أخر ومنها الأديب والجغرافي ورجل الدين وعالم الاجتماع وعالم الآثار وعالم البيئة وعالم الأحوال وعالم النبات في مواضع أخرى. يذكر البلد أو الناحية أو المدينة ثم يغني هذه المعلومة بتعقيباته الهامة التي يرجع إليها الطالب والباحث والدارس في كثير من الأمور المتعلقة في ذلك الزمان. بالإضافة إلى ذلك أغنى ياقوت الحموي كتابه هذا بمقدمة في صفة الأرض وما فيها من الجبال والبحار وغير ذلك، وفي الأقاليم السبعة واشتقاقها والاختلاف في كيفيتها، وفي تفسير الألفاظ التي يتكرر ذكرها في هذا الكتاب، وفي أقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك. وفي جمل من أخبار البلدان ثم تلي ذلك معجم البلدان وفق الترتيب الأبجدي. وهذه لمحة يتعرف القارئ من خلالها عن هذا المبدع الذي سبق عصره في نمطية ذاك المؤلف بزمان. فهو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي. ولا يعلم شيء عن تاريخ مولده، وكل ما يعرف عنه أنه أخذ، وهو حدث، سيدا من بلاد الروم، وحمل إلى بغداد مع غيره من الأسرى فبيع فيها، فاشتراه تاجر اسمه عسكر الحموي، نُسب إليه وقيل له ياقوت الحموي: وكان الذي اشتراه جاهلاً بالخط، فوضعه في الكتّاب ليتعلم فينتفع به في ضبط أعماله التجارية، فقرأ ياقوت شيئا من النحو واللغة، ثم احتاج إليه مولاه، فأخذ يشغله بالأسفار في متاجره. ولم يمض زمن حتى أعتقه وأقصاه. فطفق ياقوت يكسب رزقه بنسخ الكتب، فاستفاد بالمطالعة علما. ولم يلبث مولاه عسكر أن عطف عليه، فأعاده وعهد إليه بتجارة سافر بها، ولما عاد وجد مولاه قد مات، فأخذ من تركته ما يمكنه من الاتجار، ثم سافر إلى حلب، وجعل ينتقل من بلد إلى آخر، حتى استقر في خوارزمه، فمكث فيها إلى أن أغار عليها جنكيز خان سلطان المغول سنة (616 هـ/1219 م)، فانهزم ياقوت إلى الموصل لا يحمل شيئا من ماله، ثم سار إلى حلب وأقام في ظاهرها إلى أن مات سنة (626هـ/1228م) وقد استفاد برحلاته الكثيرة فوائد جغرافية عديدة سنّت له تأليف هذا الكتاب.
يضع المؤلف بين يدي القارئ معجماً موسوعياً يتناول كامل المنطقة السامية، ويسهل سبل الوصول إلى تفهم تاريخها وحضارتها، وقد حصر موضوعه في الحقبة الزمنية الممتدة من مطلع العصور التاريخية إلى فجر الإسلام. شمل الموضوع المنطقة السامية المؤلفة من شبه جزيرة العرب وامتدادها، إلى سورية وبلاد ما بين النهرين وبلاد كنعان. شمل الموضوع المنطقة السامية المؤلفة من شبه جزيرة العرب وامتدادها، إلى سورية وبلاد ما بين النهرين وبلاد كنعان. متطرقاً من ثم إلى انتشار الساميين خارج حدود المنطقة السامية، ذاكراً الوجود العربي في الحبشة ومصر، والوجود الفينيقي في حوض البحر الأبيض المتوسط ولا سيما في قرطاجة متناولاً كذلك الشعوب المجاورة والفاتحين ممن تفاعلوا مع العالم السامي تاريخياً وحضارياً.
وبات في متناول القارئ الحصول على معلومات عن العرب في جنوب ووسط وشمال جزيرتهم، والعموريين والآراميين في سورية، والسومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين في بلاد ما بين النهرين، والكنعانيين والفينيقيين والعبرانيين والفلسطينيين في بلاد كنعان، والفينيقيين في حوض البحر الأبيض المتوسط، والهيكسوس والأحباش في أفريقيا، والفرس والعيلاميين والجوتيين والكاسيين والماديين في الشرق من بلاد ما بين النهرين، والبارثيين والميتانيين والحيثيين في شمال المنطقة، والمقدونيين والسلوقيين الإغريق الذين حكموا كامل المنطقة، والرومان والبيزنطيين الذين حكموا سورية، وغيرهم من أمم وشعوب عاشت في الرقعة السامية وتفاعلت مع أهاليها.
وقد عمد المؤلف في سبيل تقديم الموضوع بصورة معجمية إلى اتخاذ أسماء الأعلام مداخل إلى المواد، ذاكراً الأمم، والشعوب، والدول، والمدن، والملوك، والآلهة، والأساطير، والديانات، والأنبياء، والرسل والقديسين، واللغات، والعلماء، والفلاسفة، والكتاب، واللاهوتيين، ورجال الدين والعظماء، جملة وتفصيلاً، بحيث يتمكن القارئ من الحصول على معلومات عامة أو خاصة وفق مبتغاه وبأقرب السبل، ذاكراً في مطلع كل مادة، بالحرف اللاتيني، الاسم الفرنسي ثم الاسم الإنكليزي اللذين تعرف بهما هذه المادة، إلى جانب الاسم العربي. وذلك تسهيلاً للقارئ الراغب في مراجعة المادة في مصادر أجنبية.
ويكون المعجم بذلك، معجماً عربياً فرنسياً إنكليزيا للأعلام، واضعاً كذلك في آخر المعجم فهرساً فرنسياً يتناول جميع المواد الواردة في المعجم، يمكن القارئ من الوصول سريعاً إلى المعلومات في هذا المعجم العربي عن الأعلام التي تعرض له في المصادر الأجنبية. ويكون القارئ بذلك قد حصل على قاموس فرنسي-عربي للأعلام.
* معجم القبائل العربية القديمة والحديثة * تأليف عمر رضا كحالة
يتكون من خمسة أجزاء
وهو من اهم الكتب التي تخصصت في مجال الانساب والقبائل
أول دراسة علمية فى الأصول القرآنية للمصطلح الصوفى
معجم المصطلحات الصوفية التى تجيزها الأصول القرآنية والنبوية ، وهى مصطلحات صوفية مكونة من ألفاظ قرآنية أو نبوية ، وموضوعة على معانيها أو معان أخرى تجيزها الأصول القرآنية والنبوية ، ومرتبة ترتيبا ألف بائيا مشرقيا من حرف الألف إلى حرف الياء
-------------
الروابط فى المرفقات
(منقول)