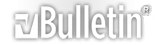-
الفصل الثاني
ماذا عن تطبيق الشريعة الإسلامية
الآن، وليس قبل الآن
مع إننا لم نتصور تطبيقاً للشريعة إلا بعد تعديلات جذرية في مضمون وشكل الشريعة نفسها، وفى رؤية العقيدة أيضاً، وفى نشر هذه الرؤية الجديدة وتعميقها حتى تشمل أغلبية المواطنين، إلا أن هناك عقبات ومحاذير خارج إطار هذين ـ أي العقيدة والشريعة ـ يتعين علينا أن نحسب حسابها وأن يكون لدينا حلولاً لما تثيره من مشكلات وإجابات لما ستطرحه من تساؤلات.
من هذه العقبات والمحاذير: عدم تهيؤ المجتمع لتقبل الشريعة الآن
هناك من يقول بمجرد أن يقرأ هذا العنوان إن تطبيق الشريعة مطلب شعبي وإن الشعب يطالب به من زمن وأنه مهيّأ لذلك من الآن، وإن الحكومات هي السبب في تأخيره، وليس أدل على ذلك من تقنين الشريعة في قوانين سنة 1987 وكان يمكن أن تعرض على مجلس الشعب وقتئذ وكان فيه مائة نائب معارض كلهم يناصرون الشريعة ولكن رئيسه العنيد رفعت المحجوب الذي كان أحد أقطاب الناصرية، احتفظ بها في درج مكتبه وأغلق عليها وقُتِلَ والمفتاح معه.
ففي الحقيقة أن المجتمع المصري ـ وهو ما ينطبق بصفة عامة على المجتمعات العربية الأخرى ـ تعرّض لمجموعة من التجارب السياسية والنظرية دون سابق استعداد أو دراسة أو اتفاق، فظهرت الأفكار اليسارية المصرية التي درست دراسات غربية وضاقت بوجوه النقص في الرأسمالية، ولكنها نقلتها كما عرضها ماركس ولينين، ومعظمها تبع الاتحاد السوفياتي، وقامت فيما بينهم منازعات وشقاقات مذهبية فرّقت شملهم، فضلاً عن أن ما قدّموه كان غريباً كل الغرابة على الأذن العربية، والقلب العربي فلم يظفروا إلا بأعداد قليلة من الناس ولكنهم وهم يسيطرون على الإعلام، استطاعوا أن يؤثّروا على مجموعات من الناس وعلى قدر من الرأي العام.
وبالطبع فإن الفكر الإسلامي كان أسبق الجميع، واكتسب الشارع المصري بفضل عبقرية ونبوغ حسن البنا وموهبته الفريدة في تنظيم الإخوان المسلمين وكان يرجى منها خيراً كثيراً، ولكن الإخوان خسروا مرشدهم عام 1949، ثم توالت الأحداث وقامت حركة 23 يوليو وحدث الصدام بينها وبين الإخوان، فصمت الإخوان حينا وحُظِرَ نشاطهم العلني بينما ظهرت الجماعات الإسلامية الشاردة التي كونت فكرها في سجون عبد الناصر وكردّ لتعذيبه المقيت. وككل الهيئات المتحمسة، دون دراسة عميقة، فقد ضلّلتها الشعارات والتصورات وألجأها حظر الحكومات لأن تلوذ بأسلوب العمل السرّي وانساقت في منزلقاته فأضاعت على نفسها ثلاثين عاماً قبل أن تتبيّن خطأ وضلال دعاوي "الحاكمية الإلهية".
وقبيل ذلك، سقط نظام عبد الناصر مع هزيمة 67 المروعة وسقطت شعارات القومية العربية والناصرية المزعومة، وسمح المجال بقدر من الحرية وللأخذ بالانفتاح الاقتصادي، فظهرت الرأسمالية المتطفّلة والسماسرة والانتهازيون الذين كونوا ثروات طائلة بوضع اليد على أراض "المدن الجديدة" أو بالعمولات أو بالغش والتزييف.
وتقبّل المجتمع المصري ذلك لأنه سمح لنفسه بفترة "استرخاء" بعد الحكم الحديدي الصارم لناصر، وتخبّط المجتمع المصري ما بين اقتصاد منفتح دون ضابط أثمر طبقة ثرية متخمة بثروات التطفّل والفساد الاقتصادي وبين نظام سياسي يتشبّث بالسلطة ويتمسّك بتراث عبد الناصر في الحزب الواحد والاستئثار بالسلطة وتقييد المعارضة وتزييف الانتخابات.
نتيجة لهذه التراكمات المتوالية التي كانت كلها تجارب فاشلة، فَقَدَ المجتمع ثقته في الجميع تقريباً، واستسلم واستسلمت المجموعات ذات المستوى الاقتصادي المرتفع للاسترخاء البرجوازيي وانساقت وراء نزعة الاستهلاك والاستمتاع بما تقدمه "الفضائيات" من برامج تصل بعضها إلى إباحية الجنس الصريح وما تقدّمه "المول" والسوبر ماركت من سلع مبهرة بينما كان على الأغلبية أن تكدح حتى يمكن أن تكفل لنفسها بقاء وأصبحت تلهث وراء لقمة العيش.
من هنا نعرف أن المجتمع المصري لم يعد واثقاً، كما كان في الأول، في التوجّه الإسلامي وإن ظل موجوداً بل وأكثرها شيوعاً، ولكن على غير وضوح وتذبذب ما بين الاتجاهات الانفعالية المتحمسة وما بين الاتجاهات السلفية المحافظة وأن بقية فئات المجتمع لا تتحمس لدعوة تطبيق الشريعة، أو حتى لتقبلها، وقد تعارضها، وأصبح يغلب عليها الإحباط.
المجتمع المصري اليوم غير مهيّأ للتطبيق السليم للشريعة، فمعظم ذوي الاتجاهات الإسلامية هم من السلفيين، وفكرتهم عن الشريعة لا تصلح، وهم يظنّون مع هذا أنهم هم الذين يمثّلون الإسلام ويقاومون كل اتجاه للتجديد أو الإصلاح، أما بقية شرائح المجتمع فهي تتوزع ما بين طبقه "الأثرياء الجدد" ومن حولهم، وقد كونوا لأنفسهم طوال العشرين عاماً الماضية، وجوداً وكيانا وهيمنة على الصحافة والإعلام، وما بين فلول الناصرية واليسارية والقومية ممن يعوضون فشل نظرياتهم بالتعصّب والادعاءات..
لهذا سيكون على الشريعة أن تسير طويلاً في دعوتها قبل أن تصل إلى مجموعات لها ثقل تؤمن بها. وأن تواجه صعوبات وعراقيل معارضة لأن هذه المهمّة هي في حقيقتها تجاوز الأطر السلفية إلى فهم جديد للعقيدة والشريعة، ومنظومة المعرفة الإسلامية، وليست هذه بالمهمة الهيّنة أو السريعة.
فإذا أريد تطبيق الشريعة فلا بد أولاً من تقديم الصورة السليمة لها والتي تختلف جذريا عما يقدمه الفقه السلفي بقدر ما تختلف عما تقدمه الانبعاثات الجهادية، ثم عليها بعد ذلك أن تسير طويلاً على طريق الدعاة لتكسب لفكرتها عن الشريعة جمهوراً له وزن وثقل ويعتد به كمّاً ونوعاً، وكما هو معروف فإن هذا ليس بالأمر الهين أو الذي يمكن إنجازه في وقت قصير.
فلابد من إيجاد دولة الإسلام أولاً في نفس كل فرد لتوجد بعد ذلك على أرض الواقع.. وهذا ما فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مدى ثلاثة عشر عاماً هي عمر الدعوة في مكة.
-
الفصل الثالث
الدستور وفقه غياب المصطلحات
مقدمة
لا يخلو مجتمع، صغر حجم أفراده أو كبر، قلّ باعه في المدنية أو كثر، من شريعة وقانون ينظم مسيرة أبنائه، يسلك بهم سبل التعاون على الخير، ويبين حدود كل واحد منهم، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، ضمن منظومة مجتمعية حاكمة لها سلطة القانون، وحتى في المجتمعات الصغيرة المتناثرة التي انقطع عنها حبل المدنية والحضارة، أو لم يصل إليها نور الشرائع روحها، فإنها تعيش في إطار شبكة من الشرائع التي تبنتها على مدار الزمن ودونتها عقليات هذا المجتمع وان تدانت في المدنية من وجهة نظر الآخرين.
وتصاغ الشريعة في صورة قوانين.. والقانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون..
أي أن القانون لكي يمكن تطبيقه واحترامه يجب أن يتكون من قواعد واضحة ليس فيها لبس.. ولهذا السبب استقر الرأي في كل الدول الحديثة أنه لا يتم سن أي قوانين إلا من خلال مجلس واحد وهو المجلس التشريعي المنتخب ولا يتم تعديله إلا من خلال هذا المجلس.. ليكون القانون واضحا يسهل علي القضاة الحكم به.. ويسهل علي الدولة تطبيقه.. ويسهل على الأفراد حكاما ومحكومين احترامه.. واتفق ببساطة أن التشريع يعني سن القوانين..
وتقابل الشريعة أو القانون، اللاقانون والفوضى، حتى إذا ما أريد وصف الحالة الفوضوية المؤدية إلى خراب البلد، قيل في مثل هذا البلد والمجتمع أن شريعة الغاب تحكمه وتتحكم في أفراده، في إشارة إلى الحياة السبعية في الغابات والأدغال، على إن الحياة السبعية هي الأخرى تحكمها قوانين خاصة بها، وإلا لما أُطلق عليها شريعة الغاب، بل إن بني البشر في بعض الأحيان تسوقه الفوضى والخراب إلى الدرجة التي يتفوق فيها في اللاقانون على سكان الغابة من الوحوش الكاسرة، فلا يصدق معه مفهوم شريعة الغابة، ولا الشريعة المدنية، فيكون هو أقرب إلى شريعة القتل وهتك الحرمات منه إلى شريعة الغاب.
الدستور والجدل القائم حوله
في مشروع دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يوم الجمعة 16 من المحرم 1434 هجرية الموافق 30 من نوفمبر 2012 ميلادية والمعد بمعرفة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. ورد في مادته الثانية النص التالي:
(الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع).
وفي مادته الثالثة:
(مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية).
ونظراً لأن عبارة (مبادئ الشريعة الإسلامية) عبارة عامة يندرج تحتها الفقه الإباضي والقادياني والشيعي وهو ما يتنافى مع المادة الرابعة من الدستور والتي تنص على أن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المنوطة بالتشريع.. كان لابد من توضيح مفهوم المقصود من عبارة (مبادئ الشريعة الإسلامية) وذلك في المادة 219 في الفصل الثاني تحت عنوان أحكام عامة ما نصه:
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة).
ونظرا لغياب فقه المصطلحات وجدنا بعضاً من قادة الجماعات المعتبرة يدلون بتصريحات تنم على عدم الفهم للمادة (219) والشارحة للمادة الثانية فراحوا يرجون أن المقصود بعبارة (مذاهب أهل السنة والجماعة) الواردة في النص المقصود بها الجماعة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين.. وأن الأزهر وافق عليها بعدما تم رشوة شيخ الأزهر في المادة الرابعة والتي تنص على دور الأزهر في التشريع حيث ورد في المادة عبارة (شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء)..
يعني واحدة بواحدة..
هكذا قالوا في خطبهم ومحاضراتهم.. وناقشناهم وجادلناهم.. ولكن وسائل الإعلام قد أتاحت لهم مساحات أوسع للتعبير عن آرائهم فحدثت الفتنة في مصر حول الدستور..
لأن المقصود بعبارة (مذاهب أهل السنة والجماعة) الواردة في نص المادة 219 يعرف المفهوم من وراءها طالب الصف الأول في المرحلة الإعدادية الأزهرية.
فأهل السنة يقصد بهم أهل الفقه على المذاهب الأربعة وأضيف إليهم الفقه الظاهري وذلك في مواجهة الفقه الشيعي والقادياني وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول فلا نسب منهم أحداً..
والمقصود بالجماعة.. أي الأشعرية والماتردية في مواجهة فكر المعتزلة بقيادة واصل بن عطاء.. ولا علاقة أبداً بالجماعة السلفية ولا الإخوان بهذه المادة نهائياً..
-
الفرع الأول
شهادتي للتاريخ
قبل اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات بعام وتحديداً عام 1980م جاءني الأستاذ إبراهيم خطاب عضو مجلس الشورى رحمه الله بنسخة من قوانين تقنين الشريعة الإسلامية وعليها خاتم مجلس الشعب، وكان ضمن الكلام الذي دار بيننا أن الرئيس السادات ـ رحمه الله ـ كان قد عهد للدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بمسئولية إعادة تقنين كافة القوانين المعمول بها في مصر طبقاً للشريعة الإسلامية ، ولقد تم بدأ العمل الفعلي للتقنين في عام 1978 وتمت الاستعانة بصفوة من العلماء المتخصصين من الأزهر والقضاة وأساتذة كليات الحقوق وبعض الخبراء من المسلمين والمسيحيين، وتم تقسيم العمل إلى لجان يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس الشعب المتخصصين في المجال، إلى جانب هؤلاء الخبراء.
وكانت الخطة تقوم على عدم التقيد بالراجح في مذهب معين، بل الأخذ بالرأي المناسب من أي مذهب من المذاهب الفقهية.
وشرعوا في التقنين على أبواب الفقه وتقسيماته، وما لم يجدوه في كتب الفقه يلجئون إلى مقاصد الشريعة في استنباط الأحكام، وفي حالة تعدد الآراء الفقهية للمسألة الواحدة كانوا يختارون واحداً منها مع ذكر الآراء الأخرى ومصادرها على هامش الصفحة ليرجع إليها من يشاء.
كانت هذه هي خطة العمل كما هو مدون في مقدمة ذلك العمل الجبار..
هذا هو السادات الذي اتهم بالردة والخيانة والكفر.. ومن ثم تم استباحة دمه..
لماذا؟.. لأنه لا يطبق شرع الله..وكأن شرع الله تعالي مجرد ورقة وقلم..
وفي حواره مع الدكتور صوفي أبو طالب المنشور على الموقع التالي:
http://www.islamonline.net/servlet/S...ArticleA_C&cid
وذلك يوم الثلاثاء. مايو. 22, 2007..
سأل الأستاذ عاطف مظهر الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق ـ ضمن ما سأل فقال:
* هل يعني هذا الكلام أن مشروع تقنين الشريعة كانت تتبناه مجموعة أفراد في السلطة.. أم كان مشروعا للدولة المصرية؟
- الوصف الأدق له أنه كان مشروعا يساير (توجه) الدولة، وليس (مشروعا) للدولة، لأنه توقف بالفعل بعد أن غيرت الدولة سياستها منه!!، ولأن الدولة أحيانا إذا أرادت شيئا تجعل أحد أعضاء المجلس يقدم الاقتراح بقانون بإيعاز منها وبالنيابة عنها، وكان الرئيس السادات في كل الاجتماعات يحثنا على الإسراع لإنجاز مشروع التقنين.. وكان يطالبنا بعدم الانتظار حتى يكتمل تقنين كل القوانين، واقترح مرة أن ندفع بما ننجزه أولا بأول إلى مجلس الشعب لأخذ الموافقة عليه تمهيدا لتطبيقه وسريانه في المنظومة القانونية.
* هذا كلام جديد على الناس.. فهل كان السادات جادا فعلا في هذا الشأن وينوي تطبيق الشريعة في مصر؟ وهل أجهض حادث اغتياله تحقيق هذا المشروع؟
ـ استطيع أن أجزم أن الرئيس السادات (رحمه الله) كان جادا في مسألة تطبيق الشريعة، وكان سلوكه وكلامه يقطعان بذلك.. ولو قدرت له الحياة عاما أو عامين آخرين لرأينا تقنين الشريعة مطبقا على أرض الواقع. وكان الرئيس السادات في كل الاجتماعات يحثنا على الإسراع لإنجاز مشروع التقنين.. وكان يطالبنا بعدم الانتظار حتى يكتمل تقنين كل القوانين، واقترح مرة أن ندفع بما ننجزه أولا بأول إلى مجلس الشعب لأخذ الموافقة عليه تمهيدا لتطبيقه وسريانه في المنظومة القانونية.
والحديث منشور بتمامه في نهاية الدراسة..
وتحتفظ مكتبتي بنسخة أصلية من هذه القوانين وعليها خاتم مجلس الشعب، فهذه النسخة الوثيقة هي التي تبرأ ساحة الرئيس المصري محمد أنور السادات وكل من ساهم في إخراجها شهود عليها وكل أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين كانوا يعدون أنفسهم بالموافقة سواء من كان يرتضيها أو من يرفضها، كل هؤلاء شهود عليها.
هذه النسخة الوثيقة سوف يقابل بها السادات ربه باعتباره أول رئيس يقنن لمبادئ الشريعة الإسلامية بمصر وكأن دمه سال عليها من الخارجين عليه والذين أباحوا دمه.. مثل ما سال دم عثمان بن عفان على المصحف الذي كتبه وذلك من الخارجين عليه كذلك..
وهذه القوانين التي صاغها كبار رجال الفقه الجنائي والمدني والاقتصادي مطبوعة طباعة فاخرة في دول الخليج وعندي منها أيضاً نسخة في مكتبتي..
ولم يمت العمل في تقنين الشريعة بموت السادات رحمه الله ولكنه استمر حتى تم الانتهاء من كافة القوانين سواء الجنائية منها أو المدنية أو الاقتصادية..
يقول الدكتور صوفي :
(ومع حلول عام 1983 تم الانتهاء من جميع أعمال التقنين، وقمنا بطباعتها وعرضها على مجلس الشعب، وحظي بالموافقة عليه بالإجماع من أعضاء المجلس المسلمين والمسيحيين.. ومضابط المجلس مازالت موجودة وثابتة، وتشير إلى مدى تحمس المسيحيين لتطبيق الشريعة الإسلامية.).أ.ھ.
المشروع بالكامل على الرابط التالي:
ومن مضبطة مجلس الشعب الجلسة الحادية والستين ( دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث) المعقودة بتاريخ 20 يونيو 1982م أنقل لكم التالي:
-
أولاً: اقتراح بمشروع قانون
بإصدار قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب للقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات ويستعاض عنه بأحكام القانون المرافق الصادر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ..................
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
https://www4.0zz0.com/2020/04/05/14/985905918.jpghttp://www.ebnmaryam.com/vb/image/gi...EAAAICRAEAOw==
مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية
أولاً: تشكيل لجان خاصة للنظر في أعمال لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية
(مضبطة الجلسة الحادية والستين ـ دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث) المعقودة بتاريخ 20 يونيو 1982م.
رئيس المجلس:
يسعدنا أن أعرض على المجلس ما تم انجازه في موضوع تقنين الشريعة الإسلامية الذي طال انتظار الشعب له.
كان المجلس-إعمالا لحكم المادة الثانية من الدستور-قد وافق بجلسته المعقودة في 17 من ديسمبر سنة 1978 ,على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاقتراحات الخاصة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتقنينها، وقد رخص للجنة في أن تستهدي بكل الدراسات والتقنينات والقوانين الخاصة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في مصر أو في الخارج، كما رخص المجلس لها في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وفى القانون.
واستنادا إلى هذا القرار، ضم إلى اللجنة الخاصة بعض أساتذة الشريعة الإسلامية والقانون وبعض رجال القضاء، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها 20 من ديسمبر سنة 1978. وقد بدأت اللجنة ـ تيسيرا للعمل ورغبة في الإسراع وانجاز مهمتها ـ بتشكيل سبع لجان فرعية، هي لجان: التقاضي، والقوانين الاجتماعية، والمعاملات المالية والاقتصادية، والقانون المدني، والعقوبات، والتجارة، والتجارة البحرية.
وقد أنجزت هذه اللجان معظم أعمالها. وعرضتها على اللجنة الخاصة التي رأت أن تستأنس برأي الأزهر الشريف والجامعات والجهات القضائية فبعثت إليها بهذه الأعمال لإبداء الرأي في شأنها.
وقد روجعت بعض المشروعات المقترحة في ضوء ما انتهى إليه من رأي أو اقتراح من تلك الجهات واكتملت صياغتها النهائية.
كما أحطت المجلس علما في 12 من يوليه سنة 1980 في بياني إليه عن نشاطه خلال دور الانعقاد العادي الأول بمناسبة فض هذا الدور، بما انتهت إليه لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وما أنجزت من عمل.
وفى 29 من ابريل سنة 1981 أحيط المجلس علما بذلك وأقر تشكيل اللجنة الخاصة، ولجانها الفرعية بعد أن أحيط علما بكل ما أنجزته هذه اللجنة ولجانها الفرعية.
وأحطته كذلك ـ في بياني إليه في 12 من أغسطس سنة 1981 عن نشاط المجلس، فإني أقترح على حضراتكم الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الخاصة على أن تعاونها سبع لجان فرعية، وتتولى اللجنة الخاصة وضع خطة العمل ومتابعة أعمال اللجان الفرعية والتنسيق بين ما تنجزه من أعمال، وتتولى كل لجنة من اللجان الفرعية دراسة أحد المشروعات التي أنجزتها اللجنة الفنية السابقة وهي:
لجنة التقاضي.
لجنة القوانين الاجتماعية.
لجنة المعاملات المالية والاقتصادية.
لجنة المعاملات المدنية.
لجنة العقوبات.
لجنة التجارة العامة.
لجنة التجارة البحرية.
وللجنة الخاصة وغيرها من اللجان الفرعية الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية والقانون.
ومعنى ذلك أن هناك مشروعات تمت صياغتها بعد استطلاع رأي كل الجهات المسئولة المختصة، ولما كان الأمر يقتضي تشكيل لجان خاصة طبقاً للدستور واللائحة لعرض الموضوع على المجلس في صيغته النهائية، فإنني أقترح على حضراتكم هذا الأسلوب حتى يتسنى لنا نظر ذلك في الاجتماع المقبل إن شاء الله تعالى.
فهل توافقون حضراتكم على مبدأ تشكيل اللجان؟.
(موافقة).
رئيس المجلس:
استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس فإني اقترح على حضراتكم الموافقة على أن يكون تشكيل هذه اللجان على النحو التالي:
أولاً: الجنة الخاصة:
الدكتور صوفي أبو طالب رئيساً
الأعضاء
الأستاذ حافظ بدوي
الأستاذ إبراهيم شكري
الأستاذ أحمد على موسى
الأستاذ كامل ليلة
الأستاذ جمال العطيفي
الأستاذ طلبة عويضة
الأستاذ ممتاز نصار
الأستاذ حنا ناروز
الدكتور محمد على محجوب
وينضم إليهم من الأساتذة والمتخصصين السادة:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
وزير العدل
وزير الأوقاف
رئيس جامعة الأزهر
فضيلة المفتي
رئيس محكمة النقض
رئيس مجلس الدولة
النائب العام
رئيس إدارة قضايا الحكومة
رئيس محكمة استئناف القاهرة
مدير عام النيابة الإدارية
عبد العزيز عيسى وزير شئون الأزهر سابقاً
عبد المنعم النمر وزير الأوقاف سابقاً
زكريا البري وزير الأوقاف سابقاً
عبد المنعم فرج الصدة نائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً
عبد الحليم الجندي رئيس إدارة قضايا الحكومة سابقا
إبراهيم القليوبي النائب العام سابقاً
أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد فتحي مرسي نائب رئيس محكمة النقض سابقا وعضو مجلس الشورى
عبد الله المشد عضو مجمع البحوث الإسلامية
عطية صقر عضو مجمع البحوث الإسلامية
إبراهيم الوقفي عضو مجمع البحوث الإسلامية
محمد أنيس عبادة رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون سابقاً
حسين حامد رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة
إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض
أحمد السيد سليمان نائب الأمين العام السابق لمجلس الشعب ومستشار ورئيس المجلس
الدكتور جمال الدين محمود أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الدكتور فتحي سرور أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بحقوق القاهرة
نقيب المحامين
عمداء كليات الحقوق
عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
اللجان الفرعية
1 ـ لجنة التقاضي
الأستاذ ممتاز نصار رئيسا
الأعضاء
الأستاذ عبد الرحمن توفيق خشبة
الأستاذ عبد الله على حسن
الأستاذ فتحي زكي الصادق محمد على
الأستاذة بثينة الطويل
الأستاذ حامد على كريم
الأستاذة عنايات أبو اليزيد يوسف
الأستاذ إبراهيم الزاهد
الأستاذ على السيد هلال
2 ـ لجنة القوانين الجنائية:
الأستاذ حافظ بدوى.................رئيسا
الأعضاء
كمال خير الله
وديع داود فريد
حسين مهدي
طارق عبد الحميد الجندي
حازم أبو ستيت
محمد عبد الغفور السوداني
محمد عبد الحميد المراكبي
3_لجنة المعاملات الدينية:
الرؤساء
الدكتور جمال العطيفي ..................رئيسا
الأعضاء
الأستاذ عبد الباري سليمان
صلاح الطاروطي
جورج روفائيل رزق
عبد الرحيم عبد الرحمن حمادي
علي علي الزقم
محي الدين عبد الغفار محرم
عويس عبد الحفيظ عليوة
الأستاذة سماء الحاج أدهم محمد عليوة
4-لجنة التجارة البحرية:
الأستاذ احمد على موسى ..................رئيسا
الأعضاء
حنا ناروز
مصطفى غباشي
عبد الغفار أبو طالب
حسين أبو هيف
عبد السميع عبد السلام مبروك
5-لجنة القانون التجاري
دكتور محمد كامل ليلة ...................رئيسا
الأعضاء
الأستاذ حسين وشاحي
احمد أبو زيد الوكيل
سعد أحمد بهنساوي قناوي
عدلي عبد الشهيد
6_لجنة القوانين الاجتماعية:
الدكتور محمد محجوب........................رئيسا
الأعضاء:
الأستاذ محمد على أبو زيد
الأستاذة فايده كامل
الأستاذ أحمد محمد أبو زيد
محمود نافع
محمود أحمد سلام أبو عقيل
إسماعيل أبو المجد رضوان
أبو المكارم عبد العزيز عبد الرحيم
نشأت كامل برسوم
محمود الفران
7_لجنة القوانين المالية والاقتصادية:
الدكتور طلبة عويضة.........................رئيسا
الأستاذ حسن وزيرى السيد
مصطفى محمد سليمان
اسطفان باسيلي
محمد عامر جاب الله
شاكر السعيد قزميل
محمود محمد عبد الرحمن دبور
الشيخ صلاح أبو إسماعيل
وهذه اللجان وظيفتها النظر في المشروعات التي أنجزت وإعداد تقرير عنها بصلاحيتها أو بتعديلها حسبما ترى اللجنة الخاصة لكي يعرض على المجلس تمهيدا لإحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها واستطلاع الرأي فيها تمهيدا لعرضها على المجلس.
فهل توافقون حضراتكم على هذا التشكيل.
(موافقة).
-
ثانياً: بيان السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب عن مشروعات تقنين الشريعة الإسلامية والموجود في مضبطة الجلسة السبعين (دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث) المعقود بتاريخ الأول من يوليو 1982م.
رئيس المجلس:
الإخوة والأخوات أعضاء المجلس:
يسعدني اليوم ونحن نختتم هذه الدورة من أدوار انعقاد المجلس الموقر، أن يكون حسن الختام بفضل الله تعالى وتوفيقه عملاً خارقاً وهو إنجاز عمل تاريخي ضخم ـ إعمالاً للتعديل الدستوري للمادة الثانية من الدستور ـ التي تقضي بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
ولقد وافقتم حضراتكم بجلسة 20 يونيو 1982 على تشكيل اللجنة الخاصة واللجان الفرعية التي ستتولى تقديم مشروعات تقنيني الشريعة الإسلامية التي تم انجازها ولعل حضراتكم تذكرون ما عرضته على المجلس عن المراحل المختلفة التي مر بها هذا العمل الجليل منذ اتخذ المجلس في 17 ديسمبر سنة 1978م قراره بالبدء في تقنين الشريعة، ولست بحاجة إلى الحديث عن الجهود أو الصعوبات التي اكتنفت إعداد هذه التشريعات فحسبنا اليوم أن الأمل والرجاء قد تحولا إلى عمل جليل بناء.
إنه وإن كان الزملاء رؤساء اللجان الفرعية، سيقدمون لحضراتكم بيانا عن كل من هذه المشروعات إلا انه يجدر بي، أن أشير بادئ ي بدء إلى أن وضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق والنزول على أحكامها هو عودة بالشعب المصري، بل بالأمة العربية والإسلامية كلها إلى ذاتها العربية بعد اغتراب عشناه في ظل القوانين الأجنبية أكثر من قرن من الزمان.
إنه إنهاء للتناقض بين القيم الأخلاقية ـ نبت هذه الأرض الطيبة ـ والسياج الحضاري الذي يربط شعبنا بين القوانين الوضعية كما يتضح من النظرة الدينية والأخلاقية في شأن بعض الأعمال كالزنا وشرب الخمر والربا، وبين النظرة إليها وفقاً للقوانين الوضعية القائمة في هذا الخصوص، وما يترتب على ذلك من تمزق نفسي، بل إحباط، للتناقض بين ما يؤمن به الإنسان المصري والقوانين التي تحكمه.
ويجدر بي في هذا المقام وقبل أن أعرض للسمات والملامح الأساسية لهذه التشريعات، أن أسجل أمامكم، أن هذا العمل الذي أنجزناه إعمالاً للمادة الثانية من الدستور، قد روعي في إعداده وسيراعى في تطبيقه أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية على السواء، بمعنى أننا كلنا يعلم أن الإسلام يكفل حرية العقيدة لغير المسلمين من أهل الكتاب إعمالاً لمبدأ (لا إكراه في الدين) كما يكفل المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات إعمالاً لمبدأ (لهم ما لنا وعليهم ما علينا).
ويجدر بنا هنا أن نؤكد أن الدستور المصري قد أفرد العديد من المواد لتطبيق هذين المبدأين، ومن ذلك المادة 40 من الدستور التي نصت على أن:
(المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).
كما صت المادة 46 على أن:
(تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية).
وهذان النصان الدستوريان قاطعان وحاسمان في تقرير المبدأين الإسلاميين (لا إكراه في الدين) و
(ولأهل الكتاب ما للمسلمين ولهم ما عليهم).
وفضلاً عما سبق، فمن المسلمات أنه يتعين تفسير أي نص في الدستور بما يتفق مع باقي نصوصه وليس بمعزل عن أي منها، وهذا ما يخضع له تفسير النص المعدل للمادة الثانية من الدستور مثل باقي نصوصه كما أنه من المسلمات أيضاً أن مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء تقرر أن غير المسلمين من أهل الكتاب يخضعون في أمور أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق وغيرهما لشرائع ملتهم، وقد استقر على ذلك رأي فقهاء الشريعة منذ أقدم العصور نزولاً على ما ورد في الكتاب والسنة ولذلك روعي في التقنينات خضوع غير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية لقوانين ملتهم.
وأهم الملامح الأساسية للتقنينات الجديدة تظهر فيما يلي:
1 ـ أن هذه التقنينات مأخوذة من الشريعة الإسلامية نصاً أو مخرجة على حكم شرعي، أو أصل من أصولها وذلك دون التقيد بمذهب فقهي معين، ومن هنا استنبطت الحكام من آراء الفقهاء التي تتفق وظروف المجتمع، ولست في حاجة إلى أن اذكر لحضراتكم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:
النوع الأول: أحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهذه لا مجال للاجتهاد فيها.
النوع الثاني: أحكام اجتهادية، إما لأنها ظنية الثبوت وإما لكونها ظنية الدلالة.
ومن المسلم به بالنسبة للأحكام الاجتهادية أنها تتغير بتغير الزمان والمكان الأمر الذي أدى معه إلى تعدد المذاهب الإسلامية بل والآراء داخل المذهب الواحد، وهو ما أعطى للفقه الإسلامي مرونة وحيوية أمكن معها القول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.
2 ـ حرصت اللجان الفنية التي تولت إعداد هذه التشريعات على بيان الأصل الشرعي لكل نص من نصوص أو الأصل أو المبدأ الذي خرجت الحكم عليه حتى يكون الرجوع في التفسير والتأويل إلى مراجع الفقه الإسلامي بدلا من الالتجاء دائماً إلى الفقه الأجنبي.
3 ـ أما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية والمعاملات المالية الجديدة التي استحدثت ولم يتطرق لها فقهاء الشريعة فقد اجتهدت اللجان في استنباط الأحكام التي تتفق وظروف المجتمع وروح العصر بشرط مطابقتها لروح الشريعة الإسلامية وأصولها، ومن أمثلة ذلك معاملات البنوك والتأمينات وطرق استثمار المال...الخ.
4 ـ إنه في سبيل الحفاظ على التراث الفقهي المصري ومبادئ القضاء التي استقرت طوال القرن الماضي فقد حرصت اللجان على الأخذ بالمصطلحات القانونية المألوفة ولم تخرج عليها في الصياغة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك..
أما المضمون والمعاني فهما مطابقان للفقه الإسلامي.
والتشريعات التي تم انجازها هي:
1 ـ مشروع قانون المعاملات المدنية: ويقع في أكثر من 1000 مادة.
2 ـ مشروع قانون الإثبات: ويقع في 181 مادة.
3 ـ مشروع قانون التقاضي: ويقع في 513 مادة.
4: مشروع قانون العقوبات: القسم العام والحدود والتعزيرات: ويقع في 630 مادة.
5 ـ مشروع قانون التجارة البحرية: ويقع في 443 مادة.
6 ـ مشروع قانون التجارة: ويقع في 776 مادة.
الإخوة والأخوات:
إن هذا العمل التاريخي الذي كانت إشارة البدء فيه من مجلسكم الموقر مازال بحاجة إلى جهد جهيد يتعين أن يسعى إليه كل الذين يريدون للشريعة الازدهار، كل في مجال تخصصه وهذا يقتضينا أن نبدأ منذ الآن بما يأتي:
تهيئة المناخ الاجتماعي لقبول التقنينات الجديدة ويكون ذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وعقد جلسة استطلاع في الموضوعات التي جدت في المجتمع بعد إقفال باب الاجتهاد، وتبنت اللجنة بعض الآراء فيها مثل أعمال البنوك ونظم التأمينات ونظم استثمار الأموال. الخ.
يتعين تنظيم دورات تدريبية حتى ينفسح المجال أمام القضاة لدراسة واستيعاب التشريعات الجديدة.
يتعين تغيير برامج الدراسة في كليات الحقوق في الجامعات المصرية بما يتمشى مع التقنينات الجديدة.
بهذا يكون مجلسكم الموقر قد وفى بما وعد به في مدة تعتبر قياسية، ففي أربعين شهراً أنجز مجلسكم الموقر هذا العمل الذي سيكون خالداً بإذن الله تعالى.
وكلنا نعلم أن القانون المدني الذي صدر عام 1948 تم انجازه في أثنى عشر عاماً، وفي هذا المجلس تم انجاز خمس مجموعات كاملة خلال أربعين شهراً.
فباسمكم أقدم خالص الشكر والتقدير للإخوة أعضاء اللجان الفنية من أساتذة ومستشارين، وللإخوة الذين عملوا معهم هنا من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، على هذا الجهد الذي أتموه، بعيداً عن الضواء أو أية ضجة إعلامية، ولم يتقاضوا عليه أجراً.
فباسمكم جميعاً أقدم لهم الشكر والتقدير.
حفظ الله أمتنا وسدد خطاها على طريق العزة والنصر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثالثا: كلمة السيد العضو حافظ بدوي
رئيس لجنة القوانين الجنائية عن مشروع قانون العقوبات
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة:
إن الذي نبحثه الآن ليس أمراً عاديا ولكنه أمر يجب أن نحتفي به لأنه أمل كبير لشعبنا، ولأنه أمنية غالية لكل فرد في بلدنا، ومن وجهة نظري - وأرجو أن أكون معبراً عن أراءكم جميعاً - نحن نعتبر هذا اليوم عيداً لنا، لأنه حقق أكبر أمل لكل فرد في شعبنا، وإنني أذكر في سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين إبان وضع مشروع الدستور الدائم وكنا نجول بين أرجاء مصرنا من أقصاها إلى أقصاها, وكان النداء الأول في كل قرية من قرانا وفي كل مدينة من مدننا وفي كل مجتمع من مجتمعنا وفي كل جامعة من جامعاتنا أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً لتشريعاتنا ومن أجل ذلك نصت المادة الثانية من دستور سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين على أن ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).
وقبل التعديل الأخير وفي سنة ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين قال الأستاذ الفاضل الدكتور صوفي أبو طالب/ وكما ذكرت ليس ذلك مجاملة له، قال لقد آن الأوان ـ وهنا وفي هذا المجلس الموقر ـ لأن توضع المادة الثانية من الدستور موضع التنفيذ، واقترح ووافق المجلس على اقتراحه بأن تشكل لجان فنية لتقنين الشريعة الإسلامية الأمر الذي أجد لزاما علىّ أن أقول له شكراً وتقديراً وعرفاناً بذلك الفضل الكبير الذي سيسجله له التاريخ.
السيد الأستاذ الفاضل رئيس المجلس:
لقد وافق المجلس على تشكيل خمس لجان وكان بين هذه اللجان الخمسة لجنة لتقنين الشريعة الإسلامية خاصة بقانون العقوبات وعملت هذه اللجنة أربعين شهراً أي ثلاث سنوات ونصف، واشهد أنها عملت ليلها ونهارها وكانت مكونة من صفوة من علماء الأزهر الشريف وأساتذة الجامعات ورجال القضاء وفي مقدمتهم:
1 ـ الأستاذ الفاضل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الذي كان مفتياً لجمهورية مصر العربية في ذلك الوقت.
2 ـ الأستاذ المستشار أحمد حسن هيكل، رئيس محكمة النقض الأسبق.
3 ـ الأستاذ الدكتور محمد أنيس عبادة، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف.
4 ـ الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي، المستشار بمحكمة النقض.
5 ـ الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ قانون العقوبات بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
6 ـ الأستاذ المستشار صلاح يونس، نائب رئيس محكمة النقض.
7 ـ الأستاذ الدكتور جمال الدين محمود، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمستشار بمحكمة النقض.
8 ـ الأستاذ المستشار محمد رفيق البسطويسي، المستشار بمحكمة النقض، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
9 ـ الأستاذ المستشار مسعود سعداوي، المحامي العام لدى محكمة النقض.
كما شارك في جانب من اجتماعات هذه اللجنة السادة:
الأستاذ الدكتور محمد محي الدين عوض، نائب رئيس جامعة المنصورة.
الأستاذ الدكتور عبد العزيز عامر، الأستاذ السابق للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
الأستاذ الدكتور محمد السعيد عبد ربه، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف.
الأستاذ الدكتور محمود طنطاوي، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
الأستاذ الدكتور عبد العظيم مرسي وزير، أستاذ مساعد القانون الجنائي بحقوق المنصورة.
الأستاذ الدكتور تيمور فوزي مصطفى كامل، المستشار بمجلس الدولة.
وقد قام بأعمال أمانة اللجنة طيلة هذه الفترة وبذل جهوداً غير عادية تذكرها لهما بالتقدير الأستاذ محمد البحيري وكيل الوزارة بالمجلس والأستاذ شبل السيد بدوي الباحث الفني.
ويجدر بنا أن نشير إلى أن مشروع قانون العقوبات (ملحق رقم 19) كبير وهو مظهر مشرف ـ وأن نعرف أن الشريعة الإسلامية ليست رقاباً ولا أيدي تقطع ولكنها الرحمة والعدل والمساواة ـ يجب أن أشير إلى أن القانون الذي أعدته اللجنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتألف من:
الكتاب الأول: ويضم الأحكام العامة لقانون العقوبات.
الكتاب الثاني: ويتضمن الأحكام الخاصة بالحدود الشرعية والقصاص في النفس، والقصاص فيما دون النفس.
الكتاب الثالث: ويضم الأحكام الخاصة بالعقوبات التعزيرية.
وفيما يلي بيان موجز عن بعض الأحكام التي تضمنتها الكتب الثلاثة التي يتألف منها مشروع قانون العقوبات..
الكتاب الأول الذي يضم النظرية العامة يوضح النظرية العامة للعقوبات في الشريعة الإسلامية وهي نظرية كلها عدل ورحمة ولين وينقسم إلى سبعة أبواب بيانها على النحو التالي:
الباب الأول: ويشمل قانون العقوبات ونطاق تطبيقه من حيث الزمان والمكان.
الباب الثاني: عن الجريمة وأنواعها وقد نص في هذا الباب على أن الجرائم الحدية تعد جنايات.. أما الجرائم التعزيرية فإنها تحدد وفق العقوبة المقررة قانوناً.
كما تضمن هذا الباب أركان الجريمة وأحكام الشروع فيها أو أسباب الإباحة وموانع العقاب.
الباب الثالث: يتضمن الأحكام الخاصة بالمساهمة الجنائية والأهلية الجنائية.
الباب الرابع: ويتضمن أنواع العقوبات الأصلية والتبعية، كما يتضمن كيفية تطبيق العقوبات وأحكام العود.
الباب الخامس: يختص بتنفيذ العقوبة.
الباب السادس: ويشمل أحكام العفو عن العقوبة والعفو الشامل.
الباب السابع: يتضمن الأحكام المشتركة بين الحدود.
ويرتكز الكتاب الأول على الأسس الآتية:
التمييز بين الجرائم الحدية والجرائم التعزيرية.. ويقصد بالجرائم ابحدية وهي الجرائم الموجبة لعقوبة مقدرة شرعا على النحو الذي تتضمنه أحكام هذا المشروع، أما ما عدا ذلك فإنه يعد جريمة تعزيرية.
يقوم المشروع على أن الهدف من توقيع العقوبة هو إصلاح حال المجرم وبالتالي إصلاح حال المجتمع، كما أنه يعتمد أساساً على سياسة الأب الرحيم الذي يقسو للإصلاح ويحذر للعبرة فالعقوبات في الشريعة الإسلامية زواجر قبل الفعل روادع بعده.
الالتزام بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة.
الالتزام بمبدأ المسئولية الشخصية، إعمالاً لقول الله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة).
الأخذ بالعقوبات البدنية والتدابير، كنوع من العقوبات التعزيرية.
تقييد العقوبة حسب جسامة الجريمة وخطورة مرتكبها.
-
الكتاب الثاني ويتضمن الحدود.
ويشتمل هذا الكتاب على ثمانية أبواب
يختص كل منها بالأحكام المتعلقة بكل حد على حدة .
الباب الأول يشتمل على الأحكام المتعلقة بحد السرقة.
أما الباب الثاني فيشتمل على الأحكام الخاصة بحد الحرابة.
والباب الثالث عن حد الزنا.
والباب الرابع عن حد القذف.
والباب الخامس عن حد الشرب وتحريم الخمر.
والباب السادس عن حد الردة.
والباب السابع عن القصاص في النفس.
والباب الثامن عن القصاص فيما دون النفس.
ويحتوي كل باب من هذه البواب على تعريف الجريمة الحدية وكيفية ارتكابها وإثباتها وشروط توقيع العقوبة الحدية وكذلك شروط الإعفاء منها ودر الحد.
كما يتضمن النص على توقيع العقوبة التعزيرية المقررة في حالة عدم توافر أحد الشروط اللازمة لتوقيع العقوبة الحدية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللجنة قد رأت الأخذ بالأحكام الفقهية التي يتفق عليها جمهور الفقهاء والعلماء ولا تتعارض مع ظروف الحال في بلادنا، كما رأت أن تكون الأحكام الخاصة بالحدود واضحة حتى تتيح لكل مطلع عليها أن يتبين مقصدها دون غموض أو تجهيل.
أما الكتاب الثالث فيختص بالتعازير.
ويشتمل هذا الكتاب على أربعة عشر باباً.
الباب الأول ويختص بالجرائم الماسة بأمن الوطن الخارجي والداخلي.
الباب الثاني ويتضمن الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
الباب الثالث عن الجرائم المخلة بواجبات العمل والنيابة عن الغير.
الباب الرابع عن الجرائم الواقعة على السلطات العامة.
الباب الخامس عن الجرائم المخلة بسير العمل.
الباب السادس عن الجرائم المخلة بالثقة العامة.
الباب السابع عن الجرائم ذات الخطر والضرر العام.
الباب الثامن عن الجرائم الماسة بحرمة الأديان.
الباب التاسع عن الجرائم الواقعة على الأشخاص.
الباب العاشر عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق العلانية.
الباب الحادي عشر عن الجرائم الماسة بالاعتبار والآداب العامة واستراق السمع وإفشاء الأسرار,
الباب الثاني عشر عن الجرائم الواقعة على المال.
الباب الثالث عشر عن القمار وأوراق اليانصيب.
الباب الرابع عشر عن الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والمقلقة للراحة والمعرضة للخطر.
ويرتكز الكتاب الثالث على المبادئ التالية:
وضع عقوبة تعزيرية للجرائم الحدية التي لم تتوافر لها شروط إقامة الحد وذلك للحيلولة دون إفلات المجرم من العقاب عن جريمة اقترفها.
تجريم الأفعال التي يرى ولي الأمر ضرورة تجريمها صوناً للمجتمع وحمايته لأمنه وأمان مواطنيه وتسييراً للحياة العامة.
تجريم الأفعال التي لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة ويرى ولي الأمر أن تجريمها ضروري لكي لا تمتد يد العابثين إلى مصالح الناس وحتى يطمئن كل مواطن على يومه وغده.
وأخيراً انتهت اللجنة الفنية منذ أيام فقط وأعضاؤها هم الذين كرتهم وأستأذن في تكرار الشكر لهم لأنهم عاشوا أياماً صعبة ورغم كبر سنهم فإنهم كانوا يأتون من أقصى القاهرة إلى هذا المجلس ليؤدوا هذا الواجب الديني إرضاء لربهم ودينهم ووطنهم ولشعبهم.
لقد أنهت هذه اللجنة الفنية عملها وقدمت لنا تقريراً وافياً وأعضاؤها من صفوة العلماء والمستشارين وأساتذة القانون ومن العاملين بالكتاب والسنة في كل مكان.
وأخيراً وافق المجلس الموقر على تشكيل لجان برلمانية ومن هذه اللجان البرلمانية لجنة العقوبات التي راجعت هذه المبادئ وهذه الأحكام ورأت أنها صالحة للعرض على المجلس.
تحية لكم أيها الإخوة الأعضاء وتهنئة لكم أيضاً بأن تطبيق الشريعة الإسلامية تحقق بوجودكم في هذا المكان فحققتم أغلى أمل لهذا الشعب العظيم، حقق الله عز وجل كل آمالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
-
الدكتور صوفي أبو طالب
د. صوفي أبو طالب: مشروع تقنين الشريعة جاهز منذ 1983!
حوار - عاطف مظهر ـ إسلام أوت لاين. الثلاثاء. مايو. 22, 2007
http://www.islamonline.net/servlet/S...&ssbinary=truehttp://www.ebnmaryam.com/vb/image/gi...EAAAICRAEAOw==
https://www2.0zz0.com/2020/04/05/15/353039729.jpghttp://www.ebnmaryam.com/vb/image/gi...EAAAICRAEAOw==
صوفي أبو طالب
كشف الدكتور "صوفي أبو طالب" رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق في حوار "لإسلام أون لاين" عن مفاجآت مثيرة ومعلومات تنشر للمرة الأولى.. منها أن الرئيس الراحل أنور السادات كان هو المحرك الحقيقي لمشروع تقنين الشريعة الذي عملت فيه لجان مجلس الشعب في أواخر السبعينيات، وانتهت منه تماما في أوائل الثمانينيات.
واعتبر أبو طالب أن حادثة اغتيال السادات هي التي عطلت فعليا تطبيق قوانين الشريعة في مصر؛ لأن المشروع تم ركنه في أدراج مجلس الشعب بعد ذلك، مع عدم وجود قرار من القيادة السياسية لتفعيلها مرة أخرى.
وحول السجال الدائر عن تعديل المادة الثانية من الدستور، قال: إن أحدا أيا كان في مصر لن يستطيع الاقتراب منها لأنها في حماية الشعب؛ وأكد أن خوف بعض الأقباط من الشريعة غير مبرر؛ لأن الإسلام يكفل لهم المساواة التامة ويضمن لهم كافة حقوق المواطنة، موضحا أن رموزا وشخصيات قبطية بارزة شاركت بفاعلية في أعمال لجان التقنين، ولم يكن هناك مثل هذه النعرات المتعصبة والجديدة على طبيعة الشعب المصري.
وفي موضوع التوريث أكد أنه لا يتوقع نجاح مشروع التوريث، وقال: إن تمريره ليس بالسهولة التي يتصورها البعض؛ فهناك عراقيل قد تتسبب في فشل الخطة في اللحظات الأخيرة!!
وإلى نص الحوار:
* نلاحظ منذ فترة طويلة عزوفك عن الفعاليات السياسية والإعلامية.. فما أسباب ذلك؟ وماذا تفعل الآن؟
- بعد انتهاء فترة رئاستي لمجلس الشعب، آثرت العودة مرة أخرى لممارسة عملي الأصلي كأستاذ للقانون في جامعة القاهرة، للإسهام في تخريج أجيال جديدة من القانونيين، وفضلت الابتعاد تماما عن العمل السياسي؛ لأن لكل فترة رجالها، وأنا أشعر أنني قد أديت دوري السياسي بقدر المستطاع.
* عاصرت حقبتي السادات ومبارك، وكنت من الرموز المشاركة في مؤسسة الحكم في كلا العهدين.. فما الفروق السياسية التي لاحظتها بين الرجلين؟
- هناك بالطبع فروق واضحة وملموسة تتبدى في نوعية القرارات السياسية المتخذة، وكيفية التفاعل مع الأحداث، ولكن هناك أيضا سمات مشتركة تجمع بينهما، فيجب ألا ننسى أن الرجلين كليهما جاءا من معينٍ واحد(!!).
**مشروع تقنين الشريعة "مركون" في أدراج مجلس الشعب وجاهز للتطبيق منذ عام 1983
* كنت أحد الداعين لتطبيق الشريعة الإسلامية، وتبنيت خلال فترة رئاستك لمجلس الشعب مشروعا لتقنين الشريعة.. فما أسباب حماسك الشديد لهذا الأمر؟
- نعم كنت وما زلت من الداعين لتطبيق الشريعة، حتى نعود لذاتنا وهويتنا، والعودة للشريعة ليس ترفا، بل هو وضع للأمور في نصابها وضرورة للنهضة والتقدم التي لا تقوم إلا على الوحدة بين المسلمين، ولن يتوحد المسلمون إلا تحت راية الإسلام والشريعة، وعندما ابتعدنا عن هذه الراية والمظلة الموحدة للصف الإسلامي تفرقنا شيعا وأحزابا وطوائف، وبدأنا نتعارك مع بعضنا ولم نعتصم بحبل الله جميعاً كما أمرنا المولى سبحانه وتعالى.
كما أنها مطلب عزيز لغالبية الشعب، وهذه حقيقة لا يجادل فيها أحد ولا ينكرها إلا جاحد أو جهول، فلكل شعب خصائص تميزه، ولكل حضارة في الدنيا جانبها المعنوي الذي يمثل خصوصيتها، ويشمل اللغة والفنون والثقافة بصفة عامة بما فيها الدين، والأمة التي تتخلى عن الجانب المعنوي لحضارتها تذوب في الأمة التي تنقل عنها..
انظر إلى دستور الاتحاد الأوروبي وتأكيده على أن الحضارة الأوروبية الحديثة هي امتداد للحضارة الرومانية، وينص على أن المشرع الأوروبي يجب أن يستلهم فيما يصدره من تشريعات وقوانين مبادئ وقيم الحضارة الكلاسيكية، أي الفلسفة الإغريقية والقانون الروماني، وعليه ألا يخرج عنهما.. فلماذا يستكثرون علينا هذا الأمر؟!.
* البعض يتساءل عن الفائدة العملية لتطبيق الشريعة، ويقولون إن القوانين الوضعية والاتفاقات والمعاهدات الدولية فيها الكفاية.. فما تقييمك لهذا الكلام؟
- الفائدة أن نحقق الاستقلال القانوني والقضائي حتى يتفاعل الناس مع القوانين ولا يلقون بها وراء ظهورهم ويتحايلون من أجل عدم تطبيقها فتشيع الفوضى.. وسأضرب لك مثلا على ذلك: كان هناك نص في القانون المدني الذي صدر عام 1883 يقول بأن على الزوجة أن تنفق على زوجها وحماتها وأخت زوجها.. ومن وضع هذا النص نقل نقلاً أعمى عن القانون الفرنسي والقانون الروماني، فبقي غير مطبق لأنه بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا.. فالقانون مرآة المجتمع.
وميزة الشريعة أن الجميع سيلتزم بها في السر والعلن، لأنها من عند الله تعالى، بخلاف القانون الوضعي الذي يلتزم به الناس خوفاً من العقوبة الدنيوية، فإذا استطاع أن يفلت من تلك العقوبة فلن يلتزم به ولن يطبقه، والدليل على ذلك أن هناك بعض مقاولي البناء الذين يغشون في كميات ونسب مواد البناء لتحقيق أكبر مكاسب مادية ممكنة، وقد تسقط العمارات التي يقومون ببنائها بسبب ذلك، ولكننا نجد نفس المقاول يحرص على أداء العمرة والحج مرات ومرات ودفع الزكاة، فهو يعتبر الغش والتحايل على القانون الوضعي شطارة، أما الحج والعمرة ودفع الزكاة فهي تغفر الذنوب وأوامر شرعية وليست وضعية.
**عدم تطبيق تقنينات الشريعة الآن يرجع لعدم رغبة القيادة السياسية في مصر.. والأغرب هو عدم تقدم عضو واحد بطلب إخراج المشروع من أدراج المجلس طيلة هذه السنوات(!!) ..
* لكن هناك من يعترض على مفهوم تقنين الشريعة زاعما أن الشريعة موجودة في كتب الفقه.. فهل الشريعة تحتاج فعلا إلى تقنين؟
- بالفعل الشريعة تحتاج إلى التقنين لأن فيها آراء متعددة، وتعدد الآراء جاء إثراء للشريعة، فمثلا كان سن الحضانة في الماضي ينتهي عند بلوغ الصبي سبع سنين والبنت تسع سنين لأن كليهما يستغني عن خدمة أبويه في هذه السن، وهذا ما قال به المذهب الحنفي.
وفي أيامنا هذه امتد سن الحضانة حتى التخرج من الجامعة، بسبب تغير وتبدل ظروف الحياة، وهذا هو معنى تغير الأحكام بتغير الزمان.. الأمر الذي يبرر الحاجة إلى اجتهاد جديد واستنباط أحكام فقهية تناسب العصر، كما أن اختلافات المذاهب الفقهية نفسها سهلت علينا العمل لتوحيد المسائل الفقهية والقانونية، وإدماجها في المنظومة القانونية السارية وصياغتها في مواد قانونية عامة.
* تربط دائما في كلامك بين الشأن السياسي والجانب التشريعي الذي تعتبره مؤشرا على استقلال القرار الوطني.. فهل المسألة برأيك تحتاج إلى هذا الربط؟
- طوال 14 قرنا كانت الشريعة هي الحاكمة في جميع بلاد المسلمين وعلى كافة المواطنين مسلمين وغير مسلمين، وطنيين وأجانب إلى أن جاء القرن التاسع عشر الميلادي فتغيرت الظروف والأوضاع بقدوم الاستعمار الأوروبي إلى بلادنا، وجرى تنصيب حكام جاءوا بإرادة واختيار المستعمر، فبات همهم وواجبهم الأول البقاء في الحكم بأي طريقة كانت، وحاولوا إرضاء القوى الأجنبية بإبعاد الشريعة عن التطبيق حتى نتشبه بأوروبا.
وإذا لم يكن الحاكم الذي يحكم الدولة الإسلامية في ظل الاستعمار الأوروبي (خواجة) فإن المستشار الخاص به غالباً ما كان (خواجة أوروبي) يشير عليه باستبعاد الشريعة من التحاكم إليها وينصحه باستخدام القوانين الأوروبية.. هذا التحول من التطبيق الكامل للشريعة على مدى القرون الماضية إلى إحلال القوانين الأوروبية محل الشريعة لم يحدث إلا في القرن التاسع عشر رغم رفض الناس لهذه القوانين المستوردة.
ومع تنامي شعور الوطنية تم النص في أول دستور للبلاد عام 1923 على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام.. وفي دستور عام 1971 تغير النص إلى أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع. وفي عام 1980 جرى استفتاء شعبي لتعديل المادة الثانية وجعل الشريعة من مصدر رئيسي للتشريع إلى (المصدر الرئيسي للتشريع) من باب استجلاء النص وتأكيده، وكان هذا كله نتيجة ضغوط شعبية، وقد كتبت في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة بخط يدي أنه في حالة عدم وجود نص في الشريعة، نأخذ من القوانين الأخرى بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أرادت مصر بذلك أن تعود إلى وجهها الإسلامي، فتم تشكيل لجنة لتقنين الشريعة الإسلامية، وكنت رئيسا لها منذ توليتي رئاسة مجلس الشعب في السبعينيات.
* هناك تصريح منشور لوزير الأوقاف الأسبق الشيخ "إبراهيم الدسوقي" في أحد اجتماعات لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب عام 1982 أكد فيه أنه تم الانتهاء من 95% من قوانين الشريعة ويجري العمل على الانتهاء من النسبة المتبقية، هذا الكلام قيل منذ 25 عاما.. فلماذا لم نسمع عنه شيئا بعد ذلك؟
- لقد بدأنا العمل الفعلي للتقنين في عام 1978 وقمنا بالاستعانة بصفوة من العلماء المتخصصين من الأزهر والقضاة وأساتذة كليات الحقوق وبعض الخبراء من المسلمين والمسيحيين، وقسمنا العمل إلى لجان يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس الشعب إلى جانب هؤلاء الخبراء. وكانت الخطة تقوم على عدم التقيد بالراجح في مذهب معين، بل الأخذ بالرأي المناسب من أي مذهب من المذاهب الفقهية.
وشرعنا في التقنين على أبواب الفقه وتقسيماته، وما لم نجده في كتب الفقه نلجأ إلى مقاصد الشريعة في استنباط الأحكام، وفي حالة تعدد الآراء الفقهية للمسألة الواحدة نختار واحداً منها مع ذكر الآراء الأخرى ومصادرها على هامش الصفحة ليرجع إليها من يشاء.
ومع حلول عام 1983 تم الانتهاء من جميع أعمال التقنين، وقمنا بطباعتها وعرضها على مجلس الشعب، وحظي بالموافقة عليه بالإجماع من أعضاء المجلس المسلمين والمسيحيين.. ومضابط المجلس مازالت موجودة وثابتة، وتشير إلى مدى تحمس المسيحيين لتطبيق الشريعة الإسلامية.
* هل يعني هذا الكلام أن مشروع تقنين الشريعة كانت تتبناه مجموعة أفراد في السلطة.. أم كان مشروعا للدولة المصرية؟
- الوصف الأدق له أنه كان مشروعا يساير (توجه) الدولة، وليس (مشروعا) للدولة، لأنه توقف بالفعل بعد أن غيرت الدولة سياستها منه!!، ولأن الدولة أحيانا إذا أرادت شيئا تجعل أحد أعضاء المجلس يقدم الاقتراح بقانون بإيعاز منها وبالنيابة عنها، وكان الرئيس السادات في كل الاجتماعات يحثنا على الإسراع لإنجاز مشروع التقنين.. وكان يطالبنا بعدم الانتظار حتى يكتمل تقنين كل القوانين، واقترح مرة أن ندفع بما ننجزه أولا بأول إلى مجلس الشعب لأخذ الموافقة عليه تمهيدا لتطبيقه وسريانه في المنظومة القانونية.
* هذا كلام جديد على الناس.. فهل كان السادات جادا فعلا في هذا الشأن وينوي تطبيق الشريعة في مصر؟ وهل أجهض حادث اغتياله تحقيق هذا المشروع؟
- استطيع أن أجزم أن الرئيس السادات (رحمه الله) كان جادا في مسألة تطبيق الشريعة، وكان سلوكه وكلامه يقطعان بذلك.. ولو قدرت له الحياة عاما أو عامين آخرين لرأينا تقنين الشريعة مطبقا على أرض الواقع.
أما بخصوص حادثة اغتياله، فلا أنا ولا أنت نعرف الجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة (!!!).
**طبعنا آلاف النسخ من أعمال التقنين ووزعناها على مكتبات الجامعات والمراكز البحثية وعلى كبار الشخصيات... لكنها اختفت فجأة بطريقة غامضة.!!.
* ما الذي حدث بعد اغتيال السادات وأوقف تطبيق أحكام الشريعة التي قمتم بتقنينها؟
- هذه قصة كبيرة.. ولكن باختصار يوجد في لائحة مجلس الشعب ما يسمى بمشروع القانون وهو الذي تقدمه الدولة، واقتراح بقانون وهو الذي يقدمه عضو المجلس من خلال لجنة الاقتراحات والشكاوى التي تحكم على مدى صلاحيته. ولأن الاقتراح بتقنين الشريعة لم يكن مشروعا مقدما من الحكومة إنما تم تقديمه من جانبنا باعتباري رئيسا لمجلس الشعب؛ وبالتالي هذا الاقتراح بتعديل القوانين القائمة وتغييرها بأحكام الشريعة كان لا بد من موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه، وتمت الموافقة وأحيل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس وبدأت اللجنة التشريعية في دراسته ومرت سنة ولم ينته فيه الرأي بالرفض أو القبول إلى أن انتهى الفصل التشريعي.
وطبقاً للائحة يسقط الاقتراح بانتهاء الفصل التشريعي للمجلس وينبغي تقديمه من جديد ولم يتقدم أحد بالمشروع مرة أخرى عقب خروجي عام 1983 من المجلس.. وأذكر أن رئيس المجلس الدكتور رفعت المحجوب قال لي إنه ليس لديه مشروع قانون أو اقتراح بقانون إنما ما لديه هو أوراق مكتوبة!!.
* ولماذا لم يقم أحد أعضاء المجلس بتقديم طلب جديد حتى تأخذ قوانين الشريعة دورتها ويتم المصادقة عليها من مجلس الشعب.. وهل كان هناك قرار من القيادة السياسية بإيقاف هذا المشروع؟
- للأسف لم يتقدم أحد من أعضاء المجلس بتقديم اقتراح بقانون لإقرار قوانين الشريعة.. وقد سألت الدكتور رفعت المحجوب في ذلك الوقت، وكانت إجابته أن الظروف السياسية والوضع العام لا يسمحان بذلك، وهذا معناه أن القيادة السياسية لا ترغب في الموضوع(!!)، وظلت القوانين في أدراج المجلس حتى الآن منذ عام 1983.
لكن الأغرب من ذلك أن كثيرين من الغيورين والراغبين في تطبيق الشريعة من أعضاء المجلس جاءوني، فقلت لهم تقدموا أنتم باقتراح بقانون، ونرى ماذا يفعلون، لكن أحدا منهم لم يتقدم.. والأشد غرابة أننا طبعنا آلاف النسخ من هذا التقنين، وقمنا بتوزيعها على مكتبات الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب أساتذة كليات الحقوق والقضاة العاملين بالمحاكم والصحافة وكبار الشخصيات، وكل من له اهتمام بالموضوع، لكنها اختفت كلها بطريقة غامضة بيد جهة مجهولة!!.
* هل توجد بالفعل ضغوط خارجية لتعطيل مشروع تقنين الشريعة.. أم أنه قرار داخلي برأيك؟
- الأمور متداخلة وغير واضحة أمامي.. والقرار السياسي قد يتأثر بكلا العاملين معا؛ فالدولة كانت تساعد، وفجأة توقف الموضوع، وقد حدث أمران خارجيان قد يكونان السبب في التعطيل: الأول الثورة الإيرانية عام 1979 وتهديدات إيران بتصدير الثورة، والبعض فهم أن تطبيق الشريعة سيجعل مصر إمارة إسلامية..
والحدث الثاني وهو تطبيق الشريعة في السودان وكان هذا محل جدل بيني وبين النميري رئيس السودان، فقد أخذ بالمبادئ والأحكام المتطرفة في محاولة لتقنين الشريعة وتطبيقها.. مثل رأي الإمام مالك الذي يحرم شرب الخمر على الإطلاق، في حين أن رأي أبي حنيفة يسمح بشرب الخمر لغير المسلمين طالما أن دينهم يسمح بذلك ومعلوم أن أبناء الجنوب يشربون الخمر، وكان ذلك سببا لإشعال التمرد ضده وتدخل مجلس الكنائس العالمي وانتهى الأمر بالانقلاب عليه.
* هل نوعية أعضاء مجلس الشعب في الثمانينيات لعبت دورا في دفع مشروع تقنين الشريعة للأمام.. وما الفرق بينهم وبين أعضاء مجلس الشعب اليوم؟
- بالطبع فقد كان المجلس يضم مجموعة متميزة من الأعضاء المميزين.. أذكر منهم الشيخ صلاح أبو إسماعيل والمستشار ممتاز نصار وغيرهم.. أما الآن فقد دخل عدد من الأعضاء المجلس "بفلوسهم" وهم يريدون فقط استعادة هذه الفلوس أو زيادتها!!.
* ما رأيك في زعم البعض من أن إقدام السادات على الإفراج عن الإسلاميين المعتقلين وإعطائهم الحرية كان للتخلص من اليساريين؟
- هذا الكلام غير صحيح بالمرة وهي شائعات مختلقة، فالسادات أطلق سراح الإسلاميين المعتقلين وحررهم من القيود التي كانوا فيها بعد أن كان اليسار مسيطرا تماما على الساحة.. كل ما في الأمر أنه سمح لهم بالتمتع بحقوق المواطنة المسلوبة منهم كنوع من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ولأن اليساريين ليس لهم وزن في الشارع أطلقوا مثل هذه الأكاذيب المغلوطة.
* وما رأيك في السجال الدائر الآن ومطالبة البعض بتغيير المادة الثانية من الدستور؟.. وهل يمكن أن يحدث ذلك؟
- أشك كثيرا في أن يحقق المطالبون بتغيير المادة الثانية هدفهم؛ لأن اليسار لا حياة ولا مستقبل له في مصر، وزعماء هذا التيار معزولون عن الناس، وهناك حقيقة لا بد من التأكيد عليها وهي أن الابتعاد عن الدين في مصر خطر وخطأ.. لأن الشعب المصري متدين بطبيعته، والتيار العلماني الذي يدعو لفصل الدين عن الدولة -كما حدث في تركيا- هو أيضا لا حياة ولا مستقبل له في مصر.
* ولكن هل يمكن أن تُعقد صفقة ما مع السلطة تفضي إلى تغيير المادة الثانية والإجهاز عليها؟
- لا يمكن هذا أيضا لأنهم لن يجدوا عضواً واحداً يساير هذا الاتجاه، ولعل ما حدث مؤخرا من هجوم وانتقادات حادة ضد وزير الثقافة بسبب تصريحاته حول موضوع الحجاب وقيام أعضاء من الحزب الوطني بقيادة هذا الهجوم مما يؤكد ذلك، كما أن مؤسسة الرئاسة ليس في مصلحتها تبني هذا الاتجاه والاصطدام مع مشاعر الناس.
* ولكن مع تزايد الضغوط من جانب العلمانيين واليساريين، بل ومن الأمريكان، قد ترضخ الدولة وتقوم بتغيير تلك المادة؟
- ضغوط العلمانيين واليساريين لا قيمة لها.. كما أن الإدارة الأمريكية غارقة في المشاكل وهي ليست على استعداد للتورط أكثر بإدخال نفسها في هذا الأمر.
* يقول العلمانيون في معرض رفضهم للمادة الثانية إن الدولة كيان محايد، لا ينبغي وصفه بالإسلامي أو الكونفشيوسي أو البوذي أو أي صفة أخرى، حتى تحقق مبدأ المواطنة.. فما رأيكم في هذا الطرح؟
- هؤلاء يتكلمون وفق مفاهيم غربية مقطوعة الصلة بخصوصيتنا وهويتنا.. فهم لا يدركون أن هناك فروقا محددة تفصل بين الدين والكهنوت، فأوروبا اليوم تفصل بين الدولة والدين بمفهومه الأوروبي (الكهنوتي).. بينما الإسلام يجمع بين الدين والدولة ولا يوجد فيه كهنوت.
وحين نصف الدولة بأنها إسلامية فإن ذلك يعني أنها تستمد ثقافتها وتشريعاتها من تراثها الإسلامي، وهذا التراث شارك في وضعه المسلمون وغير المسلمين، وعليه فإن النص على أن دين الدولة هو الإسلام هو الذي يضمن لغير المسلمين حقوقهم ويجعله واجبا شرعيا وليس مجرد نصوص قانونية وضعية يسهل التلاعب بها والخروج عليها.
**لن يستطيع أحد أيا كان في مصر تغيير المادة الثانية من الدستور لأنها في حماية الشعب.
* لو ألغينا المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.. فما المصدر البديل الذي نستقي منه القوانين؟
- لن يكون أمامنا في هذه الحالة إلا القوانين الوضعية الغربية المستمدة من القانون الروماني متمثلة في التشريعات الفرنسية والإيطالية والإسبانية.. فكأننا نتخلى عن هويتنا واستقلالنا القضائي والقانوني لصالح قوانين الدول التي احتلت بلادنا ونهبت ثرواتنا.
ومن يقولون بأن المرجعية الدولية المتمثلة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تكفي بديلاً عن الشريعة الإسلامية، نرد عليهم بأن هذه الاتفاقات والمعاهدات التي تصدر عن الأمم المتحدة تعبر عن فلسفة مادية غربية لا تتناسب مع ثقافتنا، ومن يراهنون على تلك المعاهدات لتوفير حقوق المواطنة في البلدان العربية والإسلامية، نسألهم: وهل ساوت المجتمعات الأوروبية والأمريكية بين المواطنين فيها!!.. أليس هناك تمييز عنصري وتهميش للمسلمين المقيمين في الغرب؟.. ألم تسمح تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية بزواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة فهل نأخذ بهذه القوانين ونرفض الشريعة؟!.
* ثمة تكهنات تقول إن إدخال مادة المواطنة يستهدف إلغاء المادة الثانية فما رأيكم؟
- من يطلق هذا الكلام يفهم المواطنة على أنها استبعاد للشريعة وإلغاء للمادة الثانية، وينسى أن المواطنة كحقوق وواجبات هي مفهوم إسلامي وإن كانت كمصطلح أصلها إغريقي، والإسلام أقام أول دولة على مبدأ المواطنة والمساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن دينهم أو لونهم وهي دولة المدينة التي وضع دستورها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سمي (الصحيفة) وهي أول دستور يحدد حقوق وواجبات المواطنين ويساوي بينهم، على عكس الوضع الذي كان سائداً في أوروبا حيث القانون ينص على أن الناس على دين ملوكهم، وإلا فلا حق لمن يخالف ذلك في المواطنة والحقوق المترتبة عليها.
* هناك من يزعم بأن تطبيق الشريعة ينتقص من حقوق المسيحيين؟
- هذا كلام يمزج بين الخطأ والجهل؛ لأن الشريعة الإسلامية التي طبقت على مدى قرون طويلة من الزمان أنصفت غير المسلمين في البلاد الإسلامية بأكثر مما فعلت أي حضارة أخرى في العالم؛ ويكفي تلك القاعدة الذهبية التي تجسد حقوق المواطنة لكل من يقيم في البلدان الإسلامية (لهم ما لنا وعليهم ما علينا).
* ولكن بعض المسيحيين يبدون تخوفات ويثيرون اعتراضات تستند على حجج تبدو منطقية.. فكيف تنظرون إليها؟
- هذا الموضوع كان مثار نقاش بيني وبين البابا شنودة، الذي أبدى تخوفه من بضعة أمور: منها شهادة غير المسلم على المسلم، وقضاء غير المسلم على المسلم، وهو مبدأ مطبق حاليا في القضاء المصري، ويستند على رأي الإمام أبي حنيفة الذي أجاز ذلك.. وكان تخوف البابا شنودة من أن يأتي حاكم يأخذ بالرأي الآخر الذي لا يبيح ذلك، فقلت له إن هذا لو حدث فسيكون كارثة على الجميع، المسيحي والمسلم على السواء(!!).
* سمعنا مؤخرا من يطالب بمعادلة المادة الثانية للدستور وتضمينها نصاً يضيف الشريعة المسيحية كمصدر للتشريع للإخوة المسيحيين كنوع من الترضية لهم؟
- المسيحية ديانة سماوية عظيمة، ولكن ليس فيها شريعة تنظم حياة البشر كما هو الحال في الإسلام.. فالمسيح عليه السلام كان يردد "مملكتي ليست هنا إنما في السماء" وأعلى درجات الكمال عند المسيحي، هي الرهبنة.
أما الإسلام فهو عقيدة وشريعة ودين ودولة، ووقت ظهور المسيحية كان هناك قانون بلغ أعلى درجات كماله، وهو القانون الروماني؛ فالناس في ذلك الوقت لم يكونوا في حاجة إلى حماية قانونية.. ولكنهم كانوا في حاجة إلى هداية روحية وأخلاقية فجاءت المسيحية لتعويض هذا النقص.
وحين جاء الإسلام لم يغرق في التفاصيل كما فعلت الشريعة اليهودية؛ لأن اليهودية هي أيضاً عقيدة وشريعة، ولأن الشريعة التي جاء بها الإسلام هي خاتم الرسالات السماوية فقد سمح بالاجتهاد فيما لا نص فيه.. فالقرآن الكريم يقول (أحل الله البيع) وترك عملية البيع بدون تفاصيل ليسمح مع تقدم العصور بأنواع من البيع لم تكن موجودة زمن نزول الرسالة.
ووضع الفقهاء قاعدة ذهبية تقول (تتغير الأحكام بتغير الزمان).. وهذا الزمان يتضمن المعنى الفلكي والمكاني الثقافي، وهي قاعدة تفتح الباب واسعاً للاجتهاد بشروطه فيما لا نص فيه من القرآن الكريم والسنة النبوية.
المرجع
http://www.islamonline.net/servlet/S...ah%2FSRALayout
-
الفصل الرابع
تأصيلُ القواعد القانونيّةِ في الآيات القرآنيّةِ
من سورتي البقرة ويوسف
مقدمة
ماذا يعني تطبيق الشريعة الإسلامية؟..
هناك فارق كبير بين التطبيق والتدوين.. فمرحلة التدوين - أي تدوين الشريعة- سابقة بداهة عن التطبيق، وتستلزم جهداً كبيراً من العلماء والفقهاء وجهابذة القانون وكل منهم متخصص في فرع من فروع القانون سواء الجنائي أو المدني أو الاقتصادي أو الدولي..
ومرحلة التطبيق يسبقها مرحلة الإعداد - أي إعداد المجتمع لتقبل هذه القوانين ومعه دول الجوار- وهذه هي أصعب المراحل..
وعليه فإن تدوين الشريعة الإسلامية في صورة قوانين ومواد وشروحات ليست بالأمر الهين..
بالرغم من تمايز الشرائع ما بين شريعة سماوية وأخرى بشرية، فان قاسم الشرائع جميعها منصب على خلق النظام في صفوف المجتمع الواحد أو الطائفة أو الأمة، ولكن ما يميز شريعة الإسلام الخاتم لجميع الأديان السماوية، عن غيره، أنها شريعة متكاملة ومتطورة ومواكبة لتحولات العصور والدهور، ومنسجمة تماما مع ناموس الحياة والكون، لا يعجز الفقيه الحاذق من إيجاد الفتوى والرأي الفقهي من بين ثنايا نصوص القرآن الكريم والسنّة الشريفة، للمرونة المتوفرة في الفقه الإسلامي والسعة القانونية التي تتصف بها شريعة الإسلام، ما جعلها قائمة إلى يومنا هذا، وتنعقد عليها العشرات من الحكومات والإمبراطوريات، وتتصدر المادة الأولى من دستور أية دولة، بغض النظر عن حجم التطبيق والممارسة.
ولبيان معالم التشريع الإسلامي ومصادره، وقراءة معرفية لأصوله لدى المذاهب الإسلامية المختلفة..
والفقه الإسلامي بمرونته وحيويته قادر على حلّ كل المشكلات مهما تجددت الحوادث وتشعبت مذاهب الحياة فيها، وهذا يعود إلى طبيعة الشرع الإسلامي المتجدد بذاته، والى باب الاجتهاد المفتوح أمام الفقهاء العدول للبت في مستحدثات الحياة، فيما لا نص فيه، قطعيا في صدوره كان أو ظنيا.
ولأن مصادر التشريع تشعبت بمرور الزمن، فكثيرا ما تلتقي المذاهب الإسلامية في أمور وتختلف في غيرها، وذلك لأن مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة لم تنتظم في سلك واحد لدى الفقهاء جميعاً، فمنهم من عمل ببعضها ومنهم من أخذ بغيرها.
الفرق بين الشريعة والفقه.
فالتشريع هو الدين بنصه وحكمه وآياته وتنزيله.. وأما الفقه، فهو فهمنا للدين، وقدرتنا على إتباعه، والاستفادة من أدلته.
فالفقيه إذن ليس مشرعا بذاته، وإنما فاهماً وشارحاً ومفسراً ومبيناً لأمور الشرع.
وهؤلاء الفقهاء وان استقلوا بفتاواهم أو علومهم، فإنهم يأخذون عن غيرهم من العلماء، ومن هنا كنت تجد العلماء يعتمدون نصوص بعضهم ويتتلمذ الواحد منهم على الآخر، حتى قال الشافعي رحمه الله (كلنا عيال على أبي حنيفة)".
وصح تواتر القول عن الإمام أبي حنيفة النعمان: (لولا السنتان لهلك النعمان)، وهو بذلك يشير إلى السنتين اللتين جلس فيهما يأخذ العلم عن الإمام جعفر بن محمد الصادق.
ولكن هل يصدق القول على كل من لبس العمة والجبة، أو من أطال اللحية وقصر الجلباب أنه دخل سلك الفقهاء وصار منهم؟.مستحيل..
إن الفقيه هو من أتقن علوم الدين من كتاب وسنة وتفسير وعقيدة ولغة، وأصبحت لديه الملكة المؤهلة للخوض والاجتهاد في أمور الدين.. وعلى هذا فيمكننا أن نحدد أن الفقيه من استطاع أن يستنبط الأحكام ليقرّب أمور الدنيا من أمور الدين، وجعل أمور الدنيا ومستجداتها تدور في دائرة الشرع ولا تخرج عنها مستعينا بما يملك من إمكانيات ووسائل تعينه في ذلك، وعليه فان مصالح الناس، هي محور عمل الفقيه واجتهاده، والتي يستمدها من مصادر التشريع.. فإذا وصل الفقيه إلى هذه المرتبة عندئذ يطلق عليه مجتهدا.
ومن ثم فإن "مصادر التشريع" بأنها: "السبل التي يستخدمها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية، ويعتمد عليها في الوصول إلى مبتغاه".
وبالطبع ليست الأحكام كلها، لأنه في الشريعة الإسلامية وربما في غيرها ثوابت ومتغيرات وإن شئت فسمّها بالساكن والمتحرك، فهناك ضرورات لا تطالها يد الاجتهاد، وهي التي تشمل جميع الأحكام المبينة من المحكمات وما ورد فيه نص إلهي أو نص نبوي أو نص إمام من الأئمة الأربعة، مما لا خلاف عليه فلا يمكن تعديه..
هذا هو الثابت من الشريعة وما تبقى خارج هذه الدائرة فهو المتحرك من هذه الشريعة، والمتغير من القانون، حيث تُرك المجال مفتوحاً أمام الفقيه أو الحاكم ليملأه حسب الحاجة طبقا للكتاب والسنة.
على أن الفقيه يبحث في التشريع المختص بالأحكام الشرعية لا العقائدية، لان موضوع التشريع هو الفقه وليس الكلام.
كما أن للتشريع مادتين أساسيتين وهما: القرآن الكريم والسنّة النبوية، ووقع الخلاف بين المذاهب الإسلامية، في أربعة عشر موردا، وهي: الإجماع، العقل، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، فتح الذرائع وسدّها، العرف، شرع مّن قبلنا، مذهب الصحابي، القرعة، الحيل الشرعية، الشهرة، السيرة، والأصول العملية.
أصول الشريعة المتفق عليها:
التشريع أو الفقه الإسلامي هو مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله عباده بها، ومصادره أربعة وهي التالية:
1ـ القرآن الكريم:
وهو كلام الله تعالى وهو المصدر والمرجع لأحكام الفقه الإسلامي، فإذا عرضت لنا مسألة رجعنا قبل كل شيء إلى كتاب الله عز وجل لنبحث عن حكمها فيه، فإن وجدنا فيه الحكم أخذنا به، ولم نرجع إلى غيره. ولكن القرآن لم يقصد بآياته كل جزئيات المسائل وتبيين أحكامها والنص عليها، وإنما نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلاً، والعبادات والمعاملات إجمالاً ورسم الخطوط العامة لحياة المسلمين، وجعل تفصيل ذلك للسنة النبوية. فمثلاً: أمَرَ القرآن بالصلاة، ولم يبين كيفياتها، ولا عدد ركعاتها. لذلك كان القرآن مرتبطاً بالسنة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة وتفصيل ما فيه من المسائل المجملة.
2ـ السُنَّة النبوية:
وهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وتُعَدُّ في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، شريطة أن تكون ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، والعمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن والعمل به.
3ـ الإجماع:
هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق هؤلاء العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا عليه كان حقاً.
روى أحمد في مسنده عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سألتُ الله عز وجل أن لا يَجمَعَ أمَّتي على ضلالةٍ فأعطانيها ".
والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحكم في القرآن، ولا في السنة، نظرنا هل أجمع علماء المسلمين عليه، فإن وجدنا ذلك أخذنا وعملنا به.
مثاله، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب.
4- القياس:
وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما.
وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. فالقياس إذاً في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليه.
أركان القياس أربعة: أصل مقيس عليه، وفرع مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع.
ودليله قوله عز وجل: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، أي لا تجمدوا أمام مسألة ما، بل قيسوا وقائعكم الآتية على سنَّة الله الماضية. وروى مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ".
وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسله رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم إلى اليمن ليُعَلِّمَ الناس دينهم، فقال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أقيس الأمور بمشبهاتها ( وهذا هو الاجتهاد )، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه سروراً: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله، وفي رواية أخرى قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو (أي أجتهد و لا أترك).
مثاله: إن الله تعالى حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، والعلة في تحريمه: هي أنه مسكر يُذهِب العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه قياساً على الخمر، لأن علة التحريم -وهي الإسكار- موجودة في هذا الشراب؛ فيكون حراماً قياساً على الخمر.
الأصول المختلف عليها:
1ـ الإجماع، الذي يعني عند أهل اللغة، الاتفاق، وعند أهل الفقه والأصول هو اتفاق الأمة أو الصحابة أو العلماء، فالإجماع بالإجمال أسلوب حضاري سبق المسلمون غيرهم إلى الأخذ بآراء أرباب العلم.
وبعيدا عن الخلافات حول متعلق الإجماع فانه بالإجمال حجة عند جميع المذاهب وهو أحد الأصول المعتمدة في التشريع"، على إنه ليس أصلا بذاته.
2ـ العقل، وهو الذي يوصف بأنه: القوة التي يدرك بها الإنسان ويحكم من خلالها على مدركاتها، وإنما سمي بالعقل لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك". وعليه فيجب على الفقيه المجتهد الجامع للشرائط أن يتحلى بعقلية قريبة من الفطرة الإنسانية والواقع المعاش والمذاق الإسلامي، بلحاظ أن للبيئة تأثيرا على نمط الفتوى والحكم وهذه النظرية جديرة بالاهتمام حيث أنها تتوافق مع صلب الإسلام من جهة، كما والتطور الاجتماعي وكلّ ملابساته من جهة أخرى.
3ـ القياس: والذي وردت فيه تعريفات عدة، والذي يعني فيما يعني التعرف على حكم النظير من خلال علة مظنونة في نظيره، وفيما إذا لم يرد بذلك الحكم نص من الكتاب والسنة. على إن القياس واحد من الأصول المتنازع عليها بين المذاهب.
4ـ الاستحسان: وهو عد الشيء حسناً، مع اختلاف الفقهاء الأصوليين في تعريفه والاستدلال عليه، فان: "الاستحسان: في الواقع لا يغني عن الحق شيئاً وانه مجرد عد الشيء حسناً كما عرّفه اللغويون وهذا هو الرأي بعينه وربما أضاف بعضهم بعض الشروط ليقيدها بما يلائم القواعد الأصولية". وهو لا يعد دليلا في قبال الكتاب والسنة والعقل والإجماع.
5ـ المصالح المرسلة: المصطلح مركب من كلمتين: المصالح وهي جمع المصلحة وتعني كل ما في فعله أو تركه منفعة، والمرسلة، وهي مؤنث المرسل وهو الذي لم يحدد ولم يقيد.
والمصالح المرسلة: إما مردّها إلى الدليل العقلي أو إلى النص الإلهي أو النبوي، فلا معنى لعدها دليلا مستقلا ووصفها في قبال الكتاب والسنة والعقل، وأما إن كان خلفيتها الرأي والقياس وما إلى ذلك فهو مرفوض.
6ـ الذرائع: أو سد الذرائع وفتحها، أي بمعنى الوسيلة، كما أنها ليست أصلا برأسها.
7ـ العُرف: الذي يعني في اللغة: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
ويعنى في الأصول: ما تبناه المجتمع من دون إنكار. كما أن العرف ليس أصلا برأسه ليضاهي الكتاب والسنة بل مآله إما إلى العقل أو إلى السنة.
8 ـ الشرائع السابقة: أو ما اصطلح عليه بـ "شرع من قبلنا شرع لنا"، وهي الشرائع المنزلة على أنبياء الله، وهي ليست بأصل قائم لوحده بل مرجعه إلى الكتاب والسنّة.
9ـ مذهب الصحابي: أو ما يعبر عنه بقول الصحابي أو رأيه أو فتواه. والاعتماد على مذهب الصحابي كأصل في التشريع بل لا يمكن الركون إليه في قبول روايته أيضا بمجرد كونه صحابيا إلا بعد التثبت من عدالته.
10ـ الحيل الشرعية: أي الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف. فدور الفقيه كدور المحامي حيث يسلك طريقا قانونيا ليخلص موكله من المأزق الذي وقع فيه، ويسمى بالتحايل على القانون، ولكنه في إطار القانون.
فالحيلة الشرعية إن كانت من هذا النوع بمعنى سلوك طريق شرعي آخر دون أن يصطدم بحكم شرعي آخر أو يضيع حقاً أو ما شابه ذلك فلا إشكال فيه، ولكنه ليس مصدرا مستقلا بذاته.
11ـ الشهرة: والتي تعني في اللغة الذيوع والوضوح، وعند المحدثين بالشهرة الروائية دلالة على استفاضة رواة الحديث، وعند الفقهاء بالشهرة الفتوائية، دلالة على شيوع الفتوى وذيوعها، وخلاصة الأمر أن: "الشهرة ليست أصلاً بل من المسائل المرتبطة إما بالسنة وعلومها أو بالإجماع وفروعه.
12ـ السيرة: والتي تعني السلوكية وحسن السيرة بين الناس، فما خص عقلاء الناس سمي سيرة العقلاء، وما خص الفقهاء سمي سيرة المتشرعة، وهي ليست أصلا من الأصول التشريعية.
13ـ القرعة: وتعني السهم والنصيب، وإجالة شيء بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من بينها..
14ـ الأصول العملية: أي أساس الشيء، وبتعبير الأصوليين، القواعد التي يستندون إليها في استنباط الأحكام، مثل أصالة الإطلاق والعموم والظهور وغيرها.
فماذا نعني حينما نقول -على سبيل المثال - أن القرآن الكريم هو المصدر الرئيس من مصادر الشريعة الإسلامية؟.. فنحن هنا لا نتحدث من فراغ.. ولنأخذ ما ورد في آية الدين الواردة في سورة البقرة وما فيها من أحكام تشريعات مدنية وسورة يوسف وما فيها من تشريعات جنائية متكاملة، بالإضافة إلى بعض القوانين المكملة لها في سورة النور.. وقوانين الأحوال الشخصية الموجودة تفصيلاتها في سورتي البقرة والطلاق.
-
المبحث الأول
سورة البقرة
آية الدين الواردة في سورة البقرة فهذه الآية عبارة عن مجموعة من النظريات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في الإثبات والتعاقد:
حيث اشتملت الآية الكريمة من الناحية القانونية على خمس نظريات في قضية الإثبات والتعاقد فقط وهي:
1ـ نظرية الإثبات بالكتابة
2 ـ نظرية إثبات الدين التجاري
3ـ نظرية حق الملتزم في إملاء العقد
4ـ نظرية تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات
5ـ أحكام أخرى في آية الدين
فهذه مجموعة من النظريات التي جاءت بها الشريعة الغراء نعرضها تحت عنوان واحد (الإثبات والتعاقد)، لأن القرآن الكريم جاء بها جميعاً في آية واحدة هي آية الدين، ولأن بعضها يتصل بالبعض الآخر اتصالاً وثيقاً، ولأننا سنتكلم عنها فقط بالقدر الذي يبرز فيها مميزات الشريعة الإسلامية.
يقول سبحانه وتعالى:
[ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ] البقرة{282}.
فنص الآية الكريمة يشمل عدداً من المبادئ التشريعية والنظريات الفقهية وسنبين أهمها فيما يلي:
1ـ نظرية الإثبات بالكتابة:
فرضت الشريعة الإسلامية الكتابة وسيلة لإثبات الدين المؤجل سواء كبرت قيمة الدين أو صغرت، وذلك قوله تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)..
وقوله تعالى: (وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ)..
ويدخل تحت لفظ الدين كل التزام أيًّا كان نوعه، لأن الالتزام ليس إلا دينا في ذمة الملتزم له، فيدخل تحت لفظ الدين القرض والرهن والبيع بثمن مؤجل والتعهد بعمل وغير ذلك، كذلك يمكن قياس أي التزام على الدين إذا احتفظ لكلمة الدين بمعنى القرض لأن كليهما شيء مقوم التزام به بعد أجل معين.
أما التصرفات التي تتم في الحال فليس من الواجب كتابتها ما دام كل متعاقد قد وفى بالتزاماته واستوفى حقوقه كمن يشتري شيئاً من آخر ويتسلمه ويسلمه الثمن في الحال، ومثل هذه التصرفات يجوز إثباتها بغير الكتابة مهما بلغت قيمتها إذا أثبتت باعتبارها وقائع لا باعتبارها التزامات لأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات.
وظاهر من النص الذي فرض الكتابة أنه نص عام ومرن إلى حد بعيد وأنه يصلح للتطبيق اليوم كما كان صالحاً من خمسة عشر قرناً، وكما سيكون صالحاً للمستقبل البعيد، وهذه إحدى مميزات الشريعة التي هيأتها لتكون غير قابلة للتعديل والتبديل.
ويوم نزل هذا النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العرب أميين يعيشون في أعماق البادية وفي خشونة من العيش، وأمثال هؤلاء تقل بينهم المعاملات بحيث لا تحتاج إلى تشريع خاص، ولو أن الشريعة كانت كالقانون تأتي على قد حاجة الناس لما جاء بها شيء خاص بإثبات الالتزامات، أو لجأ بها من الأحكام ما يتفق مع أمية العرب وجهالتهم، أما أن تجيء الشريعة على هذا الوجه فتفرض عل الأميين كتابة الصغير والكبير فذلك هو السمو الذي تتميز به الشريعة الكاملة الدائمة.
فرضت الشريعة الإسلامية الكتابة بين الأميين لتحملهم على أن يتعلموا فتتسع مداركهم وتتثقف عقولهم، ويحسنوا فهم هذه الحياة الدنيا فيصبحوا - وقد تعلموا - أهلاً لمنافسة الأمم الأخرى وللتفوق والسيطرة عليها، وهذه أغراض اجتماعية وسياسية بحته، أما الغرض القانوني فهو حفظ الحقوق وإقامة الشهادات ولابتعاد عن الريب والشكوك.
فالشريعة حين أوجبت الكتابة في الصغير والكبير جاءتنا بنظرية عظيمة ذات وجوه سياسية واجتماعية وقانونية، وهذه النظرية التي نزل بها القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي هي من أحدث النظريات في القوانين الوضعية وفي المذاهب الاجتماعية الحديثة، فالدول قد بدأت من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالي تفرض على شعوبها أن يتعلموا تعليماً إجبارياً رجالاً ونساء، وهذا الذي تفرضه الدول على الشعوب إنما هو تطبيق للنظرية الإسلامية في ناحيتها السياسية والاجتماعية.
وقد بدأت الدول تأخذ بالناحية القانونية من النظرية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حين افترض القانون الفرنسي الذي أخذت عنه القوانين الأوربية أن يكون مكتوباً إذا زاد عن مقدار معين، ولكن شرّاح القانون رأوا أن نظرية الإثبات بالكتابة تكون أكمل وأكثر توفيقاً لو اشترطت الكتابة في الصغير والكبير وظلوا ينادون برأيهم به ويأملون تحقيقه.
وإذن فأحدث نظريات الإثبات في عصرنا الحاضر هي نفس نظرية الشريعة الإسلامية أخذت بها القوانين الوضعية ولا يزال الشراح في بعض الدول يطالبون دولهم أن تأخذ بها..
2 ـ نظرية إثبات الدين التجاري.
اشترطت الشريعة - كما بينا- الكتابة لإثبات الدين سواء كان الدين صغيراً أو كبيراً، ولكنها استثنت من هذا المبدأ العام الدين التجاري وأباحت إثباته بغير الكتابة من طرق الإثبات وذلك قوله تعالى: [إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا] والعلة في استثناء الديون التجارية من شرط الكتابة أن الصفقات التجارية تقتضي السرعة ولا تحتمل الانتظار، ولأن المعاملات التجارية أكثر عدداً وتكراراً وتنوعاً، فاشتراط الكتابة فيها يؤدي إلى الحرج وقد يضيع فرصة الكسب على المشتري أو يعرض البائع للخسارة، ومن أجل هذا لم تقيد الشريعة المعاملات التجارية بما قيدت به المعاملات المدنية من اشتراط الكتابة.
والنص المقرر لهذه النظرية عام ومَرِنٌ إلى آخر الحدود بحيث لا يحتاج على مَرِّ الأزمان تعديلاً أو تبديلاً وليس أدل على ذلك من صلاحيته لوقتنا الحاضر مع أنه نزل منذ أكثر من خمسة عشر قرنا.
ومن يعرف شيئاً عن تاريخ العرب وحالهم وقت نزول النص يعلم أن النص لم ينزل مجاراة لحال الجماعة أو تمشياً مع ما وصلت إليه، وإنما كان نزول النص ضرورة لتكميل الشريعة الدائمة الكاملة ولرفع مستوى الجماعة وتوجيههم الوجهة الصالحة.
واستثنت الشريعة الإسلامية أيضاً من الإثبات بالكتابة حالة الضرورة وذلك قوله تعالى:
(وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ).
وليس أدل على سمو الشريعة وكمالها من أن نظرياتها في إثبات الدين التجاري هي نفس النظرية السائدة اليوم في القوانين الوضعية الحديثة، وإنها تعتبر أحدث ما وصل إليه القانون الوضعي في عصرنا الحاضر.
3ـ نظرية حق الملتزم في إملاء العقد:
جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ عام أوجبته في كتابة العقود وهو أن يملي العقد الشخص الذي عليه الحق أو بمعنى آخر أضعف الطرفين، والمقصود من هذا المبدأ العام هو حماية الضعيف من القوي، فكثيراً ما يستغل القوي مركزه فيشترط على الضعيف شروطاً قاسية، فإن كان دائناً مثلاً قسا على المدين، وإن كان صاحب عمل سلب العمل كل حق واحتفظ لنفسه بكل حق، ولا يستطيع المدين أو العامل أن يشترطا لنفسيهما أو يحتفظا بحقوقهما لضعفهما، فجاءت الشريعة وجعلت إملاء العقد معلومة له حق العلم، وليقدر ما التزم به حق قدره.
وهذه الحالة التي عالجتها الشريعة من يوم نزولها هي من أهم المشاكل القانونية في عصرنا الحاضر، وقد برزت في أوروبا في القرون الماضية على أثر النهضة الصناعية وتعدد الشركات وكثرة العمال وأرباب الأعمال، وكان أظهر صور المشكلة أن يستغل رب العمل حاجة العامل إلى العمل أو حاجة الجمهور إلى منتجاته فيفرض على العامل أو على المستهلك شروطاً قاسية يتقبلها العمل أو المستهلك وهو صاغر، إذ يقدم عقد العمل أو عقد الاستهلاك مكتوباً مطبوعاً فيوقعه تحت تأثير حاجته للعمل أو حاجته للسلعة، بينما العقد يعطى لصاحب العمل كل الحقوق ويرتب على العامل أو المستهلك كل التبعات.
ذلك العقد الذي نسميه اليوم في اصطلاحنا القانوني (عقد الإذعان).
وقد حاولت القوانين الوضعية أن تحل هذا المشكل، فاستطاعت أن تحله بين المنتج والمستهلك بفرض شروط تحمي المستهلك من المنتج وبتعيين سعر السلعة، ولكنها لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحي المشكلة بين أصحاب العمل والعمال، مثل إصابات العمال والتعويضات التي يستحقها العمل إذا أصيب أو طرد من عمله، لأن التدخل بين صاحب العمل والعمال في كل شروط العمل مما يضر بسير العمل والإنتاج، وبقيت من المشكلة نواح هامة كأجر العمل وساعات العمل ومدة الإجازات وغيرها, يحاول أصحاب العمل من ناحيتهم حلها بتأليف النقابات والاتحادات وتنظيم الإضرابات، ويرى العمال من ناحيتهم أن حل مشاكلهم لن يتأتى إلا إذا كان لهم حق إملاء شروط عقد العمل، ويظاهرهم على ذلك بعض المفكرين والكتاب، فهذا الحق الذي يطالب به العمال في كل أنحاء العالم والذي أضرب العمال من أجله وهددوا السلم والنظام في دول كثيرة في سبيل تحقيقه، هذا الحق الذي حقق القانون الوضعي بعضه ولم يحقق بعضه الآخر والذي يأمل العمال أن يتحقق كله وللملتزمين على الملتزم لهم وجاء به القرآن الكريم في آية الدين [وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ]..
وظاهر أن صيغة النص بلغت من العموم والمرونة كل مبلغ.
وهذا هو الذي جعل الشريعة تمتاز بأنها لا تقبل التغيير والتبديل.
ووجود هذا النص في الشريعة تمتاز دليل بذاته على سموِّها وكمالها وعدالتها فقد جاءت به منذ أكثر من خمسة عشر قرناً، بينما القوانين الوضعية لم تصل إلى تقرير مثله حتى الآن مع ما يدعي لها من الرقي والسمو.
4ـ نظرية تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات:
حرمت الشريعة على الإنسان أن يدعى للشهادة فيمتنع عنها، أو أن يشهد واقعة فيكتمها، أو يذكرها على غير حقيقتها، وقد نص على الحالة الأولى في آية الدين في قوله تعالى: (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ) والمقصود إباؤهم حينما يدعون ليشهدوا تصرفاً مَّا أو واقعة معينة، فالنص جاء بتحمل الشهادة وليس خاصاً بأدائها.
أما الحالتان الثانية والثالثة فقد نص عليهما في قوله تعالى: (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)..
وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) النساء {135}.
والنصان الأخيران خاصان بتحريم كتمان الشهادة أو الامتناع عن أدائها وبتحريم شهادة الزور.
والقوانين الوضعية اليوم تأخذ بنظرية الشريعة في تحريم شهادات الزور أو كتمان الشهادة، ولكنها لم تصل بَعْدُ إلى تحريم الامتناع عن تحمل الشهادة ولا شك أن الشريعة تتفوق على القوانين الوضعية من هذه الجهة.
إذن فإن المصلحة العامة تقتضي بالتعاون على حفظ الحقوق وبتسهيل المعاملات بين الناس ولامتناع عن تحمل الشهادة يقضي إلى تضييع الحقوق، ويؤدي إلى تعقيد المعاملات وبطئها وهناك عقود لابد فيها من حضور الشهود كعقد الزواج..
فإذا كان الامتناع عن تحمل الشهادات مباحاً تعطلت هذه العقود..
ومن ير النصوص التي جاءت في تحريم الامتناع عن تحمل الشهادة أو في تحريم كتمانها أو تغييرها يعلم مدى ما بلغته هذه النصوص من العموم والمرونة ويفهم العلة في أن الشريعة لا تقبل التعديل أو التبديل..
ومن يقارن الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية يعلم مدى ما وصلت إليه الشريعة من السمو والكمال، ويتبين أن نصوص الشريعة لم ترد مسايرة لحال الجماعة وإنما وردت لتكمل الشريعة بما تحتاج إليه الشريعة الكاملة الدائمة، ولترفع مستوى الجماعة حتى تقترب من مستوى الشريعة الكامل..
5ـ أحكام أخرى في آية الدين:
هذه أربع نظريات جاءت بها آية واحدة من القرآن الكريم هي آية الدين، أخذت القوانين الوضعية الحديثة باثنين وبدأت تأخذ بالثالثة ولم تأخذ بَعْدُ بالرابعة، وليست هذه القوانين الأربع هي كل أحكام آية الدين، وإنما هي بعض أحكامها، فالآية تشترط أن يكون الكاتب محايداً عدلاً عالماً بأحكام الشريعة فيما يكتبه، وتوجب عليه أن لا يمتنع عن الكتابة وتشترط أن يشهد على سند الدين رجلان أو رجل عدل وامرأتان، وتوجب عدم الإضرار بالكاتب أو الشاهد، وهذه كلها مبادئ عامة لا نستطيع أن نستعرضها جميعاً في هذه الدراسة.
وإذا كنا قد تكلما عن نظريات دستورية واجتماعية وإدارية ومدنية فإنما قصدنا من ذلك أن نبين أن نصوص الشريعة في كل ما جاءت فيه تتميز بالكمال والسمو والدوام حتى لا يظن البعض أن هذه المميزات تتوفر في قسم دون آخر من الشريعة.
-
المبحث الثاني
سورة يوسف
في هذا الفصل سوف نتناول القواعد القانونية والتي أسس لها القرءان الكريم وذلك من خلال سورة يوسف عليه السلام والتي هي أحسن القصص.
إنسَ تماما أنك تعرف سورة يوسف وربما تكون من الحافظين لها وربما تكون قد اطلعت على كافة التفاسير لها..
حسنا..
يقول سبحانه وتعالى:
(وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ) يوسف:21.
السؤال هو:
هذا الحوار دار بين من؟..
أذكرك مرة أخرى: انس تماما أنك تعرف سورة يوسف.
بالطبع فأنا أعرف أن الكل سوف يقع في شَرَكْ السؤال..
فأين تكمن المشكلة.
إنها تكمن في الصورة الذهنية لشخصيات السورة والمحفورة في الذاكرة عندك والتي أحاول أن انتزعها منك انتزاعا ولكن دون جدوى..فلقد خضت معك تجربة وقوعك تحت التأثير النفسي للقرآن الكريم والذي يعتمد على أسلوبه المذهل عند عرضه لتسلسل الأحداث ..لذلك جرب أن تقرأ الصفحة الأولى والثانية ونصف الثالثة من المصحف مباشرة دون الاعتماد على الذاكرة ..عندها سوف تعرف الإجابة ..
وعلامة معرفتها تتمثل في الإجابة عن سؤال أخر أقل تعقيدا وأكثر تبسيطا..
يقول سبحانه وتعالى:
(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) يوسف:23
طرفا المعادلة رجلٌ وامرأة..
ولكننا نعرف منها طرفاً واحداً فقط ألا وهو يوسف عليه السلام ولكن من هو الطرف الأخر فيها؟..
من هي تلك المرأة؟..
أذكرك مرة أخرى: انس تماما أنك تعرف القصة بتمامها في سورة يوسف.
الإجابة
من أول السورة وحتى الآية رقم 29 منها لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن شخصيات القصة باستثناء سيدنا يوسف عليه السلام..
فنحن لا نعرف من هو الشاري وحتى فعل المراودة الصادر عن المرأة لا نعرف من تكون، فلقد اكتفى الحق سبحانه وتعالى بقوله:
(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) يوسف:23.
دققوا في قوله تعالى: (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا).. كلام كتير كان من الممكن اختزاله في كلمة واحدة.. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يخفي شخصيتها وزوجها عنا تماما حتى الآية رقم 30..
راجعوا معي مرة ثانية:
1-(وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ) يوسف:21.
من هو؟..لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى حتى الآية رقم 29 لم نعرف من هو.. فلقد أخفى الله سبحانه وتعالى شخصيته عنا لنعرف من خلالها طبيعة وثقافة المجتمع المصري.. فالرجل بعدما رأى بعينه خيانة زوجته وبالدليل القاطع فما كان منه إلا أن قال:
(يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) يوسف: 29.
يا سلام؟..
(يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا)..هكذا وبمنتهى البساطة..
ثم يلتفت إلى حرمه المصون قائلا لها: (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ)..
لأ يا شيخ ..بجد.. حمش..
2- (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ) من هي؟...
نحن لا نعرف فالله سبحانه وتعالى لم يخبرنا ،وإخفاء شخصيتها مقصود لذاته بعكس الحديث عن أم موسى وأم عيسى عليهما السلام..فتحديد الشخصية والأسماء هنا مهم لأن شخصية أم موسى تعالج الأمومة في حين شخصية أم عيسى فتعالج العقيدة..
أما إخفاء الشخصية هنا لأنها تتناول الخوض في الأعراض..
دققوا:
(۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) يوسف: 30 .
نحن الآن فقط علمنا من هي تلك المرأة ومن هو زوجها، بعد 29 أية من التلاوة ولو لم يقل النسوة (امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ) لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أمرها..
لماذا لأن الموضوع خاص بالحديث عن إشاعة الفاحشة والخوض في الأعراض..
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النور:19.
هذا من يحب إشاعتها فكيف بمن يشيعها..
(۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) يوسف: 30 .
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النور:19.
هذا من يحب إشاعتها فكيف بمن يشيعها....لأن الله سبحانه وتعالى لم يكشف لنا عن حقيقة الرجل الذي اشترى يوسف واكتفى بقوله تعالى (من مصر)لندرك أن السيارة لم يكونوا من أهل مصر هذه واحدة أما الثانية فتتعلق بحب إشاعة الفاحشة..فلو لم يقل النسوة ما سمعوه من كلام ورددوه قبل أن ينظروه ويعاينوه ما علمنا شيئا ومن ثم وجدنا التقريع الشديد في القرآن الكريم في قوله تعالى:
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النور:19.
ولما كان الفعل المضارع في اللغة يدل على التجدد والاستمرار وقد جاء التعبير بالفعل (يحبون) و(تشيع) بصيغة الفعل المضارع ليدل على استمرار هذه الأفعال وأنها ليست مقتصرة على حادثة مضت وانتهت.
يحبون: الحب فعل قلبي ولم تعبر الآية بفعل يتمنون أو يأتون الفاحشة أو يشيعونها وإنما مجرد الحب القلبي. فإذا كان مجرد الحب القلبي لإشاعة الفاحشة عذابه (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) فما بالنا بمن يشيعها؟! وما بالنا بمن يفعلها؟!
وجاء التعبير بصيغة المضارع أيضًا في فعل (تشيع) وهو فعل يدل على سرعة الانتشار، فهذا يدل على شمولية انتشار الفاحشة في المجتمع المؤمن.
قد يسأل البعض: كيف يكون العذاب الأليم في الدنيا ونحن نرى البعض ممن يشيعون الفاحشة لم يعاقبوا؟ فيأتي ختام الآية (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) الله سبحانه وتعالى يعلم السرّ وأخفى ويعلم من يحب أن تشيع الفاحشة ولو أنهم أخفوا هذا الحب القلبي عن أعين الناس والله عز وجلّ يعلم قدر وعِظم هذا الألم الذي سيأتي لأمثال هؤلاء ممن يحبون أن تشيع الفاحشة فختمت الآية بما يتناسب مع سياقها.
لقدِ ازدادتْ خُطُورة نشْر الفاحشة بازدياد أوعيتها، وتنوُّع أساليبها، فقد يعجز المرء عن حصْر ومتابعة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمشاهدة، والتي جعل أكثرها من تزيين الفاحشة هدفًا، تُعَدُّ من أجله النصوص والمقالات.
والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده، نعم هي للمتهم، لكن قد تنتهي بحياته، وقد تنتهي ببراءته، لكن المصيبة أنها ستكون أُسْوة سيئة في المجتمع.
وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى إلى قضية عامة وقاعدة يجب أن تُرَاعى، وهي: حين تسمع خبراً يخدش الحياءَ أو يتناول الأعراض أو يخدش حكماً من أحكام الله، فإياك أنْ تشيعه في الناس؛ لأن الإشاعة إيجاد أُسْوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن يفعل، فيقول في نفسه: فلان فعل كذا، وفلان فعل كذا، ويتجرأ هو أيضاً على مثل هذا الفعل، لذلك توعد الله تعالى مَنْ يشيع الفاحشة وينشرها ويذيعها بين الناس { لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدنيا والآخرة..} [ النور: 19] .
والله تبارك وتعالى لم يعصم أحداً من المعصية وعمل السيئة، لكن الأسوأ من السيئة إشاعتها بين الناس، وقد تكون الإشاعة في حق رجل محترم مُهَابٍ في مجتمعه مسموع الكلمة وله مكانة، فإنْ سمعت في حَقِّه مَا لا يليق فلربما زهّدك ما سمعتَ في هذا الشخص، وزهَّدك في حسناته وإيجابياته فكأنك حرمتَ المجتمع من حسنات هذا الرجل.
وهذه المسألة كما قال فضيلة الشيخ الشعراوي رضي الله تعالى عنه :
(هي التعليل الذي يستر الله به غَيْب الخَلْق عن الخَلْق)..
إذن: سَتْر غيب الناس عن الناس نعمة كبيرة تُثري الخير في المجتمع وتُنميه، ويجعلك تتعامل مع الآخرين، وتنتفع بهم على عِلاَّتهم، وصدق الشاعر الذي قال:
فَخُذْ بِعلْمي ولاَ تركَنْ إلىَ عَمِلي / وَاجْنِ الثمارَ وخَلِّ العُودَ للنَّارِ
وذلك جانب من منهج التربية , وإجراء من إجراءات الوقاية. يقوم على خبرة بالنفس البشرية , ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها..
وهذه الآية في ختام الآيات التي نزلت في براءة أمنا عائشة - - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - من كل ما قالهٌ فيه المنافقون، ; وأنها بريئة من كل هذه الأمور، وأنها عفيفةٌ كل العِفَّة، قال الله - جلَّ عَلاَ-: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )، المنافقون عندما قالوا الإفك في عائشة عندما نامت، وسار الجيش أمامها، وقامت وحدها، وكان صفوان بن المُعطِّل هو الذي غلب عليه النوم، حتى أدركها، فحملها على جمله، وقاد بزمام الجمل حتى أتى بها المعسكر، فتكلَّم بعض المنافقين، أو بعض ضعيفي الإيمان، وقالوا ما قالوا، فبرَّأ الله أمَّ المؤمنين من كل سوء، ونزَّها من كل سوء، وردَّ على هؤلاء ردًا جزلاً عظيما، وختم الله القصة بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا)، أي يحبون أن تنتشر فيهم الفاحشة، ويحبون شيوع الفاحشة، ويحبون القول فيها، ويحبون تلوث الناس بها، فهؤلاء - والعياذ بالله- قصدهم الأذى والسوء، (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، فعليهم حدُّ القتل، ولهم عذاب الآخرة، لأنهم أحبوا إشاعة الفاحشة بين المسلمين، فإن إشاعة الفاحشة ضرر على أهل الإسلام، أن تنتشر الفاحشة بينهم، ; وقذف بعضِهم بعضا، ورمي بعضهم بعضا. ;
حَرَص الإسلام أشد الحرص على مُحَاصَرة الفواحش بكل أنواعها، وبدأت محاربة الإسلام للفواحش من خلال منْع إشاعتها، وإغلاق كل السُّبُل المؤدِّية إليها، فقد قَدَّم تحريم النظر على تحريم الزنا؛ لأن النظر بريد الزنا؛ ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور: 30]، وتَوَعَّد مَن يُطْلق العنان للسانه في أعراض الناس، وإثارة الشبهات، فأوجب له العذاب الأليم، وأسقط اعتباره حين أسقط شهادته نهائيًّا.
هذه الأحكام وغيرها كانتْ بمنزلة السياج والعلاج؛ بُغية تجفيف منابع الفاحشة؛ حتى لا تراها عين، ولا تسمعها أذن، ولا يَتَحَدَّث بها لسان.
يتضح لنا - على هَدْي ما ذكر - عظم الجُرْم الذي يقع فيه الذين يروجون للفواحش في المجتمع المسلم، ويزينونها في عيون الأغرار من الناس، وليس أخطر على المجتمع من اعتياد الشرِّ وقبوله، ولو عند الطرف الآخر، ممن نعتقد أنهم على ضلال؛ لأن مبدأ التهوين يقود إلى التليين ثم التزيين.
ولا بأس أن أذكر هنا ما ذكره مخرج تائب، فقد قال: كان يأتي إلينا المنتج من بعض دول الخليج، فيقول: أريد الممثِّلة فلانة مع الممثل فلان، في مسلسل تقوم فكرته على أنَّ العلاقة بين الشاب والفتاة قبل الزواج مستحبَّة، وتسهم في استمرار الحياة الزوجية، ويصب في هذا الاتجاه ذلك الكمُّ منَ المجلات المُوَجَّهة للشباب والشابات، والتي يباع أكثرها بأقل من سعر التكلفة؛ بغية الوصول إلى أكبر قطاع منَ الشباب وإفسادهم.
فجميع الدول على كافة أعراقها وانتماءاتها في منهج التربية فهي تسعى إلى خلق (المواطن الصالح) طبقا لمعايير تتناسب مع طبيعة وتوجه الدولة.. أما الإسلام فمنهجه مختلف تماما وعلى النقيض من الأمر فهو لا يسعى إلى خلق (المواطن الصالح) وإنما (الإنسان الصالح) الإنسان من حيث هو إنسان بجوهره الكامن فيه.. الإنسان بكينونته كإنسان.. وليس كمواطن.. والآية التي بين أيدينا هي النواة الأولى لهذا المنهج الإسلامي الفريد.
فائدة:
(۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (30)) يوسف: 30.
قَالَ اللهُ تَعَالى في سُورَةِ يُوسُف: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (يوسف: ٣٠).
وقَالَ اللهُ تَعَالى في سُورَةِ الحُجُرَات: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحجرات: ١٤).
ان الفاعل إذا كان جمعا ، أو اسم جمع كما هو الحال في تلك الآية الكريمة ؛
فإنه نعم يجوز في فعله : ( التذكير ، والتأنيث ) .
ويُغلّبُ التذكير إذا كان المقصود بالجمع :قلة العدد ؛كما في قوله تعالى ( وقال نسوة ) ؛ فلأنّ المتكلمين في حق امرأة العزيز آنذاك ( قلة ) من النساء ؛ فآثر الحق جل وعلا التذكير : إشارة إلى قلة عدد المتكلمين ؛ لأنه على تقدير :وقال ( جمع ) نسوة .
ويُغلّب التأنيث إذا كان المراد من الجمع كثرة في العدد ؛ لأنه يكون على تقدير ( جماعة ) كما في قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا ) ؛ فلم آثر الحق ههنا التأنيث ؟ لأنه على تقدير : قالت ( جماعة ) الأعراب إشارة إلى كثرة عدد القائلين .ولذا لِمَ ذُكّر الفعل مع ( المؤمنات ) في قوله تعالى :
( ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) ،مع أن المؤمنات مؤنث حقيقي التأنيث .
لأن ( المؤمنات ) وهن الفاعل جمع ؛ فيجوز في فعله : التذكير والتأنيث ،وآثر الحق جل وعلا التذكير في الفعل هنا : إشارة إلى قلة عددهن .وتلك قاعدة مطردة في القرآن الكريم ،ومَن يتتبعها يدرك تلك الأسرار الدقيقة المرتبطة بالمعنى .
فلم يؤنَّث الفعل الذي هو (قال) في قوله تعالى: (وَقَالَ نِسْوَةٌ) لأن لفظ (نسوة) مؤنث غير حقيقي.
ففي قوله (وَقَالَ نِسْوَةٌ) النسوة فيها أقوال:
المشهور: أنه جمع تكسير للقلة على فعلة، كالصبية والغلمة، وليس لها واحد من لفظها.
والثاني: أنها اسم مفرد لجمع المرأة.
والثالث: أنها اسم جمع، وكذلك أخواتها: كالصبية والفتية.
وعلى كل قول فتأنيثها غير حقيقي فهو باعتبار الجماعة، ولذلك لم يلحق فعلها التأنيث.
فإذا كان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع كـ(نسوة)، فيجوز في الفعل أن يذكَّر نظراً لمعنى الجمع، وأن يؤنث نظراً لمعنى الجماعة.
وفي هذا الفصل سوف نتناول القواعد القانونية التالية والمستقاة من سورة يوسف عليه السلام.http://www.ebnmaryam.com/vb/image/gi...EAAAICRAEAOw==
المطلب الأول- مبــدأ قانــونيٌّ (شخصيَّة العقـــــوبة)
المطلب الثاني- علاقة يوسف بقميصه علاقة تستحق التأمل..
المطلب الثالث- القرائن
المطلب الرابع- التنازع الدولي من حيثُ الاختصاص التشريعي.
المطلب الخامس- قواعد القانون الجنائي في سورة يوسف
المطلب السادس- الطعن في الحكم القضائي
المطلب السابع- تكييف الواقعة أو ما يعرف بالحيل الفقهية ومشروعيتها
المطلب الثامن- حق المتهم في الدفاع عن نفسه
المطلب التاسع- قضيتي الثبوت والتحاكم
المطلب العاشر- أمورٌ إنسانيَّة متكررة يمارسها الناس عند وقوعهم تحت طائلة القانون
-
المطلب الأول
مبــدأ قانــونيٌّ (شخصيَّة العقـــــوبة)
هناك مبدأ قانوني في شرائع من قبلنا، ومُقرٌّ في شريعتنا، ومازال معمولاً به في الأنظمة العقابية.. وهو:
(شخصية العقوبة)
أي: لا يتعدى أثر العقوبة إلى غير الجاني … (قال معاذ الله أن نأخذ إلاّ من وجدنا متاعا عنده إنّا إذا لظالمون) يوسف / 79 ..
وهذا أصل من أصول الشريعة الغرَّاء، ورد في شريعتنا متفِقاً مع ما ورد على لسان سيدنا [يوسف]..
يقول تعالى :
(ولا تكسب كلّ نفسٍ إلاّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) المائدة / 164 .
ويقول تعالى :
(وكل إنسان ألزمنـاه اليوم طائره في عنقيه ونخرج له يوم القيـامة كتاباً يلقاهُ منشورا، إقرأ كتابك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) الإسراء / 14 ..
فهذا أحسن تعبير عن [ شخصيَّة العقوبة ] !!..
ويتجلى هذا الأمر بوضوح في شخصية (شخصيَّة العقـــــوبة) والتي تتجلى في قول الملك اثناء التحقيق:
(وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ)...
(وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ) كي أستمع كلامه وأعرف درجة عقله وأعلم تفضيل رأيه (فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ) وبلّغه أمر الملك وطلب إليه إنفاذه.
(قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) البال: هو الأمر الذي يبحث عنه ويهتم به: أي ارجع إلى سيدك قبل شخوصي إليه ومثولي بين يديه، وسله عن حال النسوة اللاتي قطّعن أيديهن ليعرف حقيقة أمره، إذ لا أود أن آتيه وأنا متهم بقضية عوقبت من أجلها بالسجن وقد طال مكثي فيه دون تعرف الحقيقة ولا البحث في صميم التهمة.
لا تنس أن يوسف عليه السلام كان رهن الاعتقال ولم توجه له تهمة..
(إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) أي إنه تعالى هو العالم بخفيّات الأمور، وهو الذي صرف عنى كيدهن فلم يمسسني منه سوء.
وقد دل هذا التريث والتمهل من يوسف عليه السلام عن إجابة طلب الملك له حتى تحقق براءته على جملة أمور:
(1) جميل صبره وحسن أناته، ولا عجب فمثله ممن لقى الشدائد جدير به أن يكون صبورا حليما، ولا سيما ممن ورث النبوة كابرا عن كابر.
وقد ورد في الصحيحين مرفوعا « ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي »، وفي رواية أحمد « لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر ».
(2) عزة نفسه وصون كرامته، إذ لم يرض أن تكون التهمة بالباطل عالقة به، فطلب إظهار براءته وعفته عن أن يزنّ بريبة أو تحوم حول اسمه شائبة السوء.
(3) إنه عفّ عن اتهام النسوة بالسوء والتصريح بالطعن عليهن حتى يتحقق الملك بنفسه حين ما يسألهن عن السبب في تقطيع الأيدي ويعلم ذلك منهن حين الإجابة.
(4) إنه لم يذكر سيدته معهن وهي السبب في تلك الفتنة الشعواء وفاء لزوجها ورحمة بها، وإنما اتهمها أولا دفاعا عن نفسه حين وقف موقف التهمة لدى سيدها وبعد أن طعنت فيه.
(قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ) الخطب الشأن العظيم الذي يقع فيه التخاطب إما لغرابته وإما لإنكاره، ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: « قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ » وقوم موسى: « فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ » أي إن الرسول بعد أن أبلغ الملك قول يوسف: إنه لا يخرج من السجن استجابة لدعوته حتى يحقق قصة النسوة - جمعهن وسألهن: ما خطبكن الذي حملكن على مراودته عن نفسه: هل كان عن ميل منه إليكن، وهل رأيتن منه مواتاة واستجابة بعدها، وماذا كان السبب في إلقائه في السجن مع المجرمين.
(قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ) أي معاذ الله. ما علمنا عليه سوءا يشينه ويسوءه لا قليلا ولا كثيرا.
انتبه للإجابة الدبلوماسية منهن..إن الملك لم يسألهن عن اخلاق يوسف عليه السلام حتى تكون تلك الإجابة ولكنه سألهن عن تصرف بدر منهن تجاه يوسف وهو اتهام مباشر لهن..
هنا قامت امرأة العزيز وبكل شجاعة قالت:
(قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ: الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ) حصحص: ظهر بعد أن كان خفيا أي إن الحق في هذه القضية كان في رأى من بلغهم - موزّع التبعة بيننا معشر النسوة وبين يوسف، لكل منا حصة بقدر ما عرض فيها من شبهة، والآن قد ظهر الحق في جانب واحد لا خفاء فيه، وهن قد شهدن بما علمن شهادة نفى، وهأنذا أشهد على نفسي شهادة إيجاب.
(أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ) لا أنه راودنى، بل استعصم وأعرض عني.
(وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) في قوله حين افتريت عليه: هي راودتنى عن نفسي، والذي دعاها إلى هذا الاعتراف مكافأة يوسف على ما فعله من رعاية حقها وتعظيم جانبها وإخفاء أمرها حيث قال: (ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) ولم يعرض لشأنها.
وفي هذا الاعتراف شهادة مريحة من امرأة العزيز ببراءة يوسف من كل الذنوب، وطهارته من كل العيوب.
(ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) أي ذلك الاعتراف مني بالحق له، والشهادة بالصدق الذي علمته منه، ليعلم إني لم أخنه بالغيب عنه منذ سجن إلى الآن، فلم أنل من أمانته، أو أطعن في شرفه وعفته، بل صرحت لأولئك النسوة بأني راودته عن نفسه فاستعصم، وهأنذا أقر بهذا أمام الملك ورجال دولته وهو غائب عنا.
(وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ) أي لا ينفذه بل يبطله وتكون عاقبته الفضيحة والنكال، ولقد كدنا له فصرف ربه عنه كيدنا، وسجنّاه فبرأه الله وفضح مكربا، حتى شهدنا على أنفسنا في مثل هذا الحفل الرهيب والمقام المنيف ببراءته من كل العيوب، وسلامته من كل سوء.
وعلى الجملة فالتحقيق أسفر عن أن يوسف كان مثل الكمال الإنساني في عفته ونزاهته لم يمسسه سوء من فتنة أولئك النسوة، وأن امرأة العزيز أقرّت في خاتمة المطاف بذنبها في مجلس الملك إيثارا للحق وإثباتا لبراءة يوسف عليه السلام.
مذكرة بدفاع
دائـرة جنح مستأنف ممفيس مدينة الاله رع - منف اول عاصمة مركزية وموحده يعرفها التاريخ والتي تعرف اليوم بميت رهينه جنوب مركز البدرشين - .
نبي الله يوسف عليه السلام / متهم
ضــــــــــد
النيابة العامة ممثلة الاتهام
في القضية رقم .......... لسنة جنح مستأنف (....) والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 / 12/ 2019 .
بأسباب الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بتاريخ / / 1900 ق.م عصر سونسرت الثاني من الأسرة الثانية عش من محكمة جنح
فى القضية رقم (بدون)/ جنح المقضى فيها غيابيا بحبس المتهم تسع سنوات .
االوقائع والموضوع
إيمانا من الدفاع ببراءة ساحة المتهم من ثمة ما يشوبها من عمل مخالف والثابت علي ما جري عليه قرار الاتهام وحرصا منا كذلك علي ثمين وقت عدالة المحكمة نعرض للوقائع بإيجاز في نقاط عدة :-
إن المتأمل في سيرة يوسف عليه السلام وإخوته يلاحظ أمورا متعددة وعلوما كثيرة وبالأخص أن هناك مجموعة من القمصان المنسوبة ليوسف.
أحدها الذي جاء به إخوته وعليه دم كذب.
وقمصان أخرى كان يرتديها يوسف حين كان عند أبيه وفي بيت العزيز.
ولعل القميص الأهم من بينها هو الذي ألقوه على وجه أبيه فارتد بصيرا.
علاقة يوسف بقميصه علاقة تستحق التأمل..
1- رأيناه يوم أن كاد له إخوته بسوء..
(وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ) يوسف: ١٨.
وطبعاً هذا القميص احتفظ به أبوه..
2- ومع امرأة العزيز
(وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) يوسف: ٢٥.
وطبعاً هذا القميص احتفظت به هيئة المحكمة كدليل إدانة..
3-ومع أبيه
(اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) يوسف: ٩٣.
وطبعاً هذا القميص من الواضح أنه هو القميص الذي كان يرتديه ساعتها فهو بمثابة البشارة..
-
المطلب الثاني
علاقة يوسف بقميصه علاقة تستحق التأمل..
هناك قضية هامة يجب الانتباه لها في معرض استعراضنا لأهمية القميص، وهي اقتصار استخدام مفردة (قميص) في هذه السورة فقط وحين الحديث عن يوسف تحديدا، بينما في القرآن استخدمت مفردات أخرى لأنواع المرتديات كالجلباب واللباس والثياب وغيره، هذا إذا اعتبرنا أن القميص صنف من الثياب.
وهنا تبرز أمامنا تساؤلات هامة:
ما هو السر الذي لا نعرفه عن قميص يوسف هذا؟ ولماذا لم يستخدم يوسف أنواعا أخرى من الثياب خلاف القمصان؟ ألم تجد امرأة العزيز غير القميص لتقده؟ ولماذا أستخدم الشاهد القميص في شهادته وليس شيئا آخر؟ وكيف يكون قد القميص من قبل دليل كذب وإدانة، بينما قده من دبر دليل صدق وبراءة؟ وكيف يمكن ليوسف أن يقد قميصه من قبل؟ وهل واجهة القميص الأمامية تسمى قبل وواجهته الخلفية تسمى دبرا؟.
وهل القميص المستخدم في الشهادة هو نفس القميص الذي أرسله يوسف لأبيه؟ ولماذا لم يرسل يوسف لأبيه أي قطعة أخرى خلاف هذا القميص؟.
وهل القميص له علاقة حين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ هل الريح هي الرائحة؟ غريب أمر هذا القميص! ما سره؟ هل معنى مفردة قميص في السورة هو ذات المعنى المتداول بين الناس أم أن السورة تشير إلى شيء آخر لا علاقة له بما نعرف؟ تساؤلات عديدة أحاول من خلالها الإجابة في ضوء ما يسر الله لي من تدبر لآيات القرآن العظيم.
دعونا نفتح قضية يوسف مع امرأة العزيز من جديد ونضع تحت المجهر إن لي صح التعبير أول دليل جنائي في القضية وهو قميص يوسف ، فلعل هناك أمر ما قد فات علينا ، فهو ليس كأي قميص آخر ، فقد لعب دورا هاما في قصة يوسف عليه السلام. ورد ذكره ست مرات في ست آيات ولم يرد ذكره خارج سورة يوسف. استخدمه إخوته كدليل على أكل الذئب يوسف.
استخدمه الشاهد كدليل براءة يوسف. وأخيرا كسبب في ارتداد البصر!.
أهمية قميص يوسف:
الفرق بين مفردتي (قميص) و (لباس): في البداية لنعود إلى آيات القرآن العظيم محاولة التعرف على بعض معاني مفردة (لباس)، فقد وردت هذه المفردة في آيات عديدة من القرآن ولكني سأقتصر على هاتين الآيتين من سورة الأعراف لارتباطهما بالموضوع من ناحية الهدف من اللباس.
قال تعالى في الأعراف: آية 26 و27 (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ) و (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا)، الهدف واضح من خلال الآيتين، ألا وهو أن اللباس يقصد به ستر العورة أو السوأة وهي تقع في الجزء الأدنى من الجسد، فإذا كان الهدف من اللباس هو تغطية أسفل الجسد، إذن يمكننا الاستنتاج منه أن القميص يستخدم لتغطية الجزء الأعلى منه.
الفعلين (قمص) و(لبس) ليسا فعلين حركيين يتطلبان من الفرد الانتقال من مكان لآخر.
الفرق بين الفعلين (نزع) و (قد) وارتباطهما بالقميص:
لنتدبر الآن الفرق بين الفعلين (نزع) و (قد). ورد الفعل (نزع) في أكثر من آية من سور القرآن العظيم وهو في مجمله يشير إلى إخراج شيء من شيء أو سلب شيء عن شيء، سواء كان المنزوع ماديا أو معنويا! كنزع الملك ونزع ما في الصدور ونزع اليد ونزع الرحمة ونزع العتاة ونزع الشهداء ونزع الناس ونزع اللباس. وصف القرآن الفعل الذي قام به الشيطان لإزالة اللباس بمفردة (ينزع) والهدف من النزع هو (ليريهما سوآتهما) ، بينما وصف الفعل الذي قامت به امرأت العزيز بمفردة (قدت) ولكن الهدف من القد ليس مصرحا به في الآيات وإنما هو من بنات أفكارنا. حتى ولو كان كذلك ، فالنتيجة هي ظهور الجزء العلوي من جسد يوسف! ولو كان الهدف هو إظهارها سوأة يوسف لكانت صياغة الفعل أظنها ستكون (ونزعت قميصه) مما لا يتناسب معه استخدام فعل النزع ، فهو استخدام في غير موضعه فجاء التعبير الأمثل بمفردة (قدت) ، كما أنها لو كانت كما ظنناها لاتجهت مباشرة نحو لباس يوسف لتنزعه وليس قميصه لتقده! مما يشير إلى أن الفعل الذي قامت به امرأة العزيز لا ينطوي على شبهة الوقوع أو نية الشروع في علاقة مشبوهة. وإذا كان كشف الجزء الأعلى من الجسم يعتبر عورة أو شروع في نية مشبوهة ، إذن فما أكثر من تبدوا أكتافهم وصدورهم بل وبطونهم أثناء نسكي الطواف أو السعي!! (نزع) و (قد) ليسا فعلين حركيين يتطلبان من الفرد الانتقال من مكان لآخر!.
الفرق بين مفردتي (قبل) و (دبر):
(قبل) و (دبر) مفردتين متناظرتين تشيران إلى الناحية الأمامية والناحية الخلفية من القميص.
فإذا كانت الآية الكريمة تشير إلى أن امرأة العزيز (قدت قميصه من دبر) بمعنى شقت قميصه من الخلف كما قالوا لنا ، فقد يكون تبريرا مقبولا فقط في حالة واحدة وهي إذا افترضنا ان الفعل (قدت) يعني (شقت) ، ولكن هذه الفرضية لا تصمد طويلا ، فحينما نتدبر الفعل (شق) في القرآن العظيم نجد أنه فعل يشير إلى المباعدة بين شيئين أو جعل الشيء يصبح جزئين كقوله تعالى (وانشق القمر) و (ثم شققنا الأرض) فلو كان الفعلان يحملان نفس المعنى لكانت صياغة الآية أظنها ستختلف فقد تكون على سبيل المثال (وشقت قميصه من دبر) ، ولكن هذا المفهوم لمعنى الفعل (شق) أيضا لا يستقيم في حالة يوسف ، إذ كيف يمكن ليوسف أن يشق قميصه من الأمام إن كان راغبا في استئناف هذه العلاقة المشبوهة ، فقد كان يكفيه مجرد خلع قميصه بكل يسر وسهولة بدل أن يشقه!..
إن الفعل (قدت قميصه) فعل ماضي ترتيبه جاء بعد أن همت به وهم بها أي بعد أن فرغت امرأت العزيز من مراودة يوسف دون أن تصل معه إلى نتيجة، فبعد الفراغ من أمر كهذا تعاد الأمور لمكانها والثياب لوضعها، وهو حسب ظني يعني “أغلقت” ولا يعني شقت. وإليك الدليل: (إن كان قميصه قد من قبل) أي إن كان قميصه أغلق من الأمام، فهو دليل كذب يوسف وصدق امرأت العزيز و (إن كان قميصه قد من دبر) أي إن كان قميصه أغلق من الخلف فهو دليل صدق يوسف وكذب امرأت العزيز لأنه لا أحد يمكنه أن يغلق قميصه من الخلف إلا بمساعدة من طرف آخر.
ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَٰذَا
يقول تعالى في سورة يوسف 93 : (ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ)..
ارجو التأمل في الكلمتين (يَأْتِ بَصِيرًا)......و (وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ)..
ألم يدخل يعقوب عليه السلام ضمن قول يوسف لإخوته : (وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ)..
فما دلالة الفعل (يَأْتِ) هنا؟. ..
من أين يأتي؟!..
دققوا..
إن المقصود أنه يعود مبصرا في التو واللحظة.
ولكن الفعل (يأتي) يظل له إيحاؤه .. فما دلالته؟.
إن يعقوب عليه السلام لم يكن غائبا فيأتي! فهو جالس مكانه لا يريم! ولكنه كان كالغائب.. فحين فقد بصره لم يكن (حاضراً) فيما حوله، يراه، ويتفاعل معه كما يتفاعل المبصرون! إنما كان (غائبا) ببصره عنه.. وحين يرتد بصيرا فإنه (يأتي).. يأتي من غيبته التى كان فيها، ويصبح (حاضراً) فيما يحيط به من أشخاص وأشياء..
وكلمة واحدة تعطى هذا المعنى العميق كله، وتجعل المشهد يتحرك بحركة (المجيء) بعد (الغياب)!..
ألا إنه إعجاز .
-
المطلب الثالث
القرائن
من الدرس السابق (البند سادساً) نستطيع التوصل إلى بعض من قواعد القانون الجنائي والتي منها القرائن.
اختلف الفقهاء في اعتماد القرائن وسيلة من وسائل الإثبات إلى فريقين، وليس المجال هنا لاستعراض الأراء حيث أنني أميل إلى الفريق الذي يرى أن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا، سيما أن هذا الراي ينسب إلى جماهير العلماء، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
وردت أدلة كثيرة في القرآن الكريم، تُشير بوضح إلى اعتماد القرائن الواضحة، وسيلة من وسائل الإثبات، ومنها:
أ- قوله تعالى: (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) [يوسف: 18].
وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
تُفيد الآية الكريمة أن إخوة يوسف عليه السلام أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم، لكن سيدنا يعقوب عليه السلام، لم يَقتنِع بدعواهم، وذلك لوجود قرينة أقوى، وهي عدم تمزق قميص سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف يأكله الذئب، دون أن يمزِّق قميصه؟! وهذه قرينة قاطعة، تدل على بطلان دعواهم، ولهذا استدل سيدنا يعقوب عليه السلام على كذبهم، بصحة القميص، وهذا دليل على اعتماد القرائن، وسيلة من وسائل الإثبات، وشرع من قبلنا شرع لنا، إذا جاء في شرعنا، ولم يرفع أو يرد في شرعنا ما يغيره.
ب- قال تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) [يوسف: 26 - 28] .
وجه الاستدلال:
تفيد الآيات بوضوح اعتماد قدِّ القميص وسيلة لمعرفة الصادق منهما من الكاذب في دَعواه، وهذا دليل واضح على اعتماد القرائن القاطعة وسيلة من وسائل الإثبات، وشرْع مَن قبلَنا شرعٌ لنا إذا جاء في شرعِنا ولم يَرِدْ في شَرعِنا ما يغيره.
ويستفاد مما سبق ما يلي:
أ- القرينة وسيلة من وسائل الإثبات، وهي تُغني عن الوسائل الأخرى وتقوم مقامها، كالشَّهادة سواء بسواء.
ب- القرينة وسيلة من وسائل دفع الدعوى.
جـ- يُعطى القاضي سلطة تقديرية في استِنباط القرائن، وخاصَّةً عند وزْنِ البيِّنات، وتكوين القناعة بشهادة الشهود.
وعليه فللقاضي أن يستنبطَ قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يَجوزُ فيها الإثبات بشهادة الشهود.
كما أن القرينة تعدُّ بيِّنة؛ لأنَّها تُظهِرُ الحقَّ وتبيِّنه؛ ولهذا تَندرِجُ تحت مفهوم قولِه - عليه الصلاة والسلام - البيِّنة على مَن ادَّعى؛ ويكونُ حجَّة القائلين باعتِماد القَرينة وسيلة من وسائل الإثبات، وبناءً على ذلك، وتَحقيقًا لمقاصد الشارع في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، فإنِّي أميلُ إلى اعتِماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق الشخصية والمدنية والجزائية، إذا كانت قاطعةً ومشروعةً، ولا يتطرَّق إليها الاحتِمال للأَسباب التاليَة:
1- قوَّة أدلَّة القائلين بها.
2- ضَعفُ أدلَّة المانِعين.
3- تَحقيق مقاصد الشارع بإقامة العدْل وحفظ الحقوق.
4- ولأنَّها بيِّنة تندرِجُ تحت مَفهوم قوله عليه السلام: ((البيِّنة على من ادعى)).
5- ولأنَّ القوانين المستمَدَّة من الفقه الإسلامي اعتمدتْها وسيلة مِن وسائل الإثبات.
إن الاعتماد على الأدلة والتي بناءً عليها أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها قد ينسفه محامي الاستئناف بعدما حكمت المحكمة بإدانة يوسف عليه السلام اعتمادا على القرائن وليس الأدلة. إذ أن القرائن لها دور قوي في الاستئناس والتَّرجيح، كما أن القرينة تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل قناعة القاضي عند وزن البينات، وهذا أمر لا خلاف فيه؛ لأنه يستند إلى منطق العقل.
مشروعيَّة إعمال القرينة في الأحكام
وأمَّا مشروعيَّة إعمال القرينة، فإن القرينة مشروعة في الجملة؛ لِما ورَد في قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾ [يوسف: 18]، قال القرطبي في تفسيره: "إنهم لَمَّا أرادوا أن يَجعلوا الدم علامة صِدقهم، قرَن الله بهذه العلامة علامةً تُعارِضها، وهي سلامة القميص من التمزيق؛ إذ لا يُمكن افتراسُ الذئب ليوسفَ وهو لابِسٌ القميصَ، ويَسلم القميصُ، وأجْمَعوا على أن يعقوب - عليه السلام - استدلَّ على كذبهم بصحَّة القميص، فاستدلَّ العلماء بهذه الآية على إعمال الأَمَارات في مسائل كثيرة من الفقه".
كما استدلُّوا بقوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [يوسف: 26 - 27].
على جواز إثبات الحُكم بالعلامة؛ إذ أثبَتوا بذلك كذبَ امرأة العزيز فيما نسَبته ليوسف - عليه الصلاة والسلام.
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم في صحيحه: ((الأَيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكر تُستأمر، وإذنها سكوتُها)).
فجعَل صُماتها قرينة دالة على الرِّضا، وتَجوز الشهادة عليها بأنها رَضِيت، وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن.
كما سارَ على ذلك الخلفاء الراشدون والصحابة في القضايا التي عرَضت، ومن ذلك ما حكَم به عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعثمان - رضي الله عنهم، ولا يُعلَم لهم مخالفٌ - بوجوب الحدِّ على مَن وُجِدت فيه رائحة الخمر، أو قاءَها؛ وذلك اعتمادًا على القرينة الظاهرة.
ومن أدلة إعمال القرينة في القضاء، ما أورَده النسائي في سُننه، قال - رحمه الله تعالى -: "باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يَفعله: أفْعَل؛ ليَستبين الحقُّ"، ثم ساقَ الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((خرَجت امرأتان معهما صبيَّان لهما، فعدا الذئبُ على إحداهما، فأخَذ ولدها، فأصبَحتا تَختصمان في الصبي الباقي إلى داود - عليه السلام - فقضى به للكبرى منهما، فمرَّتا على سليمان، فقال: كيف أمركُما، فقصَّتا عليه، فقال: ائتوني بالسِّكِّين أشقُّ الغلام بينهما، فقالت الصغرى: أتشقُّه؟ قال: نعم، فقالت: لا تَفعل، حظي منه لها، قال: هو ابنك، فقَضى به لها))، وصحَّحه الألباني.
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -:
"قال العلماء: يُحتمل أن داود - عليه السلام - قضى به للكبرى لشَبَهٍ رآه فيها، أو أنه كان في شريعته ترجيحُ الكبرى، أو لكونه كان في يدها، فكان ذلك مُرجَّحًا في شرْعه، وأمَّا سليمان - عليه السلام - فتوصَّل بطريقٍ من الحِيلة والملاطفة إلى معرفة باطنة القضيَّة، فأوْهَمها أنه يُريد قطْعَه؛ ليَعرف مَن يَشُقُّ عليها قطْعُه، فتكون هي أُمَّه، فلمَّا أرادَت الكبرى قطْعَه، عرَف أنها ليستْ أُمَّه، فلمَّا قالت الصغرى ما قالت، عرَف أنها أُمُّه، ولَم يكن مُراده أنه يَقطعه حقيقةً، وإنما أرادَ اختبار شَفَقتها؛ ليتميَّز له الأمَّ"، ثم قال النووي: "قال العلماء: ومثلُ هذا يَفعله الحاكم؛ ليتوصَّل به إلى حقيقة الصواب".
-
المطلب الرابع
التنازع الدولي من حيثُ الاختصاص التشريعي.
إن امتداد العلاقات القانونية بين الأفراد عبر الحدود يفرز جملة أوضاع منها حق الأفراد بالتمتع بالحقوق، واستعمالها، وأخيرا الحماية القضائية لها عند أثارة نزاع بين أطرافها.
وإذا كان التمتع بالحقوق عن طريق الجنسية أو الموطن، فان استعمال هذه الحقوق يثير موضوع التنازع الدولي بين القوانين ذات الصلة بهذه الحقوق، وهذا الاستعمال ترافقه ضمانات تتمثل بالحماية القضائية لهذه الحقوق والذي بأثرها يطرح تنازع آخر يصطلح علية بتنازع الاختصاص القضائي الدولي الذي يمثل الجانب الإجرائي لمشكلة تنازع القوانين.
ومثلما توجد قواعد حلول تنازع القوانين توجد قواعد لحلول التنازع بين المحاكم، كما أن تلك القواعد تمارس من خلالها المحكمة صلاحيتها في تسوية النزاع، مما يثر ذلك التساؤل عن أنواع الاختصاص القضائي الدولي، وطبيعة القواعد والإجراءات المتبعة في كل منهم، ولأجل الإحاطة بالموضوع سنبحث ذلك من خلال مبحثين:
فالأول: يتعلق ببيان المحاكم المختصَّة، بالنظر في القضايا التي تخصُّ المواطنين والأجانب، والحالات التي تُعتبر فيها المحاكم الوطنيَّة هي المعنيَّة بالنظر فيها، ولو كان حدوثها خارج البلد.
والثاني: يتعلق ببيان القانون الواجب التنفيذ، في حالة النظر في قضيَّةٍ لها علاقةٌ بأجنبيٍّ، أو وقعت في بلدٍ أجنبيٍّ، ولكن تمَّ النظر فيها في محكمة وطنيَّة .
وبناء عليه هناك نظريتان [ولهما تفصيلات] خلاصتهما:
1- إنَّ الأغلب أخذ [بإقليمية القوانين]، أي تطبيق قانون الإقليم الذي وقعت فيه الجريمة، وإن كان الفاعلون من الأجانب. مثل إخوة يوسف عليه السلام.
(ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ)
(دِينِ الْمَلِكِ) أي شرع الملك وقانون الدولة.. فما كان له ولا مما تبيحه أمانته لملك مصر أن يخالف شرعه الذي فوض له الحكم به وهو لا يبيح استرقاق السارق، فما كان بالميسور له أخذ أخيه من إخوته ومنعه من الرحيل معهم إلا بحكمهم على أنفسهم بشريعة يعقوب التي تبيح ذلك.
ولما كانت هذه الوسيلة إلى تلك الغاية الشريفة منكرة بحسب الظاهر، لأنها تهمة باطلة، وكان من شأن يوسف أن يتباعد عنها ويتحاماها إلا بوحي من الله - بين أنه فعل ذلك بإذن الله ومشيئته فقال:
(إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ) أي إنه فعل ذلك بإذن الله ووحيه، لا أنه هو الذي اخترع هذه المكيدة.
2- والبعض يأخذ [ بشخصية القوانين] … وخاصة في الدول التي للغير فيها امتيازات مفروضة ، أو ما كانت فيها امتيازات لأعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية .مثل أخو يوسف عليه السلام.
فيطبق عليهم قانون بلدهم الذي يلاحقهم أينما ذهبوا. فإنَّ الناس تسعى دوماً الى أن تبقى تحت حكم قانونها الشخصي.
(قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ) أي جزاؤه أخذ من وجد في رحله وظهر أنه هو السارق له وجعله عبدا لصاحبه، وقوله:
(فَهُوَ جَزاؤُهُ) تقرير للحكم السابق وتأكيد له بإعادته، كما تقول حق الضيف أن يكرم، فهو حقه، والقصد من الأول إفادة الحكم، ومن الثاني إفادة أن ذلك هو الحق الواجب في مثل هذا، وقد كان الحكم في شرع يعقوب أن يسترقّ السارق سنة.
(كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) أي مثل هذا الجزاء الأوفى نجزى الظالمين للناس بسرقة أمتعتهم وأموالهم في شريعتنا، فنحن أشد الناس عقابا للسراق.
وهذا تأكيد منهم بعد تأكيد لثقتهم ببراءة أنفسهم.
(فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ) أي فبدأ يوسف بتفتيش أوعيتهم التي تشتمل عليها رحالهم ابتعادا عن الشبهة وظن التهمة بطريق الحيلة.
(ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ) أي ثم إنه بعد أن فرغ من تفتيش أوعيتهم فتش وعاء أخيه فأخرج السقاية منه.
(كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ) أي مثل هذا الكيد والتدبير الخفي كدنا ليوسف، وألهمناه إياه، وأوحينا إليه أن يفعله.
3- الجمع بينهما
إنَّ سيَّدنا يُوسُف أدخل إخوتَه في الفخ ، فارتضوا قانونهم الذي يُطبِّقونه في بلادهم ، ألا وهو شريعـــة [ يعقوب ] .. حتى أنّهم:
(قالوا من وُجِد في رحله فهو جزاؤه كذلك نَجزي الظالمين)
فَأَخَذَ إقرارهم على رؤوس الأشْهاد، في أنَّ (العبودِيَّة) هي جزاء السارق في شريعتهم ، وأنَّهم راضون بما تفرضه شريعَتُهم ، بل أنَّ [ يوسف ] وأتباعه يُعدُوُن متفضلين، إذ سحبوا شريعة يعقوب ، وهي : [ قانونهم الشخصي ] ، إلى إقليم دولة [ الملك] !!..
-
المطلب الخامس
قواعد القانون الجنائي في سورة يوسف
العجيب أن هذه القصة تتضمن بيان قواعد ومبادئ قانونية راقية يعتمدها المحققون في كل الأزمنة والأمكنة من أجل كشف الجناة في الجرائم الجنائية في كل العالم المسلمين وغير المسلمين؟؟ حتى نعرف روعة معاني القران الكريم وبداعته وشموله لكل نواحي الحياة التي يحتاجها الإنسان ويتبين ذلك من خلال النقاط التالية:
1. بقع الدم الموجودة في مسرح الجريمة يعتبر دليلا مهما في كشف الجرائم ومرتكبيها كما بين ذلك قوله تعالى (وجاءوعلى قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) آية (17) سورة يوسف.
2. الشهود تعتبر من أهم الأدلة في كشف الجناة في ارتكاب الجريمة وتم تبرئة يوسف عليه السلام من جريمة الاعتداء الجنسي على امرأة العزيز عن طريق الشاهد الذي كان موجودا في مسرح الجريمة لقوله عزوجل (قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) آية (26) سورة يوسف.
3. الاعتراف يعتبر سيد الأدلة في كشف الجناة والمجرمين في الجرائم الجنائية ويتبين ذلك بوضوح من خلال الآيات الآتية(51-52)التي تنص على اعتراف (نسوة المدينة –وامرأة العزيز )لقوله تعالى (قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الئن حصحص الحق إنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ) وان الآيتين (91-97) التي تشمل اعتراف (أخوة يوسف) لقوله تعالى (قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين ) (قالوا ياابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين )إي أن ( نسوة المدينة –وامرأة العزيز – وأخوة يوسف ) اعترفوا ببراءة يوسف عليه السلام وارتكابهم جرائم بحق يوسف).
4. مكان وقوع الجريمة يعتبر مبدأ مهما في كشف الجريمة والجناة كما في آية (15) التي تتضمن مكان ارتكاب جريمة الشروع بقتل يوسف خارج البيت لقوله تعالى (فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) والآية (23) التي تبين ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي داخل بيت امرأة العزيز إي في منزل الزوجية لقوله تعالى (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي انه لايفلح الظالمون ) لان مكان ارتكب الجريمة وصفة المرتكب له أهمية في تشديد أو تخفيف العقوبة في القانون الجنائي .
5. كشف الكذب والتي يعتبر طريقة لكشف المجرم في ارتكاب الجريمة الآية (18) (و جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) التي تتضمن كذب (أخوة يوسف )على أبيهم بشأن أكل يوسف من قبل الذئب والثانية كذب( امرأة العزيز) بشأن محاولة اعتداء يوسف عليها.كما في الآية (25) (و استبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم).
6. الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة كما في آية (18-25-72) والتي تشير إلى أن أخوة يوسف استعملوا قميصه الملطخ بدم كذب لكي يقنعوا أباهم بقتل يوسف عليه السلام( وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون)آية (18) والثانية تمزيق قميص يوسف في قضية جريمة الاعتداء الجنسي من قبل امرأة العزيز (و استبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم)أية (25) والثالثة صواع الملك في قضية السرقة(قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) أية(72).
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا براعة وإعجاز القران الكريم في كل نواحي الحياة وإصلاحها لكل الأزمنة والأمكنة وبيانها في هذه السورة المباركة أهم المبادئ الأساسية في التحقيق في الجرائم الجنائية العالمية علما أن القران الكريم يحتوي على مبادئ قانونية أخرى رائعة مثل ( البصمة )ودورها في كشف الجرائم بمختلف أنواعها كما في سورة القيامة ( بلى قادرين على أن نسوي بنانه) لكونها تختلف من إنسان إلى أخر كما اكتشفها العلم الحديث وهذا يزيدنا ثقة واطمئنانا بإعجاز الآية القرآنية ( مافرطنا في الكتاب من شئ ) أي تطرق القران الكريم إلى كل جوانب الحياة إما بشكل مباشر أو غير مباشرو العاقل بالإشارة يفهم.
-
المطلب السادس
الطعن في الحكم القضائي
معنى الطعن في الحكم القضائي: إبطال العمل بالحكم القضائي الأول، والعمل بالحكم الذي يراه حقا سواء كان ذلك حكمه أم حكم قاضٍ سبقه.
مصطلحات قانونية
الطعن: إبطال العمل بالحكم القضائي الأول، والعمل بالحكم الذي يراه حقا سواء كان ذلك حكمه أم حكم قاضٍ سبقه، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهي المعارضة في الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.
والاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية إما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير.
والاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية.
إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما يؤدى إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية " الاستئناف ".
والنقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر ذلك الحكم. ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
واستئناف الأحكام القضائية بعد الحكم للحكم مرة أخرى قبل تنفيذها سنّة ماضية لتصحيح الحكم متى ما كان خطأ، ولا تبرأ الذمّة إلا به، سواء كان من قاضِ آخر أو رجوعاً من نفس القاضي الذي أصدر الحكم أولاً ، ومن أدلّة مشروعيّة النقض ما يلي :
1- في سورة يوسف نرى قضية الاستئناف واضحة بجلاء وذلك في قوله تعالى:
(وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ * قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ) سورة يوسف: 50 - 52
ففي الآية دليل على جواز الدفاع في أي وقت سواء اثناء النظر في القضية او بعدها فقد دافع يوسف عليه السلام عن نفسه عند القاء التهمه عليه قال تعالى : قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي .......(26).
وعندما ظن نجاة ساقى الملك قال تعالى : وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ......(42).
ودافع عن نفسه ايضا حينما ارسل له الملك قال تعالى : وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ .........(50).
فنقول هذا حق لا مرية فيه، ففي الشريعة الإسلامية ادله كثيره على مشروعية الدفاع عن النفس او العرض او المال او النسل او الدين .
كقوله صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد..... الى اخر الحديث.
وعليه فإن ما يفعله المستأنف في المحاكم المصرية اليوم هو نفسه ما فعله يوسف عليه السلام .
2 ـ نقضُ سليمان لحكم داود عليهما السلام قبل تنفيذه وحكمُ سليمان بحكم آخر ، وقد أقرّ الله ذلك في كتابه فقــــال : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ *فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ) الأنبياء: 78-79.
قال ابن حجر: ( وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق قال : كان حرثهم عنباً نفشت فيه الغنم ، أي رعت ليلاً ، فقضى داود بالغنم لهم ، فمرّوا على سليمان فأخبروه الخبر ، فقال : لا ، ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها ، ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردّوا عليهم غنمهم ) ( فتح الباري 13/148 ).
وقال ابن العربي عند تفسيره للآية الوارد فيها نقض سليمان لحكم داود عليهما السلام في ( أحكام القرآن 3/266 ) : ( في هذه الآية دليل على رجوع القاضي عمّا حكم به إذا تبيّن أنّ الحقَّ في غيره ).
3 ـ وقد يؤيد قاضي الاستئناف حكم الدرجة الأولى مثل ما حدث في قصّة الزُبْيَة – وهي الحفرة التي تُغطّى ليُصاد بها الأسد - ، فعن علي رضي الله عنه قال : (لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ حَفَرَ قَوْمٌ زُبْيَةً لِلْأَسَدِ ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى الزُّبْيَةِ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ ، حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً ، فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فِيهَا فَهَلَكُوا ، وَحَمَلَ الْقَوْمُ السِّلَاحَ وَكَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ : أَتَقْتُلُونَ مِائَتَيْ رَجُلٍ مِنْ أَجْلِ أَرْبَعَةِ إِنَاسٍ! تَعَالَوْا أَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ ، فَإِنْ رَضِيتُمُوهُ فَهُوَ قَضَاءٌ بَيْنَكُمْ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ رَفَعْتُمْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ . فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَجَعَلَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلرَّابِعِ الدِّيَةَ ، وَجَعَلَ الدِّيَاتِ عَلَى مَنْ حَفَرَ الزُّبْيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ ، فَسَخِطَ بَعْضُهُمْ وَرَضِيَ بَعْضُهُمْ ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ ، فَقَالَ قَائِلٌ : إِنَّ عَلِيًّا قَدْ قَضَى بَيْنَنَا . فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَضَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَضَاءُ كَمَا قَضَى عَلِيٌّ . فِي رِوَايَةٍ : فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَ عَلِيٍّ ). روا أحمد وغيره ، وصحّحه أحمد شاكر برقم 573 ، وساق الحديث محتجاً به ابن القيّم كما في ( زاد المعاد 5/13، وإعلام الموقعين 2/58) ، والمجد كما في المنتقى (2/699).
4- واستندوا أيضا على الدليل النقلي الآتي : ( إن عمر أتى بامرأة زنت، فأقرت، فأمر برجمها، فقال علي : لعل لها عذرا؟ ثم قال لها : ما حملك على الزنا ؟ قالت كان لي خليط ـ أي راع ترافقه إذا رعت إبلها، وفي إبله ماء ولبن، ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثا، فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج، أعطيته الذي أراد فسقاني، فقال علي : الله أكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)). الإمام القرافي ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والأمام ، ط2 ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، 1995م، هامش ص55..
يستدل من هذه الرواية بأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نقض الحكم القضائي الذي أصدره عمر، وهذا دليل عملي على جواز الطعن بالحكم القضائي.
-
المطلب السابع
http://www.ebnmaryam.com/vb/image/gi...EAAAICRAEAOw==تكييف الواقعة
أو ما يعرف بالحيل الفقهية ومشروعيتها
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ (73) قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76)
تفسير المفردات
آوى إليه: أي ضم إليه، والابتئاس: اجتلاب البؤس والشقاء، والسقاية (بالكسر) وعاء يسقى به، وبه كان يكال للناس الطعام ويقدر بكيلة مصرية 1 \ 12 من الإردب المصري، وهو الذي عبر عنه بصواع الملك، وأذن مؤذن: أي نادى مناد، من التأذين وهو تكرار الأذان والإعلام بالشيء الذي تدركه الأذن، والعير: الإبل التي عليها الأحمال والمراد أصحابها، زعيم: كفيل أجعله جزاء لمن يجىء به، الكيد: التدبير الذي يخفى ظاهره على المتعاملين به حتى يؤدى إلى باطنه المراد منه، ودين الملك: شرعه الذي يدين الله تعالى به.
الإيضاح
(وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ) أي ولما دخلوا عليه في مجلسه الخاصّ بعد دخولهم باحة القصر من حيث أمرهم أبوهم، ضم إليه أخاه الشقيق بنيامين، وقد حصل ما كان يتوقع يعقوب أو فوق ما كان يتوقع من الحدب عليه والعناية التي خصه بها.
(قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ) يوسف الذي فقد تموه صغيرا.
(فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي فلا يلحقنك بعد الآن بؤس أي مكروه ولا شدة بسبب ما كانوا يعملون من الجفاء وسوء المعاملة بحسدهم لي ولك.
روي أنهم قالوا له: هذا أخونا قد جئناك به، فقال لهم أحسنتم وأصبتم، وستجدون أجر ذلك عندي، فأنزلهم وأكرمهم، ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحده فبكى وقال لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه، فقال يوسف بقي أخوكم وحيدا، فأجلسه معه على مائدته وجعل يؤاكله، وقال أنتم عشرة فلينزل كل اثنين منكم بيتا (حجرة) وهذا لا ثاني له فيكون معى، فبات يوسف يضمه إليه ويشمّ رائحته حتى أصبح وسأله عن ولده، فقال لي عشرة بنين اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي هلك فقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال من يجد أخا مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل، فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال له: إني أنا أخوك إلخ.
(فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) أي فلما قضى لهم حاجتهم ووفاهم كيلهم جعل الإناء الذي يكيل به الطعام في رحل أخيه.
وفي قوله: جعل السقاية، إيماء إلى أنه وضعها بيده ولم يكل ذلك إلى أحد من فتيانه كتجهيزهم الأول والثاني لئلا يطلعوا على مكيدته.
(ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ) أي وقد افتقد فتيانه السقاية، لأنها الصواع الذي يكيلون به للممتارين فلم يجدوها، فأذن مؤذنهم بذلك أي كرر النداء به كدأب الذين ينشدون المفقود في كل زمان ومكان قائلا:
(أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) أي يا أصحاب العير قد ثبت عندنا أنكم سارقون، فلا ترحلوا حتى ننظر في أمركم.
(قالُوا: وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ؟) أي قال إخوة يوسف للمؤذن ومن معه: أي شيء تفقدون، وما الذي ضل عنكم فلم تجدوه؟.
(قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ) أي نفقد الصواع الذي عليه شارة الملك.
(وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) أي ولمن أتى به حمل جمل من القمح، وفى هذا دليل على أن عيرهم كانت الإبل لا الحمير.
(وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) أي قال المؤذن وأنا كفيل بحمل البعير، أجعله حلوانا لمن يحىء به، سواء أكان مفقودا أم جاء به غير سارقه.
(قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ) أي قالوا لقد علمتم بما خبرتموه من أمرنا وسيرتنا من حين مجيئنا في امتيارنا الأول وحين عودتنا إذ رددنا بضاعتنا التي ردت إلينا مع غيرها، أننا ما جئنا لنفسد في أرض مصر بسرقة ولا غيرها مما فيه تعدّ على حقوق الناس.
(قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ) أي قال فتيان يوسف لهم فما جزاء سارقه إن كنتم كاذبين في جحودكم للسرق وادعائكم البراءة والنزاهة؟.
(قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ) أي جزاؤه أخذ من وجد في رحله وظهر أنه هو السارق له وجعله عبدا لصاحبه، وقوله:
(فَهُوَ جَزاؤُهُ) تقرير للحكم السابق وتأكيد له بإعادته، كما تقول حق الضيف أن يكرم، فهو حقه، والقصد من الأول إفادة الحكم، ومن الثاني إفادة أن ذلك هو الحق الواجب في مثل هذا، وقد كان الحكم في شرع يعقوب أن يسترقّ السارق سنة.
(كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) أي مثل هذا الجزاء الأوفى نجزى الظالمين للناس بسرقة أمتعتهم وأموالهم في شريعتنا، فنحن أشد الناس عقابا للسراق.
وهذا تأكيد منهم بعد تأكيد لثقتهم ببراءة أنفسهم.
(فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ) أي فبدأ يوسف بتفتيش أوعيتهم التي تشتمل عليها رحالهم ابتعادا عن الشبهة وظن التهمة بطريق الحيلة.
(ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ) أي ثم إنه بعد أن فرغ من تفتيش أوعيتهم فتش وعاء أخيه فأخرج السقاية منه.
(كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ) أي مثل هذا الكيد والتدبير الخفي كدنا ليوسف، وألهمناه إياه، وأوحينا إليه أن يفعله.
ذلك أن الحكمة الإلهية اقتضت تربية إخوة يوسف وعقابهم بما فرطوا في يوسف واستحقاقهم إتمام النعمة عليهم يتوقف على أخذه بطريق لا جبر فيه ولا تقتضيه شريعة الملك، وبه يذوقون ألم فراق بنيامين ومرارته، فيما لا لوم فيه على أحد غير أنفسهم، ولن يكون هذا الحكم منهم إلا بوقوع شبهة السرقة على بنيامين من حيث لا يؤذيه ذلك ولا يؤلمه، وقد أعلمه أخوه يوسف به وبغايته. وفى هذا إيماء إلى جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما ظاهره الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف شرعا ثابتا.
ثم علل ما صنعه الله من الكيد ليوسف بقوله:
(ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) أي وما كان له ولا مما تبيحه أمانته لملك مصر أن يخالف شرعه الذي فوض له الحكم به وهو لا يبيح استرقاق السارق، فما كان بالميسور له أخذ أخيه من إخوته ومنعه من الرحيل معهم إلا بحكمهم على أنفسهم بشريعة يعقوب التي تبيح ذلك.
ولما كانت هذه الوسيلة إلى تلك الغاية الشريفة منكرة بحسب الظاهر، لأنها تهمة باطلة، وكان من شأن يوسف أن يتباعد عنها ويتحاماها إلا بوحي من الله - بين أنه فعل ذلك بإذن الله ومشيئته فقال:
(إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ) أي إنه فعل ذلك بإذن الله ووحيه، لا أنه هو الذي اخترع هذه المكيدة.
وليس من التقوى التحايل على إسقاط الواجبات، أو فعل المحرمات، بحجة إخراج الناس من الضيق، بل قد يكون التحايل على الأحكام الشرعية سببًا في الوقوع في المضايق.
وبناء عليه لابد للحيل الجائزة أو المخارج الشرعية من ضوابط تضبطها حتى تؤدي دورها، وحتى لا يقع المسلم في الحيل المحرمة، وهذه الضوابط هي:
1- أن تكون الحيلة متوافقة مع مقصد الشارع، وفيها تحقيق مصلحة شهد الشرع باعتبارها، وألا تهدم أصلًا شرعيًا، قال الشاطبي:"فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلًا شرعيًا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي". المرجع السابق 3/ 124.
2- أن يكون النظر في تقرير مصالح الحيل وموافقتها لمقصود الشارع للعلماء الشرعيين؛ "ليكون الناظر متكيفًا بأخلاق الشريعة، فينبو عقله وطبعه عما يخالفها"،. ولا يفتح المجال لغيرهم؛ لأن من كان جاهلًا بالأصول يكون بعيد الطبع عن أخلاق الشريعة، فيقع في مخالفتها بقصد أو دون قصد .نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي 9/ 4092.
3- ألا تتضمن إسقاط حق، أو تحريم حلال، أو تحليل حرام، قال ابن القيم:"وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب، وهي حيلة جائزة؛ فإنها لا تتضمن إسقاط حق، ولا تحريم حلال، ولا تحليل حرام إعلام الموقعين، لابن القيم 4/ 17.. وقد ذكر ابن القيم من هذه الحيل الجائزة مئة وستة عشر مثالًا. المرجع السابق 3/ 261-4/ 37.
الآيـــــات ذات الأحـــكام القانونيّة في السورة
بسم الله الرحمن الرحيم
} وقال يا بَنِيّ لا تدخلوا من بابٍ واحدٍ وادخلوا من أبوابٍ متفرقةٍ وما أُغني عنكم من الله من شيء إنْ الحكمُ إلا لله عليهِ توكلتُ وعليهِ فليَتَوَكَّل المتوكلون * ولمّا دخلوا من حيثُ أمرهُمْ أبوهم ما كان يُغْني عَنْهُم من الله من شيء إلاَّ حاجةً في نفسِ يعقوبَ قَضاهَا و إنّهُ لذو علمٍ لِّما علمناهُ ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمون * فلمَّا دخلوا على يُوسُفَ آوى إليهِ أخاهُ قال إنِّي أنا أخوك فلا تبتئِس بما كانوا يَعْمَلون * فلَّما جَهَّزَهُم بِجَهازِهم جَعَلَ السِقايَةَ في رَحلِ أخيه ثُمَّ أذّن مُؤذِّنٌ أيَّتُها العيرُ إنَّكُم لسارقون * قالوا وأقبَلُوا عَلَيْهِم ماذا تَفْقِدون * قالوا نَفْقِدُ صُواعَ الملِك ولمن جاء به حِمْلُ بعيرٍ وأنا به زعيم * قالوا تالله ما جِئْنا لنُفْسِدَ في الأرض وما كنَّا سارقين * قالوا فما جَزَاؤُهُ إنْ كُنْتُم كاذبين * قالوا جَزاؤهُ منْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فهو جَزاؤهُ كذلك نَجْزي الظَّالمينْ * فبدأ بأوعِيَتِهِم قبلَ وِعاء أخيه ثمَّ استَخْرَجَها من وِعاء أخِيه كذلك كِدْنا ليُوسُفَ ما كان لِيَأخُذَ أخاهُ في دين المَلِك ألاَّ أن يَشاء الله نرفعُ دَرَجاتٍ من نَّشاءُ وفوق كلِّ ذي علمٍ عليم * قالوا إنْ يَسْرِق فقد سَرَقَ أخٌ لَّهُ من قبلُ فأسَرَّها يُوسفُ في نَفْسِهِ ولمْ يُبْدِها لهُمْ قالَ أنتُم شرٌّ مكاناً والله أعلمُ بما تَصِفُونَ * قالوُا يا أيُّها العزيزُ إنَّ له أباً شيخاً كبيراً فَخُذْ أحَدَنَا مَكانَهُ إنَّ نَراكَ من المُحسنين * قالَ معاذَ اللهَّ أنْ نأخُذَ إلاَّ من وَجَدْنا مَتاعَنا عندهُ إنَّا إذاً لَظالمونْ * { . يوسف / 67 إلى 76 .
ويقول تعالى :
} ولقد همَّتْ بِهِ وهمَّ بها لوْلا أنْ رأى بُرهانَ ربِّهِ كذلك لنَصرِفَ عنْهُ السوُءَ والفَحشاءَ إنَّهُ مِنْ عِبَاِدنَا المُخْلَصِيِنْ * واسْتَبَقا البابَ وقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وألْفَيَا سيَّدَهاَ لدى البابْ قالتْ ما جَزاءُ مَنْ أرادَ بأهْلِكَ سُوُءاً إلاَّ أن يُسْجنَ أو عَذَابٌ أليم * قالَ هيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وشَهِدَ شاهدٌ مِنْ أهلِها إنْ كان قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وهُوَ مِنَ الكاذبِين * وإنْ كان قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وهُوَ مِنَ الصَادِقِين * فلَمَا رأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قال إنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إنَّ كَيْدَكُنَّ عظِيم * { يوسف / 24 إلى 27 .
إنَّ في هذه الآية من الأمور القانونية والفقهيَّة، أمور منها :
1- [ احتيال] سيّدنا [ يوسف عليه السلام ] ، بجعل السقاية في رحل أخيه ، تمهيداً لاتّهامه بالسرقة ، ومن ثم تنفيذ بقية ما رسمه في ذهنه !!..
2- [ احتياله ] بانتزاع رضاهم بتحكيم شريعة أبيهم [ يعقوب ] !..
3- [ احتياله ] بإبعاد الظنِّ منهم في كون الأمر مدبَّرٌ ، فيبدأ تفتيشه برحالهم .
فهل: [ الاحتيال ] جائز للأنبياء فقط ؟ أم هو جائز لنا ؟.
وهل : جوازُهُ أصلاً وابتداءً ؟ ، أم عن طريق الرجوع إلى شَرْعِ مَنْ قَبْلَنا ؟.. هذا هو موضوع المبحث الآتي
ونستطيع هنا أن نتكلم - بفضلِ الله - عن جملةٍ من مسائل القانون والشرع، في هذه الآيات، وكالآتي :شــرائعُ مَنْ قَبــْلَنا
مما لا شك فيه أنَّ الاستدلال بالآية لِمَا أردنا الاستدلال له، متوَقِّفٌ على الأخذ :
(بشرائع منْ قَبْلنا، إذا ذكرت في قرآننا ، من غير تصريح باعتداد أو إلغاء) . وهذا ما سنعود إليه بعد حين.
ويقول القرآن الكريم:
(ولمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون )
فهذا مجرد تطمين لأخيه حتى لا تذهب به الظنون كلّ مذهب بالنسبة لما هو آتٍ من الأحداث ، ليتحول بعدئذ القرآن العظيم في روايته لأحداث قصة [ يوسف ] عليه وعلى نبينا السلام ، إلى منعطف خطير، وهو الاحتيال، للوصول الى المطلوب .
بيان الحيل، وأنواعها ، وشروطها ..
الحيل الشرعيَّةِ ومشروعيتها
وهي على مبحثين:
-
المبحث الأول
الحيل التي اتَّبعها [ يوسف ] مع اخوته .!.
إن ّ[ احتيال ] سيّدنا يوسف لأجل أخذ أخيه عنده ، دون أمرٍ سلطوي ، أو إشعارٍ لهم بحقيقةِ شخصه .
و [ احتياله ] لإبعاد الشكِّ عن تدبيراته من أجل أخذ أخيه .
و [ احتياله ] لهم حتى يقبلوا بشريعة أبيهم لكي يُبقي أخاه عنده.
كلُّ ما تقدَّم ، أمرٌ يستحق التوقف والتأمل الفقهي ، لأجل الوصول الى حُكمٍ في مسألةٍ هي من أخطر المسائل حسَّاسيَّةً ، ألا وهي مسألة ما أطلق عليه ، أو قل ما اصطُلِح عليه:( بالحيل الشرعيَّة).
إنّ الاصطلاح لا مناقشة فيه ..إذ: [ لا مشَّاحة في الاصطلاح ] ، فالعبرة بحقيقة الأشياء لا بأسمائها ، فاختلاف الأسماء لا يُغيِّرُ مِن حقيقة المسميَّات ، وإن كان الأفضل تجنُّب الألفاظ المثيرة للإبهام والإيهام .
إنَّ لفظ [ الاستحسان ] أثار ما أثار بسبب الفهم المتعجل لمعناه ، ولو رجعنا إلى مقصود أصحابه منه لَما قيل الذي قيل فيه وفي المتَّخذين له دليلا، وما زال ذلك غُصَّةً في حلوق الطرفين : القائلين به ، والمنكرين له .
فلو اختار أصحابُهُ غيْرَ هذا الاسم لَمَا توَلَّد الالتباس ، ولو تأنى مُنْكِرُه لما لِيِمَ على حُكمهِ ، والله سبحانه وتعالى يقول : (… فتبينوا ... ) .
بعد هذا ينبغي أن نُشَخِّص ( الحيلة ) التي استعملها سيِّدُنــــا [ يُوسف ]عليه السلام ، حتى نستطيع الحكم عليها بمقبوليَّةٍ أو رفضٍ ، لكي يكون الكلام بعدئذٍ في مدى إمكان الأخذ بها في شريعتنا ، رغم أنَّها وردت في قرآننا العظيم ، على أنّها مِن تطبيقات الشرائع السابقة لشريعة نبيِّنا عليه أفضل الصلاة والتسليم .
لقد احتال لهم أول مرَّة :
(فلمّا جهّزهم بِجَهازِهِم جَعَلَ السقاية في رحْل أخيه ثمَّ أذنّ مؤذّن أيتها العيرُ إنّكم لسارقون )[15]فقد فعل هذا تمهيداً لاتِّهامهم بالسرقة.
ثم احتال لهم ثانيةً حين سألهم :
( .. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ..)
فلما أراد أن يستبقي عنده أخاه ، ولم يكن له من سبيلٍ في قانـــــون [ الملك ] ، سألهم عن شريعة أبيهم [ يعقوب] في مثل هذه الحالات ، فأخبروه باسترقاق المسروق منه للسارق ، إن ثبتت السرقة .
فاحتال لهم ثالثة :
(فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعـاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) .
فإبعاداً للظن والتُهمة ، بدأ بالتفتيش في غير رحل أخيه ، أو وِعاء السارق المجازي ، وهو أخاه . وهذا نوع [ احتيال ] .
إنّ هذا الاحتيال امتدحه الله سبحانه وتعالى بكونه هو فعل الذين رفع الله سبحانه وتعالى درجتهم بالعلم :
(..نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) .
فكان ( الكيد ) - أي التدبير - من الله سبحانه وتعالى ، هو الذي ألهم سيِّدنا يوسف ما فعل ، ولولا فعل سيِّدنا يوسف لما أخذ أخاه ، فهو ممن رفع الله درجته بهذا العلم !! ..
********
إنَّ في هذه الآية من الأمور القانونية والفقهيَّة ، أمور منها :
1- [ احتيال] سيّدنا [ يوسف عليه السلام ] ، بجعل السقاية في رحل أخيه ، تمهيداً لاتّهامه بالسرقة ، ومن ثم تنفيذ بقية ما رسمه في ذهنه !!..
2- [ احتياله ] بانتزاع رضاهم بتحكيم شريعة أبيهم [ يعقوب ] !..
3- [ احتياله ] بإبعاد الظنِّ منهم في كون الأمر مدبَّرٌ ، فيبدأ تفتيشه برحالهم .
فهل : [ الاحتيال ] جائز للأنبياء فقط ؟ أم هو جائز لنا ؟.
وهل : جوازُهُ أصلاً وابتداءً ؟ ، أم عن طريق الرجوع إلى شَرْعِ مَنْ قَبْلَنا ؟.. هذا هو موضوع المبحث الآتي. ..
-
المبحث الثاني
معنى الاحتيال .. وشروط الأخذ بها ..
والأدلة الشرعية لجوازها
نقول : الاحتيال هنا بمعنى التدبير ، وهو المسمى [ بالمُخْرِج ]الشرعي. وجمعه : مخارج ، ومفرده على صيغة اسم الفاعل .
ولقد سميَّت المخارج كذلك ، لأنَّها :
تُخرج من الضيق الذي فيه المكلَّف ، إلى السعة التي يبتغيها .
أمَّا الحيلة : فجمعها [ الحِيَل ] .
وهي : الحذق في التدبير، وتقليب الفكر للوصول إلى المقصود .
وفي الشرع ، لم يتعرض العلماء لوضع تعريفٍ اصطلاحي لها ، ولذلك فقد عرفناها بأنَّها هي :
الطريق لوصول المكلف إلى مُبتغاه ، من غير وقوعٍ في الحرام أو شبهته ، ومن غير إبطالٍ لواجبٍ ، أو خروجٍ على المقاصد العامَّة للشريعة ، أو الأصول العامَّةِ المعتبرة .
يقول شمس الأئمة السرخْسي في المبسوط :
[ .. فإنّ الحيل في الأحكام المُخرجةُ عن الآثام جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله ، وإنما كَرِه ذلك بعض المُتقشِّفة لجهلهم ، وقلَّة تأملهم في الكتاب والسنة ] .
نقلاً من : [ ملحق كتاب الحيل لمحمد بن الحسن ، طبعة ليبسك 1930 ، وأعادته بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد ] .
وجوازه ممّا ورد ذكره في هذه الآية ، وفي مواضِعَ قبْلَها ، ممّا يدل على جوازه في شرائع مَنْ قبلنا ، وقد أوضحناها قبلاً بالتفصيل.
ويؤيده ما ورد في قصة سيدنا [ أيوب ]عليه وعلى نبيّنا السلام،حيث حلف في أشد حالات مرضه وشدته :
إن أحياه الله لَيَضْرِبَنَّ امرأته مائة جلدة !! ..
وذلك لأمر ما عدّة كبيراً ، ويستدعي منه الذي نذره ، مِنْ وجهة نظره !! ، رغم أنَّها الوحيدة التي بقيت معه في محنته !!..
فلمّا أنجاه الله ، وقع في محنةٍ بين أمرين :
الأول : البِّر بيمينه ، وهو نبيٌّ لا يُخالف ، خصوصا بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء ، وزيادة المال والولد .
يقول تعالى : ( وأيّوب إذ نادى ربَّهُ أنِّي مسَّنيَ الضُرُّ وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضُرٍّ وآتيناهُ أهله ومثلهم معهم رحمةً مِن عِندِنا وذكرى للعابدين ).
الثاني : الوفاء لزوجه التي صاحبته في محنته ، بعد تخلى الجميع .. فأخرَجَهُ الله من ذلك [بحيلة ]علمَّها إياهُ ، أو قل هو :[ مُخْرِجٌ شرعيٌّ ].
يقول تعالى :( واذكُر عَبْدَنا أيُوبَ إذ نادى ربَّه أنِّي مسَّنيَ الشيطانُ بنُصْبٍ وعذاب * أُركُض بِرجْلِكَ هذا مغتسَلٌ باردٌ وشرابْ * ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمةً منَّا وذكرى لأولي الألباب * وخذ بيدك ضِغْثاً فاضرب به ولا تحنَث إنَّا وجدناهُ صابراً نِعْمَ العبـدُ إنَّه أوَّاب) .
أي : خُذ عُرجوناً قديماً ذا مائة شِمراخ ، فاضرب زوجتك بخفةٍ،ضربةً واحدةً تعوّض عن المائة ، فلا تُعدّ حينئذٍ حانثاً ، بل بارّاً بقسمك، ولا تعُد متنكِّراً لمن فاض جميلُها عليك في وقت محنتِك. !!..
والحيل الشرعيَّة .. للأخذ بها شروطاً، وهي :
1- أن تُخرج من الضيق الى السعة .
2- ألاّ تُؤدى الى ضياع حقّ من حقوق الله ، أو العباد .
3- ألا تُعارض أمراً قامت الحُجة على اعتباره في شريعتنا ، أو قاعدةٍ من القواعد المعروفة في الشريعة ، أو أصلاً من الأصول .
فمن ضياع الحقوق : أنْ يعلِّم بعض الماجنين من المفتين ، من وجبت عليهم الزكاة ، وبقي بينهم وبين شرط [ حولان الحـول ] أيام ، يعلّمون أولئك بالتصدّق بجزء يسير يَثْلِم النصاب ، مقابل سقوط الكثير .
فمن ملك عشرين مثقالاً من الذهب ، فعليه نصف مثقال ، فلو تصدّق [ بحبةٍ ] ، فإنّ النصاب سوف يقلُّ عن حدِّه الأدنىِّ ، وبالتالي فلا زكاة .. والفرق بين الحبة ونصف المثقال كثير!! ..
وما قامت الحجة على مراعاته في شريعتنا : حرمة الربا ، فقيام بعض الماجنين بتعليم المُقرضِين أن يبيع المقترض سلعةً نقداً ، ثم يشتريها بثمن أعلى مُنَسَّئاً ، فتعود له سلعتُهُ و يكونُ مديناً بالفرق بين الصفقتين ، وهو في حقيقته ربا الاقتراض ، المعروف بربا النسيئة .
فكل هذا و ذاك هو من: [ العلم الذي يُعلَم ولا يُعَلَّم ] .
وهو احتيال مرفوض ، ويكون اُلمفتي من هذا القبيل ، مستحقـاً للحَجْر.. أي : [ المنع ] ، باعتباره واحداً من ثلاثة جوّز الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الحجر عليهم ، استثناءً من مبدئه في عدم الحجر بعد سن الخامسة والعشرين ، وهم :
أ. [ المفتى الماجن ] الذي : يعلِّم الناس الحيل .
ب.[ والمتطبب الجاهل ] الذي : يؤذي الناس بجهله .
ج.[ والمُكاري المفلس ] الذي: لا يستطـيع الإيفاء بالتزامـاته ، ويكتفي بأخذ المال مع عدم القدرة على الوفاء .
فالأخذ [بالحيل ] أو المخارج ، بشروطها ، كان استدلالاً بفعل سيِّدينا : [ يوسف ، وأيوب ] عليهما السلام .
وكلّ هذا من شرع من قبلنا الذي سكت عنه قرآننا ، فأخذنا به لعدم مخالفته قاعدةً شرعيةً ، أو نصاً من النصوص ، أو أمراً معلوماً من الدين بالضرورة .
ولهذا فقد استدلّ الأحناف لجواز[ الحيل ] ، بما يأتي :
أ. من القرآن الكريم :
1. ما ورد عن سيِّدنا أيوب ، وقد تقدم .
2. ما ورد عن سيِّدنا يوسف ، مما نحن بصدده .
3. ما ورد على لسان سيِّدنا موسى ، حين قطع وعداً للرجل الصالح ، حيثُ قال :
( قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا ).
فقد احتال سيِّدنا موسى لنفسه ، خشية عدم قدرته على الصبر، فأتى بالاستثناء ، وهو قول : [ إن شاء الله ] .
ولم يُعاتَبْ على ذلك ، لأنه استعمل مُخْرِجاً صحيحا .. فلا يُعدُّ حانثا إن لم يَسْتطع الصبر !! ..
ومن السنة النبوية الشريفة :
1. روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، قال يوم الأحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة :
(فلعلَّنا أمرناهم بذلك ) .
فلما قال له عمر رضي الله عنه في ذلك ، قال عليه السلام:
( الحرب خدعة ) .
وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم اكتساب حيلة ، ومُخرج من الإثم ، بتقييد الكلام [ بلعلَّ ] .
2. أتى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبره أنَّه حلف بطلاَّق امرأته ثلاثاً أنْ لا يُكلِّم أخاه ، فقال له رسول الله عليه السلام :
( طلِّقها واحدةً فإذا انقضت عدَّتها فكلِّم أخاك ، ثم تزوجها )
وهذا تعليمٌ للحيلة صادر عن رسول الله عليه السلام !! .
قال السَرَخْسي : [.. والآثار فيه كثيرة ] .
ثم أورد السرخسي جملةً من الأمور المشَّرعة في شريعتنا ، وحقيقتها حيلٌ توفرت فيها الشروط التي أوردناها ، فيقول :
[ ومن تأملَّ أحكامَ الشرعِ ، وجد المعاملات كُلَّها بهذه الصفة ...
فإنَّ من أحبَّ امرأةً ، إذا سأل فقال : كيف لي أنْ أصِل إليها ؟.
يقال له : تزوجها .
وإذا هوى جاريةً ، فقال : ما الحيلة لي في أن أصل إليها ؟.
يقال له : اشْتَرِها .
وإذا كره صحبة امرأةٍ ، فقال : ما الحيلة لي في التخلص منها ؟ .
قيل له : طلِّقها .
وبعد ما طلقها إذا ندم ، وسأل الحيلة في ذلك ؟ .
قيل له : راجعها .
وبعد ما طلَّقها ثلاثاً ، إذا تابت من سوء خُلُقِها ، وطلبا حيلةً .
قيل لهما: الحيلة في ذلك ، أن تتزوج بزوجٍ آخر ، ويدخل بها ].
. ثم قال : [ فمن كره الحيل في الأحكام ، فإنَّما يكره في الحقيقة أحكام الشرع ، وإنَّما يوقع في مثل هذا الاشتباه ، من قلَّة التأمل .
فالحاصل أنَّ ما يتخلص به الرجل من الحرام ، أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل ، فهو حسن . وإنَما يكره من ذلك :
أن : يحتال في حقٍّ لرجل حتَّى يُبطله .
أو : في باطل حتَّى يُموِّهه .
أو : في حقٍّ حتى يُدخل فيه شُبْهةً.
فما كان على هذا السبيل فهو مكروهٌ. وما كان على السبيل الذي قلنا أولاً ، فلا بأس به. لأن الله تعالى قال :
(وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).
ففي النوع الأوَّل معنى التعاون على البر والتقوى .
وفي النوع الثاني معنى التعاون على الإثم والعدوان ] .
ثمَّ أورد أدلةً أخرى ، تجدها مبسوطةً في المبسوط ، ولو استوفيناها لخرجنا عن المقصود .
لقد أكثر الأحناف من استعمال [ الحيل ] ، حتى ظنَّ الظانُّون أنهـم في أحكام الدين متساهلون !! ، وليس الأمر كما يُخيل للبعض ، بل هو استعمالٌ للمخـارج توسعةً على المكلفين ، على النحو الذي بينَّاه ، وليس من السهل أن يتضح الأمر لكل أحدٍ ، خصوصاً بعد شيوع استعمال لفظة [ الحيلة ] في غير الممدوح من الأمور .
ومن شدة اهتمامهم بهذا الفن من فنون الفقه ، وهي متنوعةٌ ، فقد أفرده بالتأليف الإمام : محمد بن الحسن الشيباني ، تلميذ الإمام أبي حنيفة ، والذي حفظ أصول مذهبه وفروعه ، بكثرة مدوَّناته المتداولة ، وسمَّى كتابه ذاك [ المخارج في الحيل ] .
-
المطلب الثامن
حق المتهم في الدفاع عن نفسه
إن قاعدة افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، قد وُجدت في الشريعة الإسلامية من مدة تزيد على أربعة عشر قرناً، حيث جاءت بها نصوص القرآن والسنة، وبهذا فقد امتازت هذه الشريعة على القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، حيث أدخلت في القانون الوضعي الفرنسي كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية، وقُررت لأول مرة في المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان الصادر عام1789م، ثم انتقلت القاعدة من التشريع الفرنسي إلى التشريعات الوضعية الأخرى، حتى أصبحت قاعدة عالمية في القوانين الوضعية كلها.
وتطبيقاً لهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، فعليه أن يثبت وقوع الجريمة من المدعى عليه (المتهم) ومسؤوليته عنها، عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-:”البينة على من ادعى”، ولا يوجد أي التزام على المتهم من حيث المبدأ لإثبات براءته، فهو في نظر الجميع يعتبر بريئاً حتى يُدان، غير أنه ليس هناك ما يمنع المتهم من المساهمة في إثبات براءته بتقديم الأدلة والبيانات للقضاء التي من شأنها نفي التهمة ودرء المسؤولية الجنائية عنه، أو التعبير عن قيام سبب من أسباب الإباحة، أو انعدام المسؤولية أو أي عذر من الأعذار الشرعية.
وبناء عليه فإن حق الفرد الذي اتهم في دينه وعرضه وسلوكا ظلما كيوسف عليه السلام أن يدافع عن نفسه تجاه من ظلمه، ويرفع صوته جاهزا بالحق مثل قول يوسف عليه السلام (هي راودتني عن نفسي) في مواجهة الحاكم، بل أباح الله تعالى له ما لم يبح لغيره، رعاية لظرفه، وذودا عن حرمته، حين قال الله تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم}(النساء:148)، ولا يجوز لأحد منع التهم من الدفاع عن نفسه، فهذا حق طبيعي وشرعي، وقد أعطى الله الحرية لإبليس اللعين ليجادل عن نفسه أمام رب العالمين، ويقول عن آدم:"أنا خير منه" كما جعل من حق كل نفس يوم القيامة أن تجادل عن نفسها.
فحق المتهم في الدفاع عن نفسه من أهم المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة بين الخصوم، كما ان مبدأ حق المتهم في سماع مقاله أمام القضاء، وهو حق أصيل يجب ألا يصادر تحت أي مصوغ، لأن لكل صاحب حق مقالاً، والأصل في ضرورة تمكين المتهم من سماع مقاله قبل الحكم عليه، حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب عندما بعثه إلى اليمن قاضياً، فعن علي -كرم الله وجهه- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله تُرسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء..؟ فقال :”إن الله سيهدي قلبك ويُثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، أحرى أن يتبين لك القضاء” قال: مازلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.
من هذا الحديث يتضح لنا أنه يجب على القاضي ألا يصدر حكماً على المتهم حتى يسمع مقاله، وإذا ما حكم القاضي دون سماع أقوال المتهم كان حكمه باطلاً، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الحكم قبل سماع حجة المتهم، والنهي يُفيد فساد المنهي عنه، فحضور المتهم لإبداء دفاعه شرط لصحة القضاء، ففي القضية التي تسور فيها الخصمان المحراب على نبي الله داود -عليه السلام- ليحكم بينهما بالعدل، وكان المدعي قوي الحجة، إذ قال فيما نص عليه القرآن على لسانه:(إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب) وأمام هذه الحجة الظاهرة حكم له النبي داوود دون سماعه لحجة المدعى عليه(المتهم)، كما جاء في قوله تعالى:(قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات….).
ولما كان هذا الحكم قد صدر بدون سماع حجة طرفي الخصومة، فإن داود قد شعر بخلل حكمه فسارع إلى الاستغفار والتوبة، كما قال تعالى:( وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) وكان هذا من الله توجيهاً لنبيه داود، وإنذاراً لمن يتولى القضاء بين الناس في الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأن الحكم بظاهر حجة خصم دون سماع حجة الخصم الآخر، هو ميل عن الحق وإتباع للهوى يترتب عليه العذاب الشديد يوم القيامة، كما قال تعالى في كتابه الكريم:(يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب).
-
المطلب التاسع
قضيتي الثبوت والتحاكم
الفرع الأول
هذه القضية من أهم القضايا الجنائية..ولنأخذ الأمثلة التالية:
امرأة العزير مع يوسف عليه السلام
فال هي راودتني عن نفسي:
واقعة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز عندما راودته عن نفسه لم تكتمل فيها أركان التحاكم الرئيسية فكانت:
امرأة العزيز وزوجها (طرف) ويوسف عليه السلام (طرف).
أي متنازعان فلم ترتقع القضية لجهة ثالثة لكي تفصل فيها.
إن شرف المرأة وعرضها هو عرض لزوجها يدافع عنه، وهو تبع له ولهذا فإن العزيز هو خصم يوسف في هذا الموضوع وليس طرفا ثالثا لأن الأمر يخص عرضه وشرفه، ومما يُدل على ذلك ما قبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قوله: ( ما بال رجالٌ يؤذونني في أهلي..) في حديث الإفك الشهير. فقد نسب الأذى على نفسه مع أن الكلام كان عن زوجته رضي الله تعالى عنها.
فيوسف عليه السلام قد حكم عليه العزيز خصمه بالسجن لأنه كان في مركز قوة ولم تحكم عليه جهة ثالثة رفع إليها الخصمان القضية للفصل فيها بل الذي أمر بسجن يوسف هي امرأة العزيز لا زوجها وما جاء في نص الآية واضح وصريح (ما جاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم). وقوله تعالى ( (وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) وقول العزيز في ذلك (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ)..
فسبحان الله ما أوضح البيان وكيف عمت عنه العينان ولكنها (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ).
فلم يحكم العزيز عليه أصلا بشيء فضلاً أنه لا يمكن أن يكون حكما في قضية هو خصم فيها.
ثانيا: قصية يوسف عليه السلام قضية ثبوت وليست قضية حكم والفرق بين الثبوت والحكم واضح فكل حكم ثبوت وليس كل ثبوت حكم، إذ أن الحكم يحتاج إلى حاكم وإلا لم يكن حكما. أما الثبوت فلا يشترط فيه وجود الطرف الثالث (الحاكم).
قال ابن القيم رحمه الله : في الطرق الحكمية ج5 ص 1بعنوان ( دعوى قتل أبي جهل).
ومن ذلك أن معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفكما؟.
قالا :لا
قال: فأرياني سيفيكما فلما نظر فيهما قال:
لأحدهما هذا قتله وقضى له بسلبه وهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع والدم في النصل شاهد عجيب) ص 762 برقم 4020 كتاب المغازي، وصحيح مسلم ص748 برقم 1800، كتاب الجهاد والسر، باب قتل أبي جهل.
فقوله صلى الله عليه وسلم : هل مسحتما سيفيكما..إلى أن قال. هذا قتله..هذه هي قضية الثبوت التي يكون الرجوع فيها إلى خبير أو عالم ولو كام مشركا.
وقوله : وقضى له بسلبه هذا هو الحكم أو القضاء الذي لا يجوز الرجوع فيه إلا لحاكم يحكم بشرع الله ويشترط فيه الإسلام.
والناظر المنصف لحادثة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز يجد أنها قضية ثبوت وليست قضية تحاكم.
وقد يطلق على الثبوت حكم من ناحية لغوية..
أما من حيث الاصطلاح هو أن الثبوت يحتاج إلى خبير أو حكيم..
فالمرجع في الغالب الخبرة والفطنة والدراية..
أما الحكم فهو يشترط فيه الرجوع فيه لحكم الله سبحانه وتعالى والمحكم فيه مسلم.
فمن لم يفرق بين التحاكم وبين النزاع معه وبين قضية الثبوت اختلطت عليه الأمور ووقع في المحظور.
فمرحلة الثبوت تسبق مرحلة الحكم وليست منها وإن كانت من لوازمها.
1- مرحلة الثبوت
(وتشمل تحرى القرائن والبينات وسماع الشهود وإعذار المتهم أيضا , مثل قول القاضى هل هناك من يشهد معك بهذا ؟ وغير ذلك).
2- ثم مرحلة الحكم.
3- ثم مرحلة التنفيذ.
وقد يسمى كل ذلك حكما مجازا ولكن الحقيقة أن مرحلة الثبوت ليست حكما وإن كانت غالبا ما تفعل كمقدمة له وقد تنتهى به.
ومن أمثلة إطلاق لفظ الحكم عليها مجازا بالرغم من أنها ليست حكما، تفسير العلماء لقوله تعالى( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا )بقولهم وحكم حاكم من أهلها فجعلوا ذلك حكما باعتبار أنه يظهر الحق ويجلوه لا من باب أنه كان حكما فعلا لأن هذا كان في مرحلة الثبوت وليس في مرحلة الحكم.
الفرع الثاني
ومن أمثلة محاولة إثبات البراءة بالبينات في مرحلة الثبوت سواء أمام المسلمين أو الكفار:
قوله تعالى " واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها " وكان ذلك من إخوة يوسف عليه السلام دفعا لتهمة متوقعة يتهمون بها لرجوعهم بدون أخيهم وكان ذلك منهم أمام نبي الله يعقوب عليه السلام .
وقوله تعالى " قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ " وكان ذلك من إخوة يوسف عليه السلام واستخدموا لإثبات ذلك القسم دفعا للتهمة منهم أمام يوسف عليه السلام بالرغم من أنهم يظنون أنه عزيز مصر وعلى دين قومها .
وقوله تعالى : " وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا " وكان هذا بينة منه أظهرها الشاهد للعزيز لكى يمكنه من الوصول إلى الحقيقة .
وقوله تعالى " قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ " وكانت مخاطبة الملك لهن بالإدانة رغبة منه في مباغتتهن بالحقيقة ليعترفن بها , وكان ذلك منه بالرغم من أنه كان كافرا على الراجح من كلام أهل العلم , وقد فعل ذلك لأنه كان موقنا ببراءة يوسف عليه السلام وصدق وصفه لما سجنوه من أجله أنه من كيدهن وهذا بديهي بعد أن صدقه في تأويله رؤياه .
و مرحلة الثبوت هذه مثل إظهار البينة أو التحقق من التهمة تشمل كل ما يحاول به القاضي أو من يقوم قبله بذلك من سؤال الشهود و المتهم والبحث عن قرائن وبينات أو استخلاصها أو إعذار المتهم بطلب شهود النفي منه .
ومثل ما تقوم به حاليا النيابة ويسمى التحقيق وما يقوم به الخبراء وغيرهم من الهيئات التي تختص بإظهار القرائن والبينات و ليست على الحقيقة هيئات حكم وقضاء .
وذلك حتى يتمكن القاضي من الحكم بما يرى أنه الحق بحسب دينه في مرحلة الحكم، فإن كان دينه الإسلام فسيحكم بالأحكام الشرعية حيث هو يتعبد الله بذلك، وإن كان دينه غير الإسلام فسيحكم بما يوافق دينه من قوانين وأحكام بلده.
الفرع الثالث
وقوله عليه السلام كما ذكره تعالى : " قال هي راودتنى عن نفسى " إنما رد التهمة عن نفسه بما يفيد إنكارها وكان ذلك في مرحلة التثبت من التهمة وهذه مرحله يعرف كل من له علم بكتب القضاء أنها تسبق مرحلة الحكم وليست منها , والآية تدل على أنه يمكنك أن تدفع عن نفسك تهمة في مرحلة الثبوت وهذا من باب إثبات براءة الذمة الأصلية التي تستصحب لكل البشر , بل إن إتهام امرأة العزيز ليوسف ورد يوسف عليه السلام عليها وشهادة الشاهد وهى قرينة ثبوت التهمة , كل ذلك لم يتجاوز مرحلة التثبت من التهمة ,
أما عن واقعة سجن يوسف عليه السلام نفسها , فكانت من العزيز وامرأته والنسوة في مرحلة لاحقة لتلك الواقعة التي اتهمته فيها إمراة العزيز بمراودتها , وكان ذلك بعد ذيوع وانتشار قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام بين الناس , وهذا لابد وأن يستغرق وقتا لانتشاره , وعندما رأوا سجنه كانوا جميعا خصومه فسجنوه لما رأوا الآيات , فكانوا هم الخصم والفاضي وهذا أيضا ليس صورة من صور التحاكم .
- ومعلوم أن طلب الحكم بالبراءة غير اشتراط البراءة , ففي الأولى ( طلب الحكم ) خطوات لابد أن تتم كما في كل قضاء , وذلك يكون باستدعاء الخصوم والشهود وسؤالهم في مرحلة الثبوت قبل مرحلة الحكم ويكون القاضي فيها مظهرا الحيدة التامة مع طرفي الخصومة , وهذا لم يكن ليتم ويوسف في السجن , بل لابد للملك أن يحضره إلى مجلس القضاء , ولم يكن لديه ما يمنعه من الحضور بعد أن أمر الملك بإخراجه , ويحضر أيضا امرأة العزيز والنسوة ويبدأ التحقيق في المنازعة , وهذا لم يحدث بل إن الملك أخذ كلاما فيه الكثير من التعريض لا التصريح من يوسف وخاطب به النسوة وامرأة العزيز بينهن بالإدانة وهذا يعد محاباة وليست قضاءا , فما الذى حدث إذن ؟.
-الذى حدث هو أن الملك أراد يوسف نفسه لا أراد مجرد خروجه , والدليل هو أنه لما رجع إليه الساقى بتأويل رؤياه , أمره بإحضار يوسف إليه لا بمجرد إخراجه من سجنه : " وقال الملك ائتونى به " ثم يبدوذلك أكثر وضوحا بعد أن نفذ الملك ما إشترطه يوسف لخروجه من إظهار براءته , فعاود الملك طلبه بمجرد الإنتهاء منها , وأظهر علة ذلك الطلب هذه المرة :" وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى " ..
- كما أن الملك كان يصدق يوسف بعد تأويله رؤياه في كل ما يقوله , فليس بعد تصديقه له في تأويل الرؤيا يمكن أن يكذبه في شيء أو حتى يشك في صدق كلامه , ولذلك لما أرسل له يوسف " قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن عليم " صدقه في أن ذلك كيد منهن وأيقن ببراءته , وجمع النسوة لا ليحقق معهن وهو موقن ببراءة يوسف , بل جمعهن ليواجههن بالإدانة التي هو موقن بها :" قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه " فيبهتهن ويظهرن براءة يوسف عليه السلام .
وقد كان ما أراده :" قلن حاش لله ما علمن عليه من سوء ".
وكذلك فعلت امرأة العزيز : " قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ".
وبتحقق ذلك وكما أراده يوسف واشترطه لخروجه من سجنه , خرج فعلا إلى الملك الذى كان ينتظر ذلك ليستفيد من يوسف في تدبير شئون مملكته في الأزمة المتوقعة طبقا لتأويل يوسف نفسه , والدليل على ذلك قوله تعالى : " وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين " وكان رد يوسف علي السلام دليلا على ما ذكرت أيضا , حيث اختار مخازن الغلال لكى يباشر بنفسه معالجة الأزمة المقبلة : " قال اجعلنى على خزائن الأرض إني حفيظ عليم " ..
- فكان تكييف ما حدث هو استعانة من يوسف عليه السلام بالملك لما أحس بحاجته إليه في إظهار براءته وليس أدل على ذلك من أن إظهار براءة يوسف عليه السلام لم تكن بحكم من الملك, بل كانت باعتراف صريح من النسوة وامرأة العزيز:
" قلن حاش لله ما علمن عليه من سوء "
" قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين "
الفرع الرابع
إثبات البراءة في مرحلة الثبوت لا يلزم منه الإقرار بمرحلة الحكم إذا لم تكن طالبا لها.
وفى هذه المرحلة - مرحلة الثبوت - يجوز للمتهم أن يحاول إثبات براءته أو إثبات خلو ذمته مما اتهمه به غيره، أي يحاول إثبات بقاء ذمته على البراءة الأصلية.
مثل قول يوسف عليه السلام : " قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي " " .
فقوله لا يتعدى ما ذكر في النص من أنه نفى للتهمة عن نفسه في مرحلة الثبوت في تهمة كانت امرأة العزيز هي من أراد أن يحاكمه للعزيز بها بالرغم من أنها لم تتم كمحاكمة فلم تتعد مرحلة الثبوت للآتى :
أن العزيز لم يحكم ببراءته وانما تأكد من براءته ببينة الشاهد " وشهد شاهد من أهلها " وكان قوله " يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ، " وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ فضا منه للأمر على استحياء بغير فصل , فلا هو حكم ببراءة يوسف لأن الحكم ببراءة البريء يلزم منه معاقبة الجاني الحقيقي وهو لا يريد أن يعاقب زوجته , أو لأن عقابها كان سيفضحه , فلا هو عاقبها ولا هو كابر في الحق بعد ما تبين له وأقر زوجته على اتهامها ليوسف عليه السلام بالباطل لأن ذلك كان يستلزم منه أيضا أن يعاقب يوسف بالسجن كما طلبته زوجته , ولم يفعل ذلك , قيل لأنه كان يحب يوسف ولما تأكد من براءته وعدم خيانته له في زوجته آثر عدم معاقبته , ولذلك انتهى الأمر في صورة توصيات كما ذكرت الآيات " يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا " ، " اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ" " وليس حكما فيه معاقبة أحد الطرفين بدعوى أنه الجاني.
فأين حكم العزيز المزعوم في هذه المسألة .
وأيضا في الثانية في قول يوسف عليه السلام كما ذكره سبحانه :
" قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ " " وهو فتح ملف القضية من جديد للحكم ببراءته.
فتأويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك خاصة بعد فشل ملئه في ذلك جعله الله سببا لإظهار براءته من عدة أوجه :
أن الملك علم منها أن يوسف صادق فيما يقول بدلالة ما أخبره الساقي من صدق تأويله قبل ذلك , وبدلالة تصديقه تأويل يوسف لرؤياه والتي علم منها وأيقن تبعا لذلك التأويل بحجم ما هو مقدم عليه هو ومملكته من محنة , وأن الذى يمكن أن يعبر به وبمملكته تلك المحنه هو من أول الرؤيا نفسه , فأرسل في طلبه ولم يرسل بمجرد إخراجه من السجن مكافاة له كما ذكره تعالى " وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ "
أن يوسف عليه السلام علم من لهفة الملك على طلبه حاجة الملك إليه , فأراد أن يستعين به في إظهار براءته على الملأ.
" فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن عليم "
فبمجرد أن أرسل برسالته مع رسول الملك يلمح بأن سبب سجنه كيد النسوة وامرأة العزيز من بينهن معرضا بها غير مصرح حفظا لغيبة سيده , جمعهن الملك وخاطبهن بالإدانة تصديقا ليوسف عليه السلام في مجرد تلميحه وإشارته إلى الكيد منهن " إن ربى بكيدهن عليم " , جمعهن وخاطبهن بالإدانة " قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ " ".
والذى أعلن براءة يوسف وأثبتها في الواقع ليس حكما من الملك بل هو اعترافا من النسوة بها :
" قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ".
و اعترافا أيضا من امرأة العزيز بها :
" الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ".
ولم يحكم له الملك بالبراءة لأنه كان يعرف انه بريء وهذا هو السبب في أنه لما جمع النسوة وامرأة العزيز ,خاطبهن بالإدانة ولم يسألهن حتى سؤال المحقق في مرحلة الثبوت" قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ " فهو حتى لم ينصب نفسه قاضيا يريد أن يتثبت من براءة يوسف عليه السلام تمهيدا للحكم بها , لأنه كان موقنا بها , وعلى ذلك لم يفعل ما يفعله الحكام أو القضاة فلم يقم بسؤال طرفي الخصومة مثلا , أو طلب الإعذار (شهود النفي أو الإثبات )منهما أو من أحدهما , بل توجه بالإدانة لأحدهما تصديقا للآخر وعملا بما يريده حتى يخرج إليه تصديقا له و احتياجا له ليصطفيه لنفسه ويجعله من خاصته , ولذلك لما انتهت النسوة وامرأة العزيز من إعلان براءته أخرج الملك إلى أرض الواقع حقيقة ما في نفسه بالنسبة ليوسف فقال كما ذكره عزوجل " وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ".
يراجع في ذلك:
كتاب انوار البروق في انواء الفروق للقرافي يمكن تنزيله من الشبكة الدولية من علي محرك بحث ياهو وهو اربعة مجلدات تحتوي علي اقل قليلا من 300 فرق مهم تبدأ من الفرق الأول وهو الفرق بين الشهادة والبينة (وهذا الفرق وحده استغرق من القرافي ثماني سنوات فلتأمل!!!!) وهذه الفروق هامة جدا كي لا يقع الباحث في أي لبس.
-
المطلب العاشر
أمورٌ إنسانيَّة متكررة يمارسها الناس عند وقوعهم تحت طائلة القانون
ثم نشاهد حالة لدى الناس متكررة مدى الدهور، تتمثل في:
1- إنَّ الذي تكون الأمور في غير صالحه، نراه يوزِّع الاتهامات ، ويهذي ويهذر، بكلام لا يقدِّم ولا يؤخِّر، بل قد يسيء الى القائل لا غير ،ظاناً أنَّ ذلك يدفع عنه المساءلة ، أو يُظهِره بمظهر الإنسان الطيِّب ، حتّى لا ينال اللوم من الناس ، زيادة على العقوبة ...
(قالوا إن يسرِق فقد سرق أخٌ له من قبل فأسرَّها يوسفُ في نفسِهِ ولم يُبْدِها لهم قال أنتم شرٌ مكاناً والله أعلم بما تصفون) يوسف / 77 .
فأرادوا أن يقولوا أنَّهم صالحون، وأنَّ هذا السارق هو أخوهم من أبيهم، وهذا وأخوه [يقصدون يُوُسُف] هم على هذه الشاكلة!!.
لكن هل يُغني مثلُ هذا، في مثل هذا الموقف؟
جوابه هو عين ما نراه في حياتنا العمليَّة، حين يتكلم المحكومون وأقاربُهم بما لا يُجدي، فقد: (سبق السيف العذل ) .
2- فلما ذهبت السكرةُ ، وجاءت الفكرةُ ، عاودتهم حالةٌ من حالات بني البشر الأخرى ، وهي :
الرجاء، والاسترحام، وتقديم المعاذير، والمقترحات..
(قالوا يا أيَّها العزيزُ إنَّ له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدَنا مكانَه إنّا نَراك من المُحسنين ) يوسف / 78 .
أما الجانب القانوني في هذه المسألة ، فقد عالجه قانونان :
أ. قانون العقوبات ، ونصوصه التي تخصُّ الموضوع ، هي :
يعدُّ فاعلاً للجريمة :
1- من ارتكبها وحده ، أو مع غيره .
2- من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال ، فقام عمداً أثناء ارتكابها بعملٍ من الأعمال المكوِّنة لها … .
ويُفهم أنّ غير الفاعل ، أو الشريك لا يُسأل عن أيِّ فعلل جرمي ، لا على سبيل : التطوُّع ، أو المساعدة ولو كانت لسبب إنساني ، ولا حتَّى لسبب قانوني .. .
2- أ. لا تجوز محاكمة غير المتَّهم الذي أُحيل على المحاكمة .
ب. في قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة .. فمما ورد فيها :
إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجَّهة إليه…ورأت المحكمة أنَّ اعترافه مشوب ، أو أنَّه لا يقدِّر نتائجه … .
فالمحكمة تُقدِّر كون الإقرار صحيح ، أم كان مشوباً بأيَّة شائبة ، حتى ولو كانت تحمُّل العقوبة عن: مريضٍ ، أو بِراً بقريبٍ عزيز، وما شاكل ذلك وغير خافٍ أننا لسنا في موضع الاستقصاء ، بل يكفينا التمثيل لكل قاعدة من القواعد ، لندلِّل على التوافق ، أو قل أنَّ ما ورد في السورة هو مما يجري التعامل به قانوناً .. الآن ! ..
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته