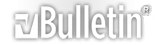أدت الهجمات اليهودية في المدينة إلى تفاقم التوتر في منطقة كان العمال اليهود والعرب يعملون فيها جنباً إلى جنب: في منشآت مصفاة شركة نفط العراق في منطقة خليج حيفا. وبدأ الأمر بإلقاء زمرة تابعة للإرغون قنبلة على مجموعة كبيرة من الفلسطينيين كانت في انتظار الدخول إلى المنشآت. وادعت الإرغون أن ذلك كان رداً انتقامياً على هجوم سابق قام به عمال عرب على زملاء لهم يهود. وكانت تلك ظاهرة جديدة في موقع صناعي كان العمال العرب واليهود معتادين فيه العمل المشترك من أجل الحصول من مستخدميهم البريطانيين على شروط عمل أفضل. لكن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة ألحق ضرراً جدياً بالتضامن الطبقي، وبدأت التوترات تتفاقم. وكان إلقاء القنابل وسط التجمعات العربية من اختصاصات الإرغون، وفعلت ذلك مراراً قبل سنة 1947. إلاّ إن هذا الهجوم بالتحديد جرى بالتنسيق مع قوات الهاغاناه كجزء من مخطط جديد لإلقاء الرعب في قلوب سكان حيفا ودفعهم إلى الهروب من المدينة. وخلال ساعات، رد العمال الفلسطينيون على الهجوم بأعمال شغب، وقتلوا عدداً كبيراً من العمال اليهود - 39 شخصاً - في واحدة من أسوأ الهجمات الفلسطينية المضادة، وكانت آخرها، لأن سلسلة الاشتباكات المعتادة المكوّنة من فعل وردة فعل توقفت بعد ذلك.
أمّا اللجنة القومية في حيفا، التابعة للفلسطينيين، فقد ظلت تناشد البريطانيين مرة بعد أُخرى [التدخل لحمايتهم - المترجم]، مفترضة، خطأً، أنه نظراً إلى كون حيفا آخر محطة في عملية الجلاء البريطاني، فإن في استطاعتها الاعتماد على حماية البريطانيين، على الأقل إلى أن يرحلوا. وعندما لم يحدث ذلك، بدأ أعضاء اللجنة القومية يبعثون برسائل يائسة إلى أعضاء الهيئة العربية العليا داخل فلسطين وخارجها، طالبين النصح والمساعدة. ووصلت مجموعة صغيرة من المتطوعين إلى المدينة في كانون الثاني ، لكن بعض الأعيان وقادة المجتمع كان أدرك وقتها أن مصيره حُسم في لحظة تبني الأمم المتحدة قرار التقسيم: الطرد على يد جيرانهم اليهود. هؤلاء الجيران الذين كانوا هم أنفسهم من دعاهم في البداية، في الفترة العثمانية، إلى المجيء والبقاء معهم، فوصلوا بائسين ومفلسين من أوروبا، وشاركوهم العيش في مدينة كوزموبوليتانية مزدهرة - إلى أن صدر قرار التقسيم المشؤوم.
على هذه الخلفية يجب أن يتذكر المرء خروج نخبة حيفا البالغ عدد أفرادها نحو 15.000 شخص، وكثيرون منهم تجار ناجحون أدى خروجهم في ذلك الوقت إلى تعطيل التجارة والأعمال، ووضع عبء إضافي على كاهل الشرائح الفقيرة في المدينة.
«هذا ليس كافياً»، صرح يوسف فايتس قائلاً عندما اجتمعت الهيئة الاستشارية يوم الأربعاء، في 31 كانون الأول 1947، قبل ساعات قليلة فقط من مذبحة بلد الشيخ. واقترح علانية ما كان سجّله سراً في يومياته أوائل الأربعينات: «أليس الآن هو الوقت الملائم للتخلص منهم؟ لماذا نستمر في ترك هذه الأشواك بيننا وهي خطر علينا؟» وبدت ردات الفعل الانتقامية، في نظره، طريقة قديمة للتعامل مع الوضع لأنها لا تتضمن الهدف الرئيسي المتمثل في مهاجمة القرى واحتلالها. وكان فايتس عُيّن عضواً في الهيئة الاستشارية لأنه كان رئيس دائرة الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي، ولأنه كان في الهيئة أدى دوراً حاسماً في توضيح أفكار «الترانسفير» الغامضة لأصدقائه وترجمتها إلى سياسة فعلية. وقد شعر بأن النقاش الجاري فيشأن المستقبل يفتقر إلى غاية، إلى توجه كان رسم معالمه في الثلاثينات والأربعينات.
«الترانسفير»، كتب في سنة 1940، «لا يخدم هدفاً واحداً فحسب - تقليل عدد السكان العرب - بل يخدم أيضاً غرضاً ثانياً لا يقل أهمية عن الأول، وهو إخلاء الأرض التي يزرعها العرب حالياً وتحريرها من أجل الاستيطان اليهودي.» ومن ثم، خلص إلى القول: «الحل الوحيد هو ترحيل العرب من هنا إلى الدول المجاورة. يجب ألاّ نترك حتى قرية واحدة أو عشيرة واحدة.»
وكانت تلك الجلسة الوحيدة للهيئة الاستشارية التي يتوافر لدينا محضر لها، (موجود في أرشيف الهاغاناه). وأعد فايتس من أجل هذه «الحلقة الدراسية الطويلة» مذكرة موجهة إلى بن - غوريون شخصياً، حضّ فيها الزعيم على المصادقة على خططه لترحيل السكان الفلسطينيين عن المناطق التي أراد اليهود احتلالها، وعلى جعل الأعمال المتصلة بذلك «حجر الأساس للسياسة الصهيونية.» ومن الواضح أنه كان يشعر بأن المرحلة «النظرية» في ما يتعلق بخطط «الترانسفير» انتهت، وحان أوان تطبيق الأفكار. وفي الواقع، غادر فايتس الحلقة الدراسية الطويلة وفي حيازته إذن بإنشاء زمرة صغيرة تابعة له تحت اسم «لجنة الترانسفير»، وأتى إلى الاجتماع التالي حاملاً خططاً فعلية.
في الحقيقة لم يكن هناك معارضة تستحق الذكر، وهذا ما يجعل الحلقة الدراسية الطويلة جلسة محورية بالغة الأهمية. فنقطة الانطلاق التي تقبلها الجميع، كانت أن التطهير العرقي ضروري. أمّا بقية المسائل، أو بالأحرى المشكلات، فكانت ذات طبيعة سيكولوجية أو لوجستية. فالأيديولوجيون مثل فايتس، والمستشرقون مثل ماخنس، والجنرالات مثل ألون، شكوا من أن جنودهم لم يستوعبوا بعد، كما يجب، الأوامر السابقة التي صدرت إليهم بتوسيع العمليات إلى ما هو أبعد من الأعمال الانتقامية المعتادة. والمشكلة الرئيسة، في نظرهم، كانت أن الجنود بدوا عاجزين عن التخلي عن الأساليب القديمة في الردود الانتقامية. «إنهم ما زالوا ينسفون بيتاً هنا وبيتاً هناك»، اشتكى غاد ماخنس، زميل دانين وبالمون، الذي أصبح، ويا للعجب، المدير العام لوزارة الأقليات الإسرائيلية في سنة 1949 (إذ بدا، على الأقل، وهذه نقطة في مصلحته، كأنه شعر بشيء من الندم على سلوكه في سنة 1948، واعترف صراحة في سنة 1960 بأنه «لولا الاستعدادات [العسكرية الصهيونية] المكشوفة ذات الطبيعة الاستفزازية، لكان من الممكن تفادي الانزلاق إلى الحرب [في سنة 1948]»). لكن وقتئذ، في كانون الثاني 1948، بدا نافد الصبر من كون القوات اليهودية ما زالت منهمكة في البحث عن «أفراد مذنبين» في هذا المكان أو ذاك، بدلاً من إلحاق الضرر في شكل فعال.
شرح ألون وبالمون لزملائهما التوجه الجديد: هناك ضرورة لسياسة أكثر شراسة في المناطق التي ظلت «هادئة فترة أطول من اللازم.» ولم يكن ثمة حاجة إلى إقناع بن - غوريون، إذ أعطى في نهاية الحلقة الدراسية الطويلة الضوء الأخضر للقيام بسلسلة كاملة من الهجمات الاستفزازية والفتاكة على قرى عربية، بعضها كردود انتقامية، وبعضها الآخر غير ذلك. والقصد هو التسبب بأقصى ما يمكن من الأضرار وقتل أكثر ما يمكن من القرويين. وعندما سمع أن المراحل الأولى المقترحة لتنفيذ السياسة الجديدة كانت جميعها في الشمال، طلب القيام بعمل تجريبي في الجنوب أيضاً، على أن يكون محدداً، لا عاماً. وهنا تكشّف بن - غوريون فجأة عن أنه كاتب حسابات حقود. فقد حضّت على القيام بهجوم على مدينة بئر السبع، والسعي بصورة خاصة الى قتل نائب المحافظ، الحاج سلامة بن سعيد، وشقيقه، اللذين رفضا في الماضي التعاون مع الخطط الصهيونية للاستيطان في المنطقة. وشدد بن - غوريون على أنه لم يعد هناك ضرورة للتمييز بين «البريء» و«المذنب»، إذ حان الوقت لإلحاق أذى مصاحب ( collateral). وتذكّر دانين بعد أعوام أن بن - غوريون شرح معنى «أذى مصاحب» بقوله: «كل هجوم يجب أن ينتهي باحتلال، ودمار، وطرد».
أمّا بالنسبة إلى المزاج «المحافظ» السائد في صفوف جنود الهاغاناه، فقد أوضح يغئيل يادين، رئيس هيئة أركان الهاغاناه - وبعد 15 أيار 1948 رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي - أن الوسيلة للتقدم [في حل هذه المشكلة - المترجم] تكمن في تبني مصطلحات جديدة صريحة، وفي تلقين عقائدي أشد قسوة. وكان نائبه، يغآل ألون، أكثر نزوعاً إلى الانتقاد. فقد انتقد الهيئة الاستشارية بصورة غير مباشرة لأنها لم تصدر أوامر صريحة بالقيام بهجوم شامل في بداية كانون الأول. «لقد كان في استطاعتنا وقتها أن نحتل يافا بسهولة، وكان يجب أن نهاجم القرى الموجودة حول تل أبيب. يجب أن نقوم بسلسلة من العقوبات الجماعية حتى لو كان هناك أطفال يعيشون في البيوت [المهاجمة].» وعندما حاول إلياهو ساسون، بمساعدة رؤوفين شيلواح، أحد مساعديه (لاحقاً شخصية بارزة في حقل الاستشراق الإسرائيلي)، أن يلفت الانتباه إلى أن الاستفزاز من شأنه أن ينفّر الفلسطينيين المسالمين، أو الذين يكنون الود لليهود، أجابه ألون بنفاد صبر قائلاً: «الدعوة إلى السلام ستكون ضَعْفاً!» وأبدى موشيه دايان آراء مشابهة، واستبعد بن - غوريون أي محاولة للتوصل إلى اتفاق في يافا، أو في أي مكان آخر.
كان غياب جهة واضحة منسِّقة مصدر قلق للعسكريين في الهيئة الاستشارية. وذُكر أن قوات متحمسة تهاجم أحياناً قرى في مناطق ترغب القيادة العليا موقتاً في تجنب حدوث استفزازات فيها. ونوقشت في الحلقة الدراسية الطويلة حادثة معينة جرت في حي روميما في القدس الغربية. وكانت تلك المنطقة في المدينة هادئة جداً إلى أن قرر قائد محلي في الهاغاناه أن يرعب الفلسطينيين في الحي بحجة أن صاحب محطة وقود هناك كان يشجع قرويين على مهاجمة السيارات اليهودية المارة. وعندما قتل الجنود صاحب المحطة، ردت قريته، لفتا، بهجوم على حافلة ركاب يهودية. وأضاف ساسون أنه اتضح أن التهمة كانت كاذبة. لكن هجوم الهاغاناه هذا كان فاتحة لسلسلة من الهجمات ضد قرى فلسطينية واقعة على المنحدرات الغربية لجبال القدس، وموجهة بصورة خاصة ضد قرية لفتا التي، حتى بشهادة استخبارات الهاغاناه، لم يحدث أن هاجمت أي قافلة على الإطلاق.
قرية لفتا، كانت واحدة من أوائل القرى التي تعرضت للتطهير العرقي. وكانت [في زمن بعيد - المترجم] مكان إقامة قاسم أحمد، قائد ثورة 1834 ضد حكم إبراهيم باشا المصري، والتي يعتبرها بعض المؤرخين أول ثورة وطنية فلسطينية. وكانت القرية مثالاً رائعاً للهندسة المعمارية الريفية، بشوارعها الضيقة المتوازية مع منحدرات الجبل. وقد تجلى ازدهارها النسبي، مثل كثير من القرى الأُخرى، خصوصاً في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، في تشييد بيوت جديدة، وتحسين الطرقات والأرصفة، بالإضافة إلى مستوى معيشي أعلى. وكانت لفتا قرية كبيرة، يقطن فيها 2500 نسمة، معظمهم مسلمون، وعدد قليل منهم مسيحيون. وكان من مظاهر رخائها المستجد مدرسة للبنات تعاون عدد من القرى على تمويل بنائها في سنة 1945.
كانت الحياة الاجتماعية في لفتا تدور حول مركز تجاري، اشتمل على ناد ومقهيين. وكان يجذب إليه المقدسيين أيضاً. وكان أحد المقهيين هدفاً للهاغاناه عندما شنت هجومها في 28 كانون الأول 1947. وقد أمطر اليهود المسلحون بالرشاشات المقهى بالرصاص، بينما أوقف أفراد من عصابة شتيرن حافلة ركاب بالقرب من المكان وبدأوا إطلاق النار عليها عشوائياً. وكانت تلك أول عملية لعصابة شتيرن في الريف الفلسطيني.
كانت هذه هي النتيجة النهائية للحلقة الدراسية الطويلة. فمع أن القيادة الصهيونية اعترفت بضرورة أن تكون الحملة منسقة وخاضعة للإشراف، إلاّ إنها قررت تحويل كل مبادرة غير مصادق عليها إلى جزء عضوي من الخطة، مانحة إياها مباركتها بعد وقوعها.