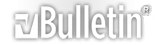المستشرق " سافاري " وحديثه عن القرآن
المستشرقون والقرآن
دراسة لترجمات نفر منالمستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم فيه
ترجمة "سافاري (1)"
د. إبراهيم عوض
إلى القارئ الكريم:
حينما فكَّرت في إعدادِ هذه الدراسةِ، لم يكن يَخطُر ببالي أن هؤلاءِ المستشرقينَ - الذين يَنتَقِدونَ القرآنَ ويخطِّئونه وينفِّرون الناسَ منه - لا يُحسِنون فهمَه على هذا النحو المُخزِي الذي تكشَّف لي بعد ذلك.
لقد كنتُ أظنُّ أن أخطاءَهم هي من تلكَ الأخطاءِ العاديةِ التي لا يَنجُو منها جهدٌ بشريٌّ، أما هذا الجهل الفادح، وهذا العنادُ الحَرُون، وهذا الالتواءُ في النيةِ الذي سيَلمَسُه قارئ هذه السطور بنفسه، فهو في الحقيقةِ شيءٌ لم يكن يَخطُر لي ببالٍ.
لقد أقبلتُ على هذا البحثِ بعقلٍ مفتوحٍ، ظانًّا أني سأَقرأُ كلامًا إن لم يوافِق اعتقادي، فهو كلام موزونٌ، أما هذا التهافتُ وهذه الجرأةُ الجاهلةُ التي سيَراها القارئُ بنفسِه من خلال عشرات الأمثلة -لاحِظ أنها مجرَّد أمثلة- فقد صَدَمتنِي، وخيَّبت ظني تخييبًا.
نقطةٌ أخيرةٌ أحبُّ أن أوضِّحها، هي: أني -وإن استعنتُ ببعض كتبِ التفاسيرِ والدراساتِ القرآنية- كنتُ حريصًا أن يكونَ لي رأيي المستقلُّ.
وسوف يرى القارئُ في عدَّة مواضعَ، كيف خالفتُ الرأيَ الشائعَ في: تحليلِ، وتفسيرِ، وتذوُّقِ هذه الآية أو تلك، أو تتبُّع الخيطِ الذي يَربِط بين الموضوعاتِ، التي تبدو للمتعجِّل متباعدةً في هذه السورةِ أو في تلك، بل إن هناك عدَّة آياتٍ لا أذكر أنِّي قرأتُ ما عنَّ لي فيها عند أحدٍ قبلي، وكان عمدتي في ذلك -إلى جانبِ استقلالِ التفكير- ذوقِي الأدبيُّ الذي غذَّته قراءاتي الأدبيةُ والنقديةُ؛ إذ إن هذا هو مجالُ تخصصي الأوَّل.
وبعد، فهل أنا بحاجةٍ إلى القول بأن القارئَ لن يَعْدَم في هذه الدراسة أخطاءً هنا وهناك؟
كلُّ الذي أرجوه ألا تكونَ هذه الأخطاءُ كثيرةً ولا فاضحةً، ولعل الله أن يسترَ على عُوار عبدِه الضعيفِ، وهو أكرم مسؤول.
ترجمة "سافاري"[1]
أول ما يلاحَظ على هذه الترجمةِ أن اسم "محمد "-صلى الله عليه وسلم- قد ذُكِر على الغِلاف بوصفِه مؤلِّفَ القرآن، ولست هنا أجادِل في حقِّ المترجِم أن يعتَقِد أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- هو مؤلِّف القرآن أو لا؛ فهذا أمرٌ يرجِع إليه هو، وليس لي أدنى حقٍّ في أن أحْجِر على ما يَعتَقِد، لكن الذي أَعرِفه هو أن الأمانةَ العلميةَ كانت تقتضيه أن يُغْفِل ذكرَ اسمِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- على الغِلاف؛ لأن الأصلَ الذي ترجَم عنه لا يُوجَد فيه شيءٌ من هذا؛ فكان الواجبُ عليه في مثلِ هذه الحالةِ أن يَحتَرِم الأصل، ثم له في المقدِّمة والملاحظاتِ الكثيرةِ المثبَتةِ في هوامش الكتابِ مندوحةٌ؛ ليقرِّر ما يعتقدُه هو كما يَحلُو له.
ولعلنا لا نُضِيف جديدًا حين نقولُ: إنه كان يرى أن النبيَّ -عليه السلام- كان يؤلِّف القرآنَ سورةً بعد سورةٍ، أو مجموعةً من الآيات بعد أخرى على حسَب الظروفِ، وأنه تعمَّد أن يكون الوحيُّ منجَّمًا على هذا النحو حتى يكون في مُكْنَتِه أن يُضِيف إليه ما يَحلُو له حسبما يَجِدُّ من أحوالٍ، أو يَعترِض من مشاكل؛ فيكونُ في يديه دائمًا زمامُ توجيهِ الأمور، وهو رأيٌ يقولُ به معظم المستشرقين، وليس الردُّ عليه بالصعب, وقد كان الأحْجَى بهؤلاءِ الناس ومَن يَقْفُون آثارَهم -صمًّا وبكمًا وعميًا- أن يُدرِكوا أن هذا افتراضٌ معتسِّفٌ، لا يُسنِده دليلٌ مقنِع، لولا أن أمثالَ هؤلاءِ يُقبِلون على البحثِ في أمر القرآن والإسلام كلِّه بعقولٍ مغلقةٍ، وقلوب مضطغنةٍ.
وبرغمِ هذا لا يَسَعنِي إلا الاعترافُ بأن أسلوبَ هذه الترجمةِ سلسٌ وأنيقٌ، لكن هذه السلاسةَ والأناقةَ لا يُصَاحِبها سلامةُ الفهمِ ولا الدقةُ اللازمة في ترجمة كتابٍ كالقرآن، هو الكتابُ المقدَّس لأتباعِ أحدِ الأديانِ الكبرى في العالم؛ إذ المترجِم في كثيرٍ جدًّا جدًّا من الأحيانِ يَكتفِي بأداءِ المعنَى أداء إجماليًّا؛ فيَنقُل إلى القارئِ المعنى الكُلِّي، لكنه يُغفِل كثيرًا من التفصيلاتِ التي لا غنَى عنها، فمثلاً: في ترجمتِه قوله -تعالى-: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ [البقرة: 108].
يقول:
"Demandez – vous votre apotre ce que les juifs demaderent a Moise ? "
ومعناه بالعربية: "أتسألونَ رسولَكم ما سألَه اليهودُ من موسى؟".
فانظر كيف حَذَف من ترجمته عبارة "أم تريدون"، وتَرجَم الفعل المبنِيَّ للمجهول بمبنِيٍّ للمعلوم، وأضافَ لفظةَ "اليهود"، وهي ليست موجودةً في النص، كما أنه حوَّل "كما" إلى "ما".
وهذا كلُّه يُخِلُّ -ولا شكَّ- بالمعنى.
لقد كان يَستَطِيع أن يُحَافِظ على الأصلِ في درجِ الترجمةِ، ثم يَشرَح في الهوامش ما فَهِمه هو من النص من تلقائه، أو مما نقلَه من كتب المفسِّرين.
وفي ترجمةِ قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ ﴾ [البقرة: 158].
على النحو التالي:
"sapha et Merva sont des monuments de Dieu. Celui qui aura fait le pelerinage de la Mecque , et aura visite la maison sainte sera exempt d'offrir une victime d'expiation , pourvu qu'il fasse la tour
de ces deux montagnes "
مترجمًا "شعائر الله" بـ "آثار الله"، مع أن المقصودَ هو: أن الطوافَ بالصفا والمروةَ شعيرةٌ دينيةٌ من شعائرِ الحجِّ، لا أن الجَبَلينِ المذكورينِ أثرانِ تذكاريانِ.
ومترجمًا قولَه- تعالى-: ﴿ حَجَّ الْبَيْتَ ﴾ بما معناه: "قام بالحجِّ إلى مكة", وهذا غيرُ دقيقٍ على الإطلاق؛ فإن الحجَّ ليس مجرَّد الذهاب إلى مكة، وإلا فالناسُ يذهبونَ إلى مكة كلَّ يومٍ بالآلاف، ولا يعدُّ هذا من الحجِّ في شيءٍ.
أما في قوله -تعالى-: ﴿ أَوِ اعْتَمَرَ ﴾، فقد استبدل بـ "أو" حرفَ عطفٍ آخرَ هو "الواو", وتَرجَم "اعتمر" بـ "زار البيت"، فأَصبَح المعنى "حَجَّ إلى مكةَ وزار البيتَ".
فانظر أي تشويهٍ للمعنَى! وكأن هذا غيرُ كافٍ؛ فتَرجَم: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾، بما يفيد أنه: "لا يجب عليه أن يضحِّي بشيء، بشرط أن يطوفَ بالصفا والمروة ".
وهو ما لا تدلُّ عليه العبارةُ القرآنيةُ أبدًا؛ إذ الآيةُ قد نَزلَت لتُذهِب عن نفوس المسلمين ما كانوا يَشعُرونَ به من حرج، تُجَاهَ التطويف بهذينِ الجَبَلينِ ظنًّا منهم أن هذا من أعمالِ الجاهليةِ التي ينبغي عليهم أن ينبذوها.
أما قوله -تعالى-: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ [البقرة: 167].
فيُتَرجِمه بما معناه: "سوف يُرِيهم أعمالَهم، وسوف يصعِّدون الزفرات"، وهو ما يُغْفِل من المعنَى دقائقَه، وذلك بتفصيص الجملةِ إلى جملتين؛ إذ المقصود أن أعمالَهم نفسَها سوف تتحوَّل إلى حسراتٍ.
وانظر إلى قوله: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾، وإشعاعاتِه التي تحومُ أمام عينيك، ولكنك لا تَستَطِيع عليها قبضًا! وأَرجُو كذلكَ ألا يَغِيب عن انتباهِك أن القرآنَ يَستَخدِم الزمنَ الحاضِرَ في ﴿ يُرِيهِمْ ﴾، فكأنَّك تُشاهِد المنظرَ وتَرَى لوقتِك أعمالَهم وحسراتِهم، وهو ما يَضِيع في الترجمة؛ من جرَّاء ما أَشرتُ إليه آنفًا، وأيضًا من جرَّاء استعمالِ المترجِم لزمن الاستقبالِ.
كذلكَ في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ ﴾ [آل عمران: 180].
يفوِّت المترجِم ما يعودُ عليه الضميرُ "هو"؛ إذ يَظنُّه عائدًا على﴿ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾، ولذلك يُتَرجِم الجملةَ كالآتي:
"Que l'avare ne regarde pas les biens qu'il resoit de Dieu comme une faveur , puisqu'ils causeront son Malheur ".
وليس هذا هو المرادَ، بل المرادُ أن عليهم أن يُفِيقوا من غَفلَتِهم؛ إذ يَحسَبُون أن بُخلَهم هو خيرٌ لهم، مع أنه في الواقعِ وبالٌ عليهم.
إن ما يَهَبُه الله لعبدٍ من عبادِه من أموال وأرزاقٍ ليس خيرًا في ذاتِه ولا شرًّا، بل نيةُ الإنسانِ وعملُه هما اللذان يَكتَسِبان هذينِ الوصفينِ.
هذا، وقد تكرَّرت ترجمتُه لقولِه - تعالى -:﴿ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ بـ "Exact"، وهو ما يُفيد أنه - سبحانه - دقيقٌ في محاسبةِ العبادِ، وليس هذا هو المقصودَ انظر: ص158، 175، 191، 269 على سبيل المثال، وإن كان قد ترجمها في ص264 ترجمةً صحيحةً، وذلك في قولِه - تعالى -: {﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [إبراهيم: 51]، فلا أدري لِمَ لَمْ يَلتَزم هذه الترجمةَ الصحيحة في كلِّ الحالات!
ومثل هذا ترجمتُه لفظةَ "المنافقون "مرارًا ترجمةً خاطئةً، وبلا سببٍ مفهومٍ.
لقد ترجمها بـ "impies" ص171 , 437"، مع أنه استَعمَل هذه الكلمةَ بمعنى: ﴿ الذين كفروا ﴾ ص186"، وبمعنى: ﴿ الظالمين ﴾ ص189"، وبمعنى: ﴿ الذين ظلموا ﴾" ص310"، وبمعنى: ﴿ أثيم ﴾ ص364 ", وبمعنى: ﴿ المسرفين ﴾ ص427".
ومثل هذا الاضطرابِ يَجُور جورًا شديدًا لا على الدقة فقط، بل على أصل المعنى؛ إذ إن الظالمينَ غيرُ الآثمين، غير الذين كفروا، غير المسرِفين.
وهذا الجَور يَجِدُه القارئ أيضًا في ترجمة الكاتب لكلمةِ "الأعراب"بـ "les Arabes"، مع أن هذه غيرُ تلك، وهو من الوضوحِ والشهرة؛ بحيث لا أَدرِي كيف خَفِي عليه؟ إن كان قد خفي فعلاً، ولم يقصده قصدًا؛ انظر ص231، 437، 438، 441، وهي سياقاتٌ يَصِمُهم الله فيها بالنفاق، أو على الأقل بعدمِ مخالطة الإيمان قلوبَهم ودخولِهم في الإسلام ظاهرًا فقط.
فهل هذا يَصْدُق على العربِ جميعًا؟ فمَن الذي حَمَل أعباء الرسالة إذًا، وقام بها قومةَ الرجال، وحارب من أجلِها , وضحَّى في سبيلِها، ونَشَرها في العالمين؟ أليس عدمُ الدقةِ هنا إثمًا عظيمًا؟
إن هذا اللونَ من الترجمةِ الإجمالية، وغيرِ الدقيقةِ يَشِيع في الكتابِ شيوعًا بارزًا، ولو أردتُ لأتيتُ للقارئ لا بعشرات الأمثلة فحسْب، بل بالمئاتِ.
يتبع