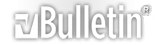قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين .
قال احد أعداء الإسلام بجهالة :
اقتباس:
يقول القرآن : " قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ"
فالواض من اللغة أن هذا النص أمر لمحمد أن يقول شيئا.. وكلغة يفترض أن ما سيقوله هو ما أتى بعد كلمه "قل"
أي أن النص يعني "قل: "مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ"
أي يفترض بأن ما سيقوله محمد سيبدأ بجملة "من كان عدوا..."
السؤال هو هذه الجملة تحوي قول "فإنه نزله على قلبك" ففي هذه الجلمة عدة إشكاليات. كيف وبأي معنى سيقول محمد "فإنه نزله على قلبك" ألم يكن من الأولى أن يقول "فإنه نزله على قلبي" أو أن تُحذف كلمة "قل". المشكل الثاني هو في "نزله" نزل ماذا؟ أعلم أن المسلمين سيقولن القرآ، لكن أين القرآن في النص؟ فالنص يقول "من كان عدوا للجبرائيل فإنه نزله على قلبك" فعلى من تعود الهاء في "نزله".
يبدو أنه واح د من النصوص الأخرى في القرآن التي لا تعني فيها الكلمات ما تقول، وسنجد من يخرج علينا يشرح لنا أن اللغة عميقة وأن الكلمات فيها نحذوف ومقدم ومؤخر وباقي محاولات التخريج المعروفة.
لكن للنتظر لنرى كيف يشرحون إبهام القرآن.
فبعد حوار كامل مع هذا الشخص .. قلت له :
مسكين !
كل مشاركة أقراها لك أشفق عليك .
يا عزيزي أنا ذكرت لك قول الإمام الشعراوي حول وسائل الخطاب بين المتكلم والمخاطب تأتي على ثلاث صور :
1) ضمير متكلم أنا
2) ضمير المخاطب أنت
3) ضمير الغائب هو
فهل هذه الآية خرجت عن نطاق قواعد اللغة ؟
بالطبع لا .. بل خرجت عن نطاق .... ثقافتك
وسالتك : هل لديك ما ينفي هذه القاعدة ؟
وجدتك تسخر من الإمام / الشعراوي وتتجاهل قواعد اللغة التي تسأل عنها وتجهلها ثم تعيد الكلام متجاهل الرد .
عموماً : قال الإمام مالك : لو جأنى مائة عالم لغلبتهم ولو جأنى جاهل واحد لغلبنى بجهله .
والتكرار يعلم إيه ! .... (لا) الشطار
بص يا شاطر :
قوله تعالى : فإنه نزله على قلبك ، فيه إلتفات من التكلم إلى الخطاب وكان الظاهر أن يقال على قلبي ، لكن بدل من الخطاب للدلالة على أن القرآن كما لا شأن في إنزاله لجبريل وإنما هو مأمور مطيع كذلك لا شأن في تلقيه وتبليغه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن قلبه وعاء للوحي لا يملك منه شيئا وهو مأمور بالتبليغ.
واعلم أن مثل هذه الآيات في أواخرها ، أنواع الالتفات وإن كان الاساس فيها الخطاب لبني إسرائيل ، غير أن الخطاب إذا كان خطاب لوم وتوبيخ وطال الكلام صار المقام مقام إستملال للحديث مع المخاطب وإستحقار. لشأنه فكان من الحري للمتكلم البليغ الاعراض عن المخاطبة تارة بعد أخرى بالالتفات بعد الالتفات للدلالة على أنه لا يرضى بخطابهم لردائة سمعهم وخسة نفوسهم ولا يرضى بترك خطابهم إظهارا لحق القضاء عليهم.
كما قال الإمام القرطبي :
قال أبو جعفر: وإنـما قال جل ثناؤه: { فَـانّهُ نَزَّلَهُ عَلَـى قَلْبِكَ } وهو يعنـي بذلك قلب مـحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر مـحمداً فـي أول الآية أن يخبر الـيهود بذلك عن نفسه، ولـم يقل: فإنه نزّله علـى قلبـي. ولو قـيـل «علـى قلبـي» كان صوابـاً من القول لأن من شأن العرب إذا أمرت رجلاً أن يحكي ما قـيـل له عن نفسه أن تـخرج فعل الـمأمور مرّة مضافـاً إلـى كناية نفس الـمخبر عن نفسه، إذ كان الـمخبر عن نفسه ومرّة مضافـاً إلـى اسمه كهيئة كناية اسم الـمخاطب لأنه به مخاطب فتقول فـي نظير ذلك:
«قل للقوم إن الـخير عندي كثـير» فتـخرج كناية اسم الـمخبر عن نفسه لأنه الـمأمور أن يخبر بذلك عن نفسه، و«قل للقوم: إن الـخير عندك كثـير» فتـخرج كناية اسمه كهيئة كناية اسم الـمخاطب لأنه وإن كان مأموراً بقـيـل ذلك فهو مخاطب مأمور بحكاية ما قـيـل له. وكذلك: «لا تقل للقوم: إنـي قائم»، و«لا تقل لهم: إنك قائم»، والـياء من إنـي اسم الـمأمور بقول ذلك علـى ما وصفنا ومن ذلك قول الله عزّ وجل: «قُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا سَيُغْلَبُونَ» و«تُغلبون» بـالـياء والتاء.
.
فعندما أحس بالفشل قال :
اقتباس:
فشكرا على التوضيح..
ولكن هل يمكنك أن تأتي لي بنماذج حقيقية من كلام العرب أو أشعارهم كمثال لهذا الأمر؟
بعدها لدي سؤال أخر في نفس الموضوع لكن سأنتظر توضيحك أولا.
العجيب أنه يطلب طلب ذكرته عن الإمام القرطبي والتي تحتها سطر؛ ولكنه تجاهلها كعادتهم .
فقمت بالرد عليه ولكنه حذف هذا الرد ليظهر عجزي في الحوار معه ، وكانت هذه المشاركة تحتوي على :
http://www.up07.com/up8/uploads/92cfe90b1e.gif
وقد تم حذفها عدة مرات إلى أن قام بطردي .. لكنني أعدت الكرة مرة أخرى وباسم جديد لأكشف له عجزه :
http://www.up07.com/up8/uploads/b658b47936.gif
نسأل الله لهم الهداية